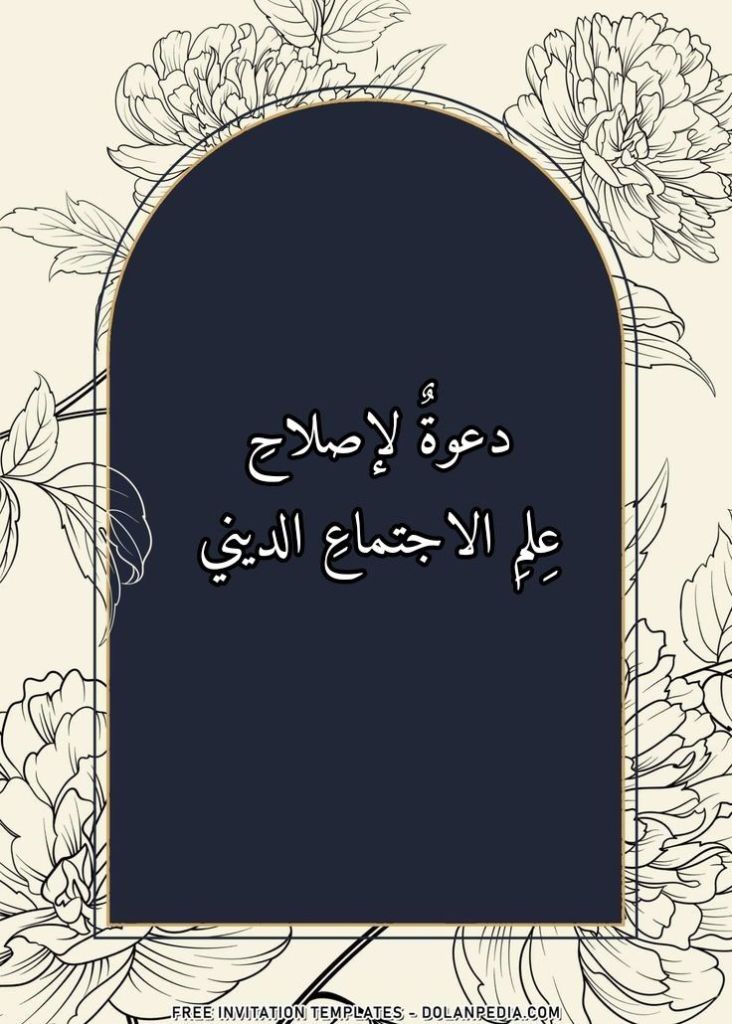
لماذا يُتَّهَم بعضُ علماءِ الاجتماع بمخالفةِ مبادئ المنهجِ العلمي؟
يفترضُ المنهجُ العلمي في دراساتِ الإنسانِ والمجتمع الالتزامَ بالحياد، وتجنبَ تبنِّي افتراضاتٍ لا يمكنُ التحققُّ منها أو التي تتأثرُ بانحيازاتٍ ثقافية أو دينية. ومع ذلك، يثار جدلٌ حول مدى التزام بعض الباحثين في علم الاجتماع الديني بهذا الحياد، خاصة في تفسيرهم لتطورِ الظاهرة الدينية، وتحديدًا فكرة أن التوحيدَ جاء متأخرًا في التجربة الإنسانية.
ويشكل المنهجُ العلمي إطارًا مرجعيًا للدراسات الاجتماعية، ويقتضي الحيادَ تجاه المسائل الميتافيزيقية، ومنها قضيةُ وجودِ الإله أو أصولُ العقائد الدينية. غير أن بعضَ الاتجاهاتِ السائدة في علمِ الاجتماع الديني تفترض أن التعدديةَ الدينية (أو ما يسمى “الشِّرك”) هي الأصلُ في التجربة البشرية، وأن التوحيدَ جاء لاحقًا نتيجةَ تطورٍ اجتماعي-ثقافي.
وتقوم هذه الفرضيةُ على تسلسلٍ تطوري (evolutionary paradigm) للدين، تروّج له أعمالٌ مثل تلك التي تعود إلى إدوارد تايلور أو جيمس فريزر، والذين افترضوا أن الأديانَ تطورت من الأرواحية إلى التعددية ثم التوحيد. لكن هذه السردية، على الرغم من انتشارها، تتضمن انحيازًا ضمنيًا، إذ تفترض مسبقًا أن التوحيدَ نتاجُ تطور اجتماعي، لا أنه قد يكونُ هو الأصل.
وهنا يُطرح تساؤل مشروع: هل تجاهلُ الفرضيةِ المقابِلة القائلة بأن التوحيدَ قد يكونُ أوليًا ثم تراجع أمام ضغوطٍ اجتماعيةٍ وسياسيةٍ وثقافية يُعد تجاهلًا لأحد المسارات التفسيرية المحتملة؟ وإن كان الأمر كذلك، أليس في ذلك إخلالٌ بمبدأ الحيادِ العلمي؟
فالعلمُ لا يملك أدواتٍ لإثبات أو نفي وجودِ الإله أو لتحديد ما إذا كان التوحيدُ أسبقَ زمنيًا من التعدديةِ الدينية. من ثمّ، فإن ترجيحَ أحدِ المسارين دون قرائنَ ماديةٍ دامغة يقع ضمن دائرةِ الفرضيات وليس الحقائق العلمية. كما أن المنهجَ العلمي لا يسمح بإقحامِ القناعات الشخصية، سواء كانت دينية أم لادينية، في صياغة نتائج البحث. ولذلك، فإن استخدامَ “المنهج العلمي” لتبريرِ فرضياتٍ غيرِ قابلة للاختبار، يجعلُ الباحثَ عرضةً للانحيازِ المعرفي (cognitive bias).
وبدلًا من ترجيحِ سرديةٍ واحدة، فإنَّ من الأجدرِ بعلماء الاجتماع أن يدرسوا الظاهرةَ الدينية ضمن تعدديةٍ تفسيرية (interpretive pluralism)، تراعي الخلفياتِ الحضارية، وتفترضُ إمكانيةَ أن تكونَ البداياتُ الدينية للإنسان أكثرَ تعقيدًا مما تقترحه النماذجُ التطورية الخَطِّية. كما ينبغي أن نعترفَ بأن بعضَ الفرضياتِ السائدة قد تكون متأثرةً بمواقفَ فلسفيةٍ مسبقة، لا بنتائجَ علميةٍ خالصة.
أختمُ بالقول إننا غيرُ ملزَمين، وذلك وفقاً لما يقتضيه الالتزامُ بالمنهجِ العلمي، أن نفاضلَ بين الفرضيتين المتقابلتين (التوحيد أولًا أم التعددية أولًا) فنفضِّلَ إحداهما على الأخرى. فقصارى ما يوجبُه علينا التزامُنا هذا هو أن ندعوَ إلى تطبيقٍ صارمٍ للمنهج العلمي، بما يضمن الحياد، ويمنع تسييسَ العلمِ أو تديينه. إن الاعترافَ بحدود المعرفة، واحترامَ التعددِ في الفرضيات، يمثلان حجرَ الأساس لأي علم اجتماعٍ رصين، ولأي مبحثٍ معرفي ينطلقُ من قوانينِ هذا العِلم وهي تسعى إلى أن تقاربَ النصَّ الديني مقاربةً إن كانت لا تغفلُ عن مقتضياتِ المنهجِ العِلمي، فإنها لا تنحازُ معرفياً، أو مزاجياً، إلى الأخذِ بمقاربةٍ دون أخرى بلا بينةٍ أو برهان.
