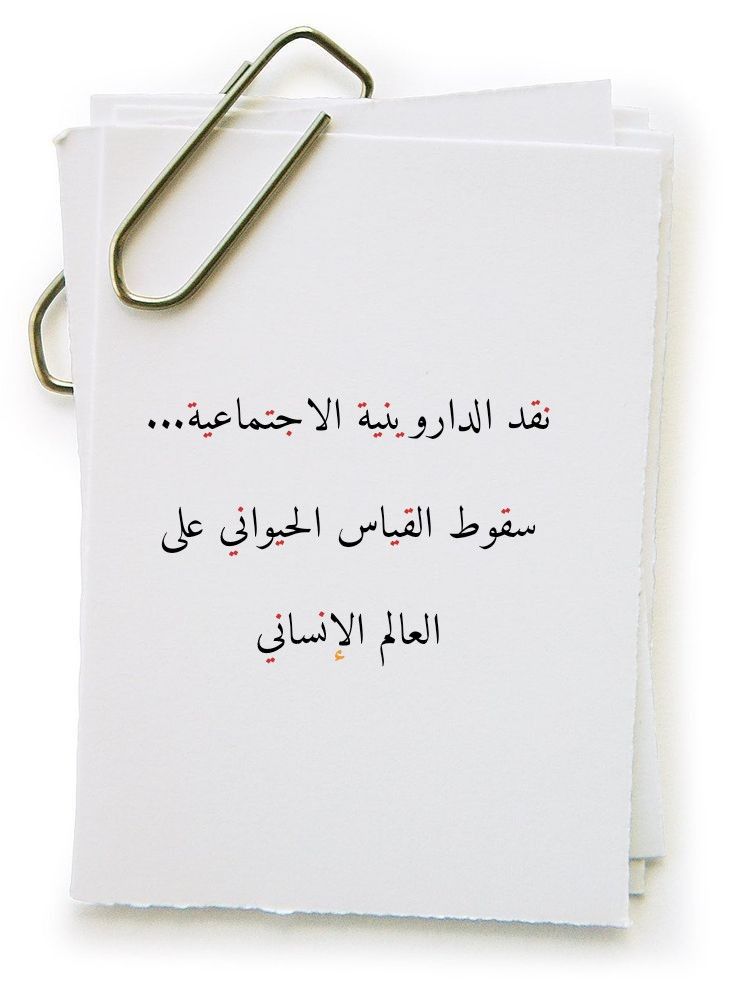
تُعَدُّ الداروينية الاجتماعية واحدة من أكثر النظريات الزائفة التي تركت أثرًا بالغ السلبية على الفكر والسياسة في القرنين التاسع عشر والعشرين. إذ حاولت أن تُسقِط آليات الانتقاء الطبيعي، كما صاغها تشارلز داروين في تفسيره لنشوء وارتقاء الكائنات الحية، على المجتمعات البشرية. لكن هذا الإسقاط لم يكن علميًا خالصًا بقدر ما كان أداة أيديولوجية لتبرير الاستعمار، والعنصرية، والتفاوت الطبقي، والحروب. فكيف يمكن أن تُعامَل المجتمعات الإنسانية كما تُعامَل قطعان الحيوانات، مع أن الإنسان كائن متمايز بخروجه على الطبيعة التي أنجبته؟
داروين في “أصل الأنواع” (1859) لم يتجاوز دائرة تفسير الطبيعة الحيوانية والنباتية. كان غرضه فهم كيفيّة نشوء الأنواع وتكيفها عبر آليات الانتقاء الطبيعي والتكيف مع البيئة. هذه المقاربة نجحت في مجالها الحيوي، إذ فسرت كثيرًا من الظواهر الطبيعية في عالم الحيوان. لكن حدودها كانت واضحة:
هي مقاربة بيولوجية صرف.
تُعنى بالكائنات غير العاقلة.
تفترض أن البقاء للأصلح يعني البقاء للأقدر على التكيف.
المشكلة بدأت عندما حاول بعض المفكرين إسقاط هذه النظرية على الإنسان والمجتمع، متجاهلين أن الإنسان لا يعيش في الطبيعة وحدها، بل يبني ثقافة وقانونًا ودينًا واقتصادًا، أي عالَمًا موازٍ لقوانين الطبيعة.
لم يكن داروين نفسه هو الذي أسس للداروينية الاجتماعية، بل كان هربرت سبنسر هو من صاغ العبارة الشهيرة “البقاء للأصلح” (Survival of the Fittest)، محولًا النظرية البيولوجية إلى نظرية اجتماعية. ومن بعده جاء منظّرون آخرون مثل غوبينو بنظريته عن تفوق الأعراق، ليضعوا لبنات العنصرية العلمية الزائفة.
في أوروبا، استُخدمت الداروينية الاجتماعية لتبرير الاستعمار، باعتباره “رسالة الحضارة للرقي بالشعوب البدائية”.
في الولايات المتحدة، ظهرت لتبرير الرأسمالية المتوحشة وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد بحجة أن السوق سيُبقي على “الأصلح”.
في ألمانيا النازية، بلغت ذروتها مع هتلر الذي رأى في “التطهير العرقي” تطبيقًا عمليًا لمنطق الطبيعة.
هكذا، لم تكن الداروينية الاجتماعية سوى إيديولوجيا مقنَّعة بالعلم، تستعمل خطابًا بيولوجيًا لإضفاء الشرعية على مشروعات الهيمنة والقهر.
إنّ قياس الإنسان على الحيوان قياس فاسد، لأن هناك فروقًا سلوكية ووظيفية تجعل من المستحيل تطبيق منطق الطبيعة الصارم على المجتمعات البشرية:
العدوانية المفرطة: بينما يُمارس الحيوان العنف في حدود البقاء، مارس الإنسان إبادة جماعية، وحروبًا عالمية، واستعمارًا عابرًا للقارات. هذه ليست غرائز تطورية بل انحرافات تاريخية.
النشاط الجنسي المنفلت: الحيوان يخضع لدورات بيولوجية واضحة، أما الإنسان فقد أطلق نشاطه الجنسي خارج أي قيد تطوري مباشر، ليصبح سلوكًا اجتماعيًا وثقافيًا، متجاوزًا دافعية التكاثر وحدها.
الهشاشة البيولوجية: الإنسان على الرغم من تطوره المعرفي، يمتلك جهازًا مناعيًا ضعيفًا، وهو الأكثر عرضة للأمراض. لو حكمته الطبيعة وحدها لانقرض. لكن الذي أنقذه هو الثقافة: الطب، العلم، والقانون.
الهشاشة النفسية: الإنسان كائن سيكولوجي هش، تلاحقه الاضطرابات النفسية والعقلية، بدرجة غير مسبوقة عند الحيوان. هذا دليل على أن الوجود الإنساني لا يمكن تفسيره بالآليات البيولوجية وحدها.
الداروينية الاجتماعية ليست مجرد خطأ علمي، بل كارثة أخلاقية، وذلك لأنها أسقطت “القانون الطبيعي” على الإنسان وكأن المجتمع البشري لا قيام له إلا بسحق القوي لمن هو اضعف منه.
أفرغت السياسة من بعدها القيمي- الاخلاقي، لتصبح مجرد صراع من أجل البقاء.
بررت الفوارق الطبقية باعتبارها انعكاسًا للتفوق الطبيعي، متجاهلة الظلم البنيوي الذي يصنعه الإنسان بيديه.
لقد كشفت الحروب العالمية، ومعسكرات الإبادة، وتجارب الاستعمار، أن هذه النظرية لا تُنتج سوى المزيد من الوحشية المقنَّعة بالعلم.
إذا كان لا بد من استعارة من الطبيعة، فالإنسان هو الكائن الذي خرج على الطبيعة، أي أنه أبدع مجالًا جديدًا للقوانين: القوانين الأخلاقية، والقوانين السياسية، والقوانين الثقافية. لا يمكن فهم المجتمعات البشرية إلا عبر ما أنتجه الإنسان من أنظمة تتجاوز الغريزة. وهذا ما يجعل أي محاولة لإخضاع الإنسان لآليات الانتقاء الطبيعي محاولةً عقيمة في أصلها.
الداروينية الاجتماعية سقطت لأنها أساءت قراءة الإنسان. لقد غفلت عن أن الإنسان ليس مجرد امتداد للحيوان، بل هو انقطاع عنه، بل قطيعة في بعض مظاهره الجوهرية. وإذا كان الحيوان يُفهم ضمن قوانين الطبيعة، فإن الإنسان يُفهم ضمن قوانين الحضارة. ومن هنا، فإن أي محاولة مستقبلية لإحياء الداروينية الاجتماعية لن تكون إلا تكرارًا لكارثة فكرية وأخلاقية سبق أن دفعت البشرية ثمنها غاليًا.
