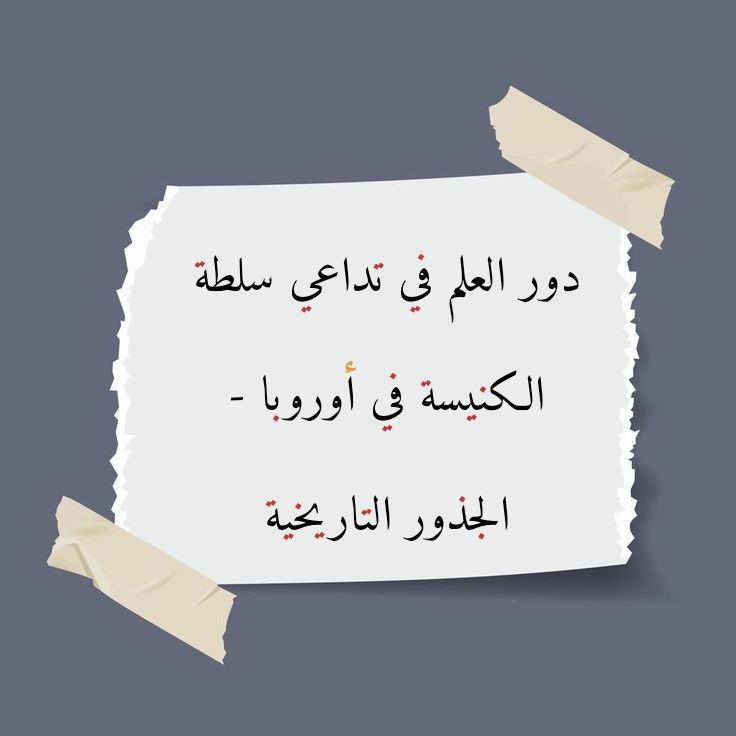
ظلّت العلاقة بين الكنيسة والعِلم في أوروبا لقرون طويلة حبلى بالتوتر والصراع، حتى انتهى الأمر بانحسار سلطة الكنيسة وصعود الدولة الحديثة باعتبارها الإطار الجامع للسلطة السياسية والاجتماعية. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل كان تحريم الكنيسة الرومانية للاشتغال بالعلم مجرّد دفاع لاهوتي عن العقيدة، أم كان في جوهره تعبيراً عن خشية رجال الدين من فقدان هيمنتهم على المجتمع؟
منذ العصور الوسطى، احتكرت الكنيسة الكاثوليكية السلطة الروحية والمعرفية، واعتبرت نفسها المرجع الأعلى في تفسير الوجود. لكن مع بروز تيارات فكرية علمية تجريبية، بدأ هذا الاحتكار يتعرض للاهتزاز. قضية غاليليو غاليلي مثال صارخ على ذلك؛ إذ لم يكن الخلاف مجرد مسألة فلكية تتعلق بمركزية الأرض أو الشمس، بل كان صراعاً على المرجعية: من يملك سلطة تحديد “الحقيقة”، الكنيسة أم العقل التجريبي؟
وفي القرن السادس عشر، جاء الإصلاح البروتستانتي بقيادة مارتن لوثر ليضيف بعداً آخر: التشكيك بسلطة الكنيسة نفسها، ليس فقط معرفياً بل أيضاً لاهوتياً وسياسياً. هنا لم تعد الكنيسة تواجه العلماء وحدهم، بل واجهت أيضاً قوى اجتماعية وسياسية صاعدة مدعومة بالعلم والطباعة والمعرفة الجديدة.
إن الثورة العلمية في القرن السابع عشر — مع ديكارت، كبلر، ونيوتن — لم تكن مجرد ثورة معرفية، بل كانت ثورة سياسية بامتياز. فقد أنتجت أدوات جديدة غيّرت قواعد اللعبة:
الملاحة والاستكشافات الجغرافية: البوصلة، الخرائط المحسنة، وفنون الملاحة الجديدة، مكّنت الأوروبيين من الوصول إلى العالم الجديد وجلب ثرواته، ما أضعف اعتماد الدولة على الكنيسة كمصدر للشرعية والقوة.
التكنولوجيا العسكرية: المدافع، السفن المحسنة، وأدوات الحصار، غيّرت شكل السلطة السياسية، وجعلت من الدولة الحديثة اللاعب الأقوى في الحقل الاستراتيجي.
الطب والعلوم الطبيعية: هذه بدورها خلقت شرعية جديدة للعقل التجريبي على حساب الشرعية الروحية الكنسية.
ومع بروز الدولة القومية الحديثة في أوروبا (فرنسا، إنجلترا، إسبانيا)، أصبح من الواضح أن الكنيسة لم تعد قادرة على ضبط مجتمعات تتغير بنيتها الاقتصادية والسياسية بسرعة غير مسبوقة.
القول بأن الكنيسة جرّمت العلم فقط لأنه “يتعارض مع العقيدة” فيه تبسيط. الواقع أن الصراع كان على من يملك احتكار الحقيقة والمعرفة. اللاهوت الكنسي لم يكن مجرد إيمان روحي، بل كان أداة لضبط المجتمع وضمان الطاعة. ومع ظهور العقلانية الديكارتية والنهج التجريبي الغاليلي-النيوتني، تآكل هذا الاحتكار شيئاً فشيئاً.
الأهم من ذلك، أن الكنيسة لم تستطع مجاراة الثورة الطباعية وانتشار الكتب والأفكار، وهو ما جعل احتكارها للمعرفة ينكسر، لتتحول إلى قوة رمزية أكثر منها مرجعية قادرة على فرض سلطتها.
إن فقدان الكنيسة لسلطتها لصالح الدولة لم يكن حدثاً عرضياً، بل كان جزءاً من تحوّل أعمق نحو الحداثة الأوروبية. فالدولة الحديثة، كما صاغها منظّرو العقد الاجتماعي مثل هوبز ولوك، وجدت في العلم أداة لتأسيس شرعية عقلانية — تختلف عن الشرعية الدينية — ترتكز على المنفعة والتنظيم والقانون الوضعي.
لقد حلّت السيادة العلمانية محل السيادة الروحية، وأصبح الحاكم هو من يحدد المصالح العليا للمجتمع، اعتماداً على العقلانية العلمية والتقنية، لا على سلطة الكهنة.
يمكن القول إن الكنيسة في اوروبا لم تخسر سلطتها الروحية فقط بسبب أخطائها اللاهوتية أو مواقفها المتشددة تجاه العلم، بل لأنها واجهت تحولات بنيوية كبرى: صعود الدولة القومية، تراكم الثروات التي جلبها الاستعمار، انتشار العقلانية العلمية، وتلاشي احتكار الكنيسة للمعرفة.
