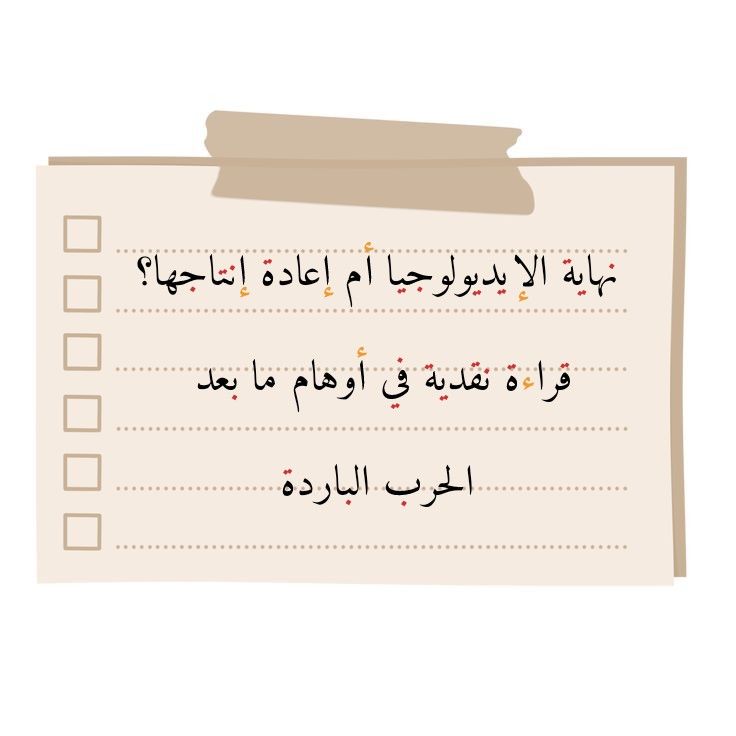
أثار انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 نقاشًا عالميًا واسعًا حول طبيعة المرحلة الجديدة التي دخلها النظام الدولي. فبينما اعتبر بعض المفكرين، وعلى رأسهم فرانسيس فوكوياما، أن ما جرى يمثل نهاية التاريخ بانتصار الليبرالية الديمقراطية، ذهب آخرون إلى القول بأننا دخلنا عصرًا “ما بعد أيديولوجي”، تراجع فيه دور العقائد الكبرى لتحل محلها صراعات براغماتية تقوم على حسابات المصالح والمنافع المباشرة. هذه الأطروحة، على الرغم من رواجها الإعلامي والسياسي، تخفي وراءها هشاشة مفاهيمية عميقة، لأنها تتجاهل الطبيعة الأيديولوجية الملازمة للإنسان، وتفترض إمكانية تاريخ بلا أيديولوجيا، وهو ما يتعارض مع كل التجارب التاريخية والفكرية للبشرية.
إن الزعم بانتهاء الأيديولوجيا عقب انهيار المنظومة الشيوعية يقوم على افتراضٍ اختزالي يرى أن سقوط تجربة سياسية–اقتصادية بعينها يعني أفول كل الأنماط العقائدية. غير أن هذا الزعم يواجه مأزقين:
مأزق التاريخ القريب: فما لبث أن حلّت محل الثنائية القطبية صراعات جديدة مشبعة بالأيديولوجيا، كما في أطروحة صموئيل هنتنغتون حول “صدام الحضارات” (1993)، التي مثّلت تعبيرًا صريحًا عن رؤية أيديولوجية تعيد ترتيب العالم وفق خطوط الهوية الثقافية والدينية.
مأزق البنية الإنسانية: إذ يتجاهل هذا الطرح أن الأيديولوجيا ليست مجرد غطاء سياسي، بل هي ميل أنطولوجي أصيل في الإنسان لإنتاج أنساق رمزية كلية تضفي المعنى والشرعية على أفعاله وتاريخه.
إذا كان الحيوان محكومًا بقوانين الطبيعة الصارمة التي لا تسمح له إلا بمسار واحد للبقاء، فإن الإنسان يمتاز بقدرة فريدة على الانفصال الرمزي عن واقعه الطبيعي، وصياغته ضمن تصورات كلية متجاوزة. من الأسطورة إلى الدين، ومن الفلسفة إلى العلم، ظل الإنسان ينتج أيديولوجيات تمنحه معنى للوجود وتوجه سلوكه الفردي والجماعي.
حتى كارل ماركس الذي سعى إلى نقد الأيديولوجيا وفضحها باعتبارها “وعيًا زائفًا” لم يستطع الانفلات من البنية الأيديولوجية، إذ تحوّل الماركسية نفسها إلى أيديولوجيا شاملة.
أما مارتن هايدغر فذهب إلى أبعد من ذلك حين أشار إلى أن الإنسان هو “الكائن المؤطِّر للوجود” (das Ge-Stell)، أي أنه لا يستطيع إدراك ذاته والعالم إلا عبر منظومات تفسيرية ذات طابع أيديولوجي.
المفارقة أن البراغماتية، التي قُدّمت في الخطاب السياسي الغربي بعد الحرب الباردة على أنها لغة “ما بعد الأيديولوجيا”، ليست سوى أيديولوجيا جديدة مقنّعة.
فالمصلحة والمنفعة ليست مفاهيم طبيعية محايدة، بل هي نتاج لرؤية معيارية تضع “المنفعة” في قمة هرم القيم.
هذا يعني أن البراغماتية السياسية ليست خروجًا من حقل الأيديولوجيا، بل إعادة صياغة له بلغة تبدو تقنية وواقعية، لكنها في جوهرها تفرض نسقًا أيديولوجيًا يعلي من شأن “المنفعة” كقيمة مطلقة.
يُفترض بالعلم أن يكون النموذج الأعلى للموضوعية والحياد، لكن التحليل المعرفي يبين أن العلم نفسه لا يمكن أن يتطهر من نزعات أيديولوجية.
فالفيزياء، مثلًا، لا تقوم فقط على التجربة والملاحظة، بل على كيانات افتراضية (الإلكترون، الكوارك، الحقل، الزمكان…) لا يمكن البرهنة عليها مباشرة، وإنما تُفترض داخل رؤية كونية كلية.
وهذا ما جعل فلاسفة العلم مثل توماس كون وبول فييرابند يؤكدون أن النظريات العلمية ليست معطيات محايدة، بل أنساق مشروطة بسياقات معرفية وأيديولوجية.
الواقع السياسي منذ التسعينيات يبرهن أن الأيديولوجيا لم تمت:
صعود الأصوليات الدينية شكل إعادة إنتاج لنزعة عقائدية في مواجهة “العولمة الليبرالية”.
بروز النيوليبرالية نفسها كإطار حاكم للاقتصاد العالمي يمثل أيديولوجيا متكاملة، رغم تقديمها كـ “حتمية اقتصادية”.
الخطابات القومية والشعبوية في أوروبا وأمريكا خلال العقدين الأخيرين تعكس تجدد الأيديولوجيا في أشكال جديدة، من “أمريكا أولًا” إلى النزعات القومية الأوروبية.
إن إعلان “موت الأيديولوجيا” كان في حقيقته مجرد خطاب أيديولوجي جديد يبرّر هيمنة نموذج سياسي–اقتصادي بعينه بعد الحرب الباردة. الأيديولوجيا ليست مرحلة تاريخية يمكن تجاوزها، بل هي بعد أنطولوجي في الوجود الإنساني، يلازمه ما دام يفكر ويمنح العالم معنى. ومن ثمّ، فالتاريخ لم يدخل طورًا “ما بعد أيديولوجي”، بل يواصل إعادة إنتاج الأيديولوجيا في صور وأشكال متجددة، كلما تبدّلت السياقات السياسية والمعرفية.
