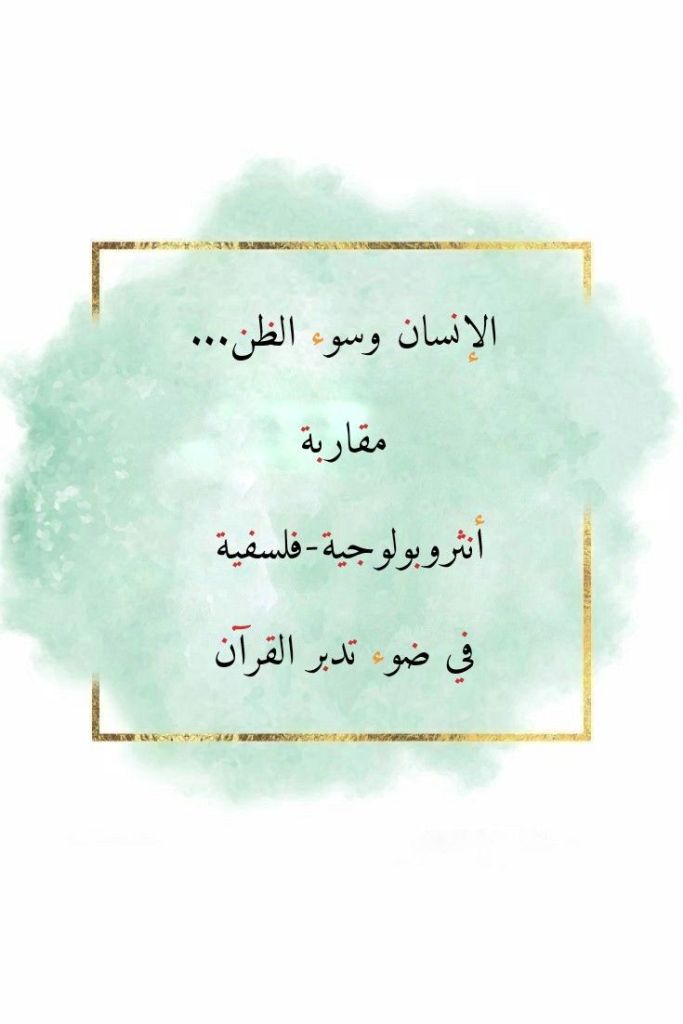
تميّز الإنسان في مساره التطوري بلحظة فاصلة خرج فيها عن منظومة الطبيعة التي أحكمت سيطرتها على السلوك الحيواني عبر ملايين السنين. هذا الخروج لم يقتصر على تطوير أدوات أو لغات أو أنماط عيش، بل شمل أيضًا بروز أنماط شعورية ومعرفية لم يعرفها الحيوان. من أبرز هذه الأنماط: سوء الظن، وهو ميل إنساني إلى إسقاط نوايا سلبية أو خفية على الآخر، حتى في غياب ما يدلّ عليها موضوعيًا.
هذه المقالة تسعى إلى تحليل هذه الظاهرة من زوايا متعددة:
أنثروبولوجيًا: بوصفها علامة على خروج الإنسان من منطق الغريزة الصافية إلى عالم الرموز والتأويلات.
فلسفيًا-أخلاقيًا: باعتبارها أزمة قيمية تزعزع العلاقات الاجتماعية.
نفس تطوريًا: باعتبارها أثرًا جانبيًا لتطور آليات البقاء التي بالغت في التعميم.
قرآنيًا: حيث نجد نصًا تحذيريًا صريحًا يوجّه الإنسان إلى ضرورة ضبط هذه النزعة.
الأنثروبولوجيا الحديثة تؤكد أن السلوك الحيواني محكوم بـ”اقتصاد حيوي” صارم (Wilson, Sociobiology: The New Synthesis, 1975). الحيوان لا يبدّد طاقته في استجابات زائدة أو مشاعر متوهمة. غريزته هي التي تضمن له التوازن: استجابة دقيقة للخطر، وانضباط صارم في التفاعل مع “الآخر”. ولهذا، لا مكان عند الحيوان لمشاعر كالارتياب أو التشكيك المستمر.
في لحظة محورية من ماضيه التطوري، دخل الإنسان مجالًا جديدًا: مجال التفسير والرمز والتأويل. هنا، بدأ يرى في كل حركة أو نظرة أو نبرة صوت مؤشرًا على نوايا خفية. هذه النقلة تزامنت مع توسع القدرة التخيلية وظهور “العقل الاجتماعي” (Cosmides & Tooby, The Adapted Mind, 1992). غير أن هذه القدرة، التي كان هدفها الأصلي تعزيز النجاة من التهديدات، تطورت إلى ما يشبه “الانحراف الإدراكي”؛ إذ صار الإنسان يبالغ في افتراض السوء.
علم النفس التطوري يقدّم تفسيرًا لهذه الظاهرة من خلال ما يُعرف بـ”انحياز الكشف عن الوكالة” (Agency Detection Bias). فالإنسان مبرمج تطوريًا على أن يخطئ في جانب المبالغة في افتراض وجود تهديدات أو نوايا عدائية، لأن الخطأ في هذا الاتجاه كان أقل كلفة للبقاء من تجاهل تهديد محتمل (Barkow, Cosmides & Tooby, 1992). ومع أن هذا الانحياز كان مفيدًا في بيئة الأسلاف، إلا أنه في المجتمع الحديث يتحول إلى أرضية خصبة لسوء الظن والارتياب المرضي.
من منظور الفلسفة الأخلاقية، يمثّل سوء الظن أزمة في بناء الثقة الذي تقوم عليه الجماعة البشرية. فكما يوضح بول ريكور (Oneself as Another, 1992)، الثقة شرط أساسي للتماسك الاجتماعي، بينما الارتياب المفرط يولّد القطيعة والعداء. وهنا يتبدى سوء الظن كقيمة سلبية، تُفسد إمكان التعايش وتُحول “الآخر” إلى تهديد دائم.
يلتقط القرآن هذا البعد الأخلاقي والأنثروبولوجي، محذرًا المؤمنين من مغبة الانسياق وراء هذه النزعة:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} (الحجرات: 12).
الآية تقرر أن الظن ليس مجرد خطأ إدراكي، بل “إثم” أخلاقي له تبعات اجتماعية. فهي دعوة إلى إعادة ضبط ما انفلت من نوازع الإنسان، وإلى أن يتجاوز عجزه عن الحساب الموضوعي لنوايا الآخرين.
المقارنة بين الإنسان والحيوان تكشف أن ما يحسبه الإنسان ميزة (القدرة على التخيل والتأويل) قد ينقلب إلى عبء حين ينفلت بلا ضابط. الحيوان، المحكوم بغريزة صافية، لا يعرف سوء الظن، بينما الإنسان يكدّس التوهمات، فيعيش في حالة استنزاف نفسي واجتماعي.
سوء الظن ليس ظاهرة عابرة، بل تعبير عن لحظة فارقة في تاريخ الإنسان التطوري. إنه الوجه السلبي لقدراته التخيلية والاجتماعية، والتي بلا ضابط أخلاقي تتحول إلى قوة تدمير داخلي. ومن هنا، فإن الاستشهاد القرآني لا يقدّم تحذيرًا دينيًا وحسب، بل أيضًا علاجًا أنثروبولوجيًا وأخلاقيًا يعيد الإنسان إلى “اقتصاد السلوك” الذي ضمن للحيوان البقاء عبر ملايين السنين.
Wilson, E. O. (1975). Sociobiology: The New Synthesis. Harvard University Press.
Cosmides, L., & Tooby, J. (1992). The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture. Oxford University Press.
Barkow, J., Cosmides, L., & Tooby, J. (1992). The Adapted Mind. Oxford University Press.
Ricœur, P. (1992). Oneself as Another. University of Chicago Press.
