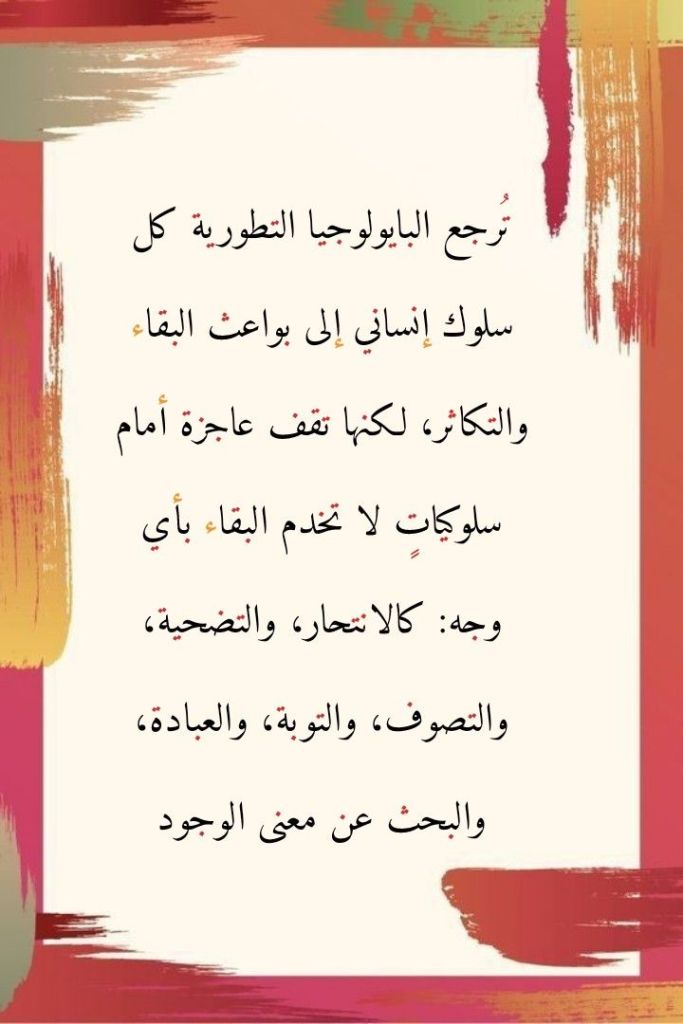
ليس سؤال لماذا يحتاج الإنسان إلى الدين سؤالًا لاهوتيًا صرفًا، بل سؤال أنطولوجي يخصّ بنية الإنسان ذاته. فالقرآن العظيم لا يقدّم الدين بوصفه مؤسسة تشريعية تنظم السلوك فحسب، بل باعتباره استجابةً إلهيةً لخللٍ أصيلٍ في طبيعة الإنسان، خللٍ يجعل هذا الكائن محتاجًا إلى الهداية كما يحتاج إلى الهواء والماء.
إنّ تبيان حقيقة الإنسان في الخطاب القرآني ليس وصفًا أخلاقيًا، بل كشفٌ ميتافيزيقيٌ لطبيعةٍ خُلقت وهي تحمل في داخلها قابليةَ النقص والاضطراب والهوى، فجاء الدين ليعيد التوازن إلى هذا الكائن الذي خرج من نظام الطبيعة دون أن يمتلك القدرة على استبدالها بنظام من صنعه.
يتحدث القرآن عن الإنسان بلغةٍ تصف جوهره لا عرَضه، فتأتي الصفات التالية كمفاتيح أنطولوجية لا كأوصاف أخلاقية:
ضعيف، عجول، ظلوم، جهول، يئوس، قنوط، كفور، مجادل، فرِح، فخور، هلوع، جزوع، كنود، منوع.
هذه المفردات القرآنية تكشف عن بنية وجودية مضطربة تتأرجح بين الضعف والطموح، وبين النزعة الأرضية والنزوع إلى العلوّ. وهي صفات لا يمكن تفسيرها بمرجعية التطور الحيوي وحدها، إذ يتعذر على البايولوجيا التطورية أن تفسّر لماذا يملك الإنسان قابليةً فطريةً للفساد الأخلاقي والتناقض الداخلي.
فالحيوان منضبط بغرائزه، أما الإنسان فقد انفلت من نظام الغرائز دون أن يبتكر نظامًا بديلاً ثابتًا. ومن هنا كان الدين ضرورةً لا اختيارًا، لأن الدين هو النظام الذي يُعاد به إدخال الإنسان في نسق كوني متوازن بعد أن خرج منه.
تُرجع البايولوجيا التطورية كل سلوك إنساني إلى بواعث البقاء والتكاثر، لكنها تقف عاجزة أمام سلوكياتٍ لا تخدم البقاء بأي وجه: كالانتحار، والتضحية، والتصوف، والتوبة، والعبادة، والبحث عن معنى الوجود.
فهذه الأفعال لا تفسَّر بالمنفعة، بل بالحنين إلى ما وراء الطبيعة — إلى أصلٍ مفقود يستدعي اكتماله.
العِلم إذًا، بقدر ما ينجح في تفسير المادة، يفشل في تفسير الروح الإنسانية. إنه يُخبرنا كيف يعمل الدماغ، لكنه لا يُخبرنا لماذا يتألم الإنسان، ولماذا يشعر بالذنب، ولماذا يفتش عن الخلاص. وهذه الفجوات هي ما يملؤه الدين.
فالدين ليس «منافسًا» للعلم، بل «مكمّلًا له من الأعلى»، يفسّر ما يعجز عنه التفسير المادي، لأنه يتعامل مع الإنسان كـكائن مزدوج: جسدٌ من تراب وروحٌ من أمر الله.
في ضوء هذا الخلل البنيوي، يمكننا القول إن الدين هو العلاج الإلهي لمرض الوجود الإنساني.
يقدّم القرآن الدين لا كتكليف خارجي، بل كوصفة علاجية إلهية:
(قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ) (المائدة 15–16).
فالنور هنا ليس معرفةً عقلية فحسب، بل طاقة وجودية تُحدث تحولًا في بنية الإنسان.
إن الإنسان من دون هذا النور يبقى كائنًا ناقصًا، لأن العقل — مهما بلغ من رجحان — لا يستطيع أن يعلو فوق أهوائه، كما لا يستطيع الضوء الصناعي أن يحلّ محلّ الشمس.
الدين هو الذي يجعل الإنسان كيانًا آخر، قادرًا على تجاوز حدوده الحيوانية، وعلى إعادة تعريف ذاته بما يتجاوز الضرورة الفيزيولوجية إلى الحرية الروحية.
الهداية في القرآن ليست مجرد إرشادٍ إلى طريقٍ معرفي، بل هي تحوّل وجودي يعيد ترتيب العلاقة بين الإنسان والله والكون.
فالهداية تُبدّل طاقة القلب، وتحوّل النفس من «أمّارة بالسوء» إلى «مطمئنة».
(اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) (البقرة 257).
إن ظلمة الإنسان ليست ظلمة جهلٍ فحسب، بل ظلمةُ طبيعةٍ مفصولةٍ عن أصلها الإلهي.
ولذلك فإن الدين هو الجسر الذي يعيد الوصل بين الخلقة والخالق، بين النقص والكمال، بين المحدود واللامحدود.
إنه مشروع عودةٍ إلى التوازن الأول الذي فُقد يوم اختار الإنسان أن يكون حرًا دون أن يكون إلهيًا.
كثيرون يظنون أن الإنسان يمكنه أن يكتفي بالأخلاق أو بالعقل ليبلغ الكمال. غير أن الأخلاق — إذا انفصلت عن الإيمان — سرعان ما تتحول إلى نسبية مائعة، والعقل إذا استقلّ بذاته يتحول إلى أداة تبرير لا إلى وسيلة ترقٍ.
فالعقل يضيء الطريق، لكن الدين وحده يهب القدرة على السير فيه.
ومن هنا تتضح المفارقة الكبرى:
الدين لا يأتي ليكمّل الإنسان في علمه، بل في ضعفه، لا في قوته بل في عجزه عن تجاوز نفسه.
إنه دعوة لأن يخرج الإنسان من ذاته ليبلغ ذاته العليا.
يتبيّن إذًا أن الإنسان يحتاج إلى الدين لا لأنه ناقص في معرفته فحسب، بل لأنه ناقص في وجوده.
العلم يعرّفنا بالكون، لكن الدين يعرّفنا بأنفسنا.
وما لم يتلقَّ الإنسان هذا النور الإلهي الذي يصحّح مسار فطرته، سيظلّ — كما وصفه القرآن — كائنًا «ضعيفًا» في قوته، «جاهلًا» في علمه، «فقيرًا» في غناه.
فالدين هو مشروع الارتقاء بالإنسان من كائنٍ محتاجٍ إلى الهداية إلى كائنٍ يفيض بالنور الإلهي حتى يكون هو الهداية نفسها.
وبهذا وحده «يعلو الإنسان فوق ضعفِه الخلقي، ويصير كائنًا آخر، يقول للشيء: كن فيكون».
