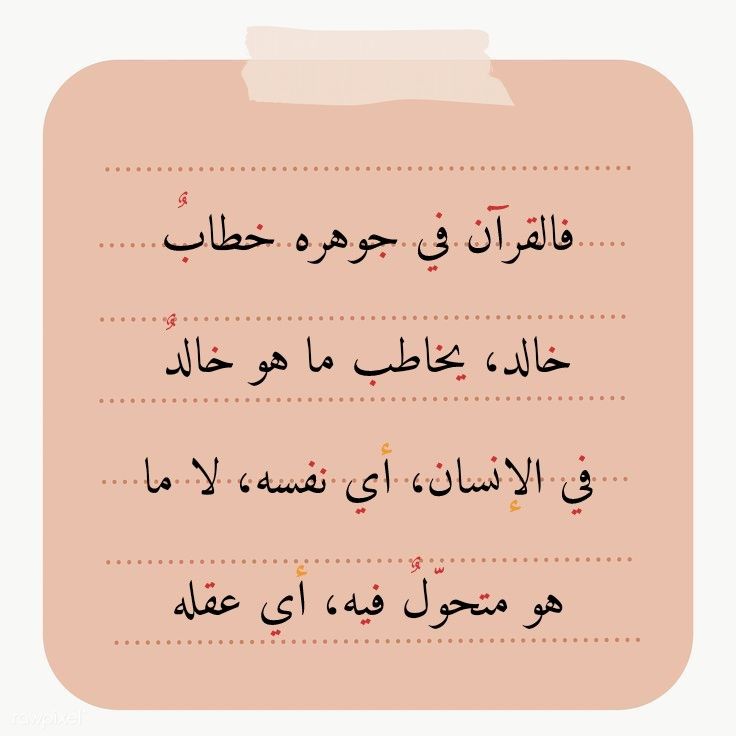
يشهد الفكر الديني المعاصر موجةً متصاعدة من الدعوات إلى “تحديث” فهم النصوص المقدسة بما يتلاءم مع ما يسمّى بمتغيرات العصر. وتقوم هذه الدعوات على فرضية مفادها أن تطور الإنسان العقلي والعلمي والاجتماعي يستلزم إعادة قراءة النص القرآني قراءة جديدة تواكب هذه التحولات. غير أن هذا الاتجاه يغفل حقيقةً جوهرية تتصل بطبيعة الخطاب القرآني ذاته: أنه ليس خطابًا زمنيًّا موجَّهًا لعقلٍ متحوّلٍ، بل خطابٌ أنطولوجيٌّ موجهٌ إلى نفسٍ ثابتةٍ في ماهيتها.
ومن هنا تنبثق هذه الدراسة لتؤكد أن القرآن لا يُفهم على ضوء متغيرات العصر، بل يُفهم على ضوء ثوابته هو، التي تتجاوز الزمان والمكان، إذ يخاطب الإنسان في جوهره الوجودي لا في مظاهره التاريخية.
القرآن الكريم لا يتوجه إلى الإنسان بوصفه كائنًا ثقافيًا أو تاريخيًا، بل بوصفه كائنًا ذا نفسٍ واحدة تتكرر في كل زمان ومكان، وتخضع لنفس الانفعالات والرغبات والميول منذ نشأة الإنسان الأولى وحتى قيام الساعة.
فالاختلاف بين البشر لا يقوم على اختلاف النفوس في جوهرها، بل على تفاوت العقول التي تتأثر بالوراثة والبيئة والتعليم. ومن هنا فإن القرآن يخاطب الإنسان من داخل ذاته الثابتة لا من خارجها المتغير.
ولو كان الخطاب القرآني مقصورًا على العقل وحده، لتبدلت لغته ومفرداته وأساليبه مع تبدل العصور، إذ أن العقل ابن الزمن، يتحول ويتغاير بتغير معطياته. أما النفس فهي الثابت الوجودي الذي لا تطاله التبدلات التاريخية. ومن ثم، فإن ثبات الخطاب القرآني هو ضرورة وجودية، لا خيار لغوي أو تشريعي.
النص القرآني، في بنيته العميقة، يميّز بين مستويين في الكيان الإنساني:
• النفس: وهي مركز الإرادة والرغبة والاختيار، ومحلّ الابتلاء والتكليف.
• العقل: وهو أداة الإدراك والاستدلال والتبرير.
وبينما خضعت العقول لتحولات التطور البشري وما رافقه من تراكمٍ معرفيٍّ وتكنولوجي، فإن النفوس ظلّت ثابتةً في نزعاتها، خاضعةً لنفس الصراعات بين الخير والشر، بين الشهوة والعقل، بين الطاعة والتمرّد.
ولذلك فإن القرآن، بوصفه خطابًا موجَّهًا للنفس قبل العقل، لا يحتاج إلى إعادة تأويلٍ تتناسب مع تطور الأدوات الفكرية، لأنه يخاطب في الإنسان ما لم يتغير، لا ما يتغير فيه.
القرآن ليس كتابًا في التاريخ ولا في العلم، بل كتاب وجود يخاطب ما وراء الزمان في كيان الإنسان.
فالزمان يتبدل في مظاهره، أما الوجود الإنساني فهو في جوهره واحد. ومن ثم، فإن الخطاب القرآني لا يُستغنى عنه بتغير الأزمنة، لأن غايته ليست تفسير الظواهر، بل هداية الإنسان إلى التوازن بين فطرته الطبيعية ومقاصده الروحية.
فالإنسان، منذ لحظة خروجه من الطبيعة وتمرده على قوانينها، فقد توازنه الأصلي، وأصبح في حاجةٍ دائمةٍ إلى ما يعيد له هذا التوازن. والقرآن هو الوسيلة الوحيدة التي تكفل له تلك العودة الآمنة إلى الانسجام مع النظام الكوني، لأنه يمثل صوت الطبيعة الإلهية في مواجهة الاغتراب الإنساني الحديث.
إن الدعوة إلى “تحديث” فهم القرآن لتلائم مفاهيم العصر تقوم على خلطٍ بين التأويل التفسيري والتأويل التاريخي.
الأول مطلوبٌ لتجديد الوعي بالنص وفهمه بلغةٍ معاصرة، دون المساس بجوهره.
أما الثاني، وهو الذي يجعل النص تابعًا للزمن، فيُفضي إلى نسف ثباته وانحلال مرجعيته، لأن معايير العصر متغيرة بطبيعتها.
فكل عصرٍ يحمل منطقه الخاص، ومتى أصبح القرآن أسير هذا المنطق فقدَ صفة الإطلاق والدوام التي تميزه عن كل قولٍ بشري.
ومن هنا، فإن فهم القرآن على ضوء متغيرات العصر يعني جعل الإلهي تابعًا للإنساني، وهو انقلابٌ في سلم القيم، ومحوٌ لخصوصية الوحي بوصفه معيارًا يقاس به الواقع لا العكس.
القرآن لا يهدف إلى مراكمة المعرفة بقدر ما يسعى إلى ترقية النفس الإنسانية حتى تبلغ كمالها الممكن.
فهو مشروع لإعادة الإنسان إلى فطرته الأولى بعد أن أفسدها الغرور العقلي والتمرد على النظام الطبيعي.
ومن ثم، فإن الخطاب القرآني هو نداء إلهيٌّ دائمٌ للإنسان ليعود إلى ذاته، إلى إنسانيته الأصيلة، لا إلى “حداثته” المصطنعة.
بهذا المعنى، لا يكون القرآن ضدّ التطور، بل هو المعيار الذي يضبطه ويوجّهه نحو مقاصده الروحية والأخلاقية. فالقرآن لا يُعارض الزمن، لكنه لا يخضع له، لأنه جاء ليعلو عليه، كما يعلو الوجود الإلهي على حركة التاريخ.
إنّ القول بعدم جواز فهم القرآن على ضوء متغيرات العصر ليس دعوة إلى جمودٍ فكري، بل إلى تحرير الفهم من الارتهان للزمن.
فالقرآن في جوهره خطابٌ خالد، يخاطب ما هو خالدٌ في الإنسان، أي نفسه، لا ما هو متحوّلٌ فيه، أي عقله.
وكل محاولةٍ لتأويل القرآن وفق شروط الحاضر إنما هي خضوعٌ للزائل، وابتعادٌ عن الجوهر الثابت الذي جعله الله هدى للبشر في كل زمانٍ ومكان.
وبذلك، يبقى القرآن هو الحبل الممتد بين الله والإنسان، لا بين الإنسان وعصره، ومن ثم فإن ثبات خطابه هو ما يضمن خلود رسالته واستمرار فاعليتها في الوجدان الإنساني، ما دام الإنسان هو الإنسان، في كل عصر، وتحت كل سماء.
