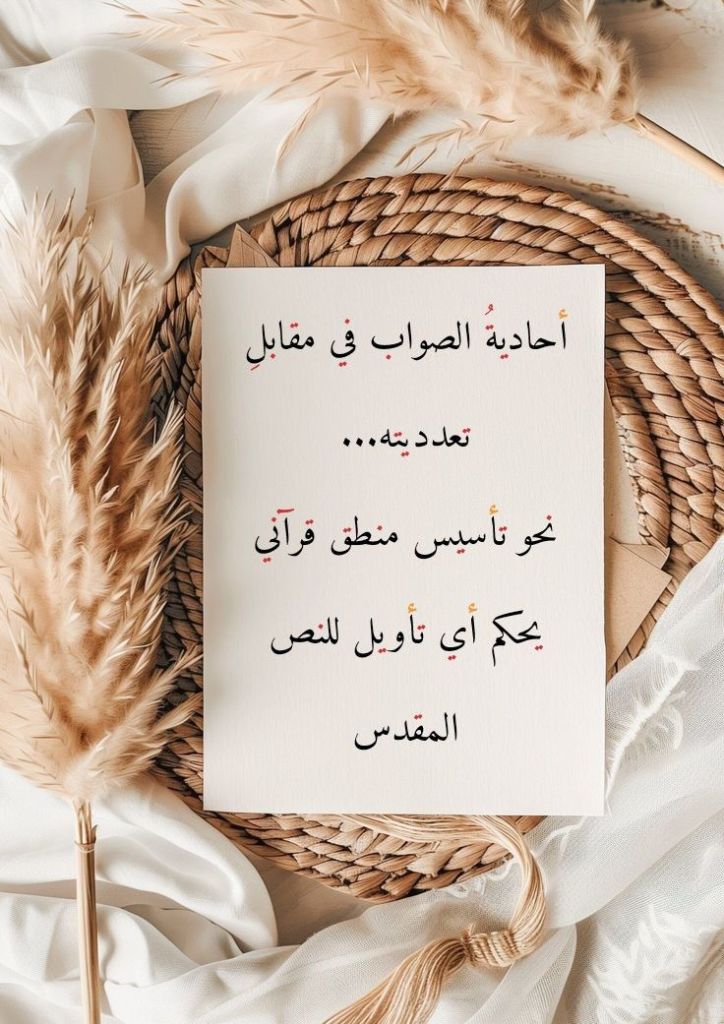
تُعَدُّ مسألة “أحادية الصواب” في فهم النصّ القرآني من أكثر القضايا حساسيةً في ميدان التفسير المعاصر، إذ تتقاطع فيها الأسئلة اللاهوتية بالأسئلة الإبستمولوجية والمنطقية. وقد شهدت العقود الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في الدعوات التي تنادي بـ”تعددية الصواب” بوصفها مظهرًا من مظاهر الانفتاح المعرفي ومقاومة النزعة الإقصائية. غير أن هذا المنحى —على ما يبدو من تحررٍ ظاهري— ينطوي على مفارقة خطيرة، إذ يفضي إلى نسف البنية المنطقية التي يقوم عليها النصّ الإلهي ذاته.
تسعى هذه الدراسة إلى تبيين التناقض البنيوي الكامن في فكرة “تعددية الصواب” من منظور قرآني ومنطقي، وإلى بيان كيف أن القرآن الكريم يرسّخ —في مستوى الدلالة والبرهان— مبدأَ وحدة الحقيقة وأحادية الصواب، بوصفهما شرطين ضروريين لقيام العقل الديني بوظيفته المعرفية.
يُقدَّم مفهوم “تعددية الصواب” في الأدبيات الحداثية بوصفه تجاوزًا للجمود التفسيري، وانفتاحًا على إمكانات المعنى المتعددة. غير أن هذه المقاربة —حين تُنزَع من ضوابطها المنطقية— تتحول من تعدد في الفهم إلى تناقض في الحقيقة. فالاختلاف التأويلي مشروع ما دام يجري داخل أفق النصّ وضمن حدوده، أما إذا قاد إلى نتائج متعارضة يستحيل الجمع بينها، فإننا نكون بإزاء تقويضٍ للمنطق القرآني الذي يجعل من الحق وحدةً متعالية على النسبية.
إن القول بتعدد الصواب لا يكتفي بفتح باب الاجتهاد، بل يفتح معه باب الفوضى المعرفية، إذ يغدو النصّ عندئذٍ فضاءً مفتوحًا لأيّ تأويلٍ مهما ابتعد عن مقاصده الأصلية. وهو ما يتنافى مع طبيعة الخطاب القرآني الذي لا يقدّم ذاته كمجموعةٍ من الاحتمالات التأويلية المتكافئة، بل كحقيقةٍ توجيهيةٍ هاديةٍ إلى صراطٍ واحدٍ مستقيم.
إن مبدأ أحادية الصواب يجد أساسه الصريح في البنية المفهومية للقرآن الكريم؛ فالنصّ القرآني لا يتحدث عن “حقائق متعددة”، بل عن “الحق” في مقابل “الضلال”، وعن “الصراط المستقيم” في مقابل “السبل المتفرقة”. وتكفي الإشارة إلى عدد من الآيات التي تُبنى دلالتها على القطع المنطقي لا على التعدد التأويلي:
(فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ) (يونس: 32) — تقرر الثنائية المطلقة بين الحق والباطل، وتنفي إمكان وجود منطقة رمادية بينهما.
(قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ) (المائدة: 100) — تؤكد أن الكثرة لا تمنح الباطل شرعية معرفية.
(بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ) (الأنبياء: 18) — تجعل العلاقة بين الحق والباطل علاقةَ صدامٍ وجودي، لا تكاملٍ احتمالي.
(وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ) (الأنعام: 153) — تُقرِّر وحدة الطريق ورفض التفرّق التأويلي.
تؤسس هذه الآيات لمعيار معرفي واضح: الحق واحد والباطل متعدّد، ومن ثم فإن المنطق القرآني ينتمي إلى منظومة الحقيقة الواحدة لا إلى منظومات النسبية المعاصرة.
من منظور فلسفة اللغة الدينية، يتأسس الفهم القرآني على وحدة الخطاب ووحدة القصد، لا على تعدد الأفهام المتضادة. فالمعنى في النصّ القرآني لا يُستنبط من الخارج عليه، بل من داخله، وفق شبكةٍ من العلاقات الدلالية التي تُبقي المعنى في أفق الوحدة.
إن تعددية الصواب تفترض —ضمناً— أن النصّ عاجز عن ضبط معناه، أو أنه مفتوح بلا قيد على كل تأويل، وهذا في ذاته نفيٌ لصفة الإعجاز البياني التي يقوم عليها القرآن.
أما التنوّع المشروع في التفسير، فهو تنوعُ زوايا النظر، لا تعددُ الصواب. أي إنّ المفسرين قد يختلفون في التطبيق أو التمثيل أو المقام الخطابي، لكنهم لا يمكن أن يصيبوا جميعًا في معانٍ متناقضة. فالحقّ في النصّ الإلهي ليس قابلًا للانقسام، وإنما هو كلٌّ منطقيّ متكامل.
يتجاوز مبدأ أحادية الصواب حدود الموقف الديني إلى الفضاء الفلسفي الأشمل؛ إذ يعبّر عن ضرورة أن يكون الوجود ذاته منظمًا وفق قانون التناقض المنطقي الذي لا يسمح باجتماع النقيضين. إن القرآن —من حيث هو خطاب إلهي— لا يمكن أن يناقض هذا القانون، لأنه صادر عن مصدرٍ هو عينُ الحقيقة. ومن ثمّ، فإن الدفاع عن وحدة الصواب في التفسير هو في جوهره دفاعٌ عن منطق الوجود نفسه، وعن انسجام الحقيقة الدينية مع الحقيقة العقلية.
ولعلّ قول العرب “الحق أبلج والباطل لجلج” يلخّص هذه الفلسفة في صورةٍ مأثورية مكثّفة: فوضوح الحقّ من وضوح العقل، والتباس الباطل من اضطراب المنطق.
تُظهر القراءة التحليلية للخطاب القرآني أن وحدة الصواب ليست خيارًا تأويليًا بين خيارات، بل مبدأ تأسيسي في نظرية المعرفة القرآنية. فالدعوة إلى “تعددية الصواب” لا تعبّر عن انفتاحٍ معرفي بقدر ما تعبّر عن تفككٍ في معايير المنطق وضياعٍ في تحديد الحقيقة.
إنّ القرآن لا يدعو إلى إقصاء التعدد في الفهم، بل إلى توحيد منطلقاته على قاعدة الحقّ الواحد، كما جاء في قوله تعالى:
(وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ).
من هنا، فإن العودة إلى المنطق ليست ترفًا فكريًا، بل هي استعادةٌ لشرط الوعي القرآني ذاته؛ شرطٍ يجعل من التفسير فعلَ عقلٍ منضبطٍ بالحقيقة، لا انفعالَ رغبةٍ تائهةٍ في ظنون التأويل.
