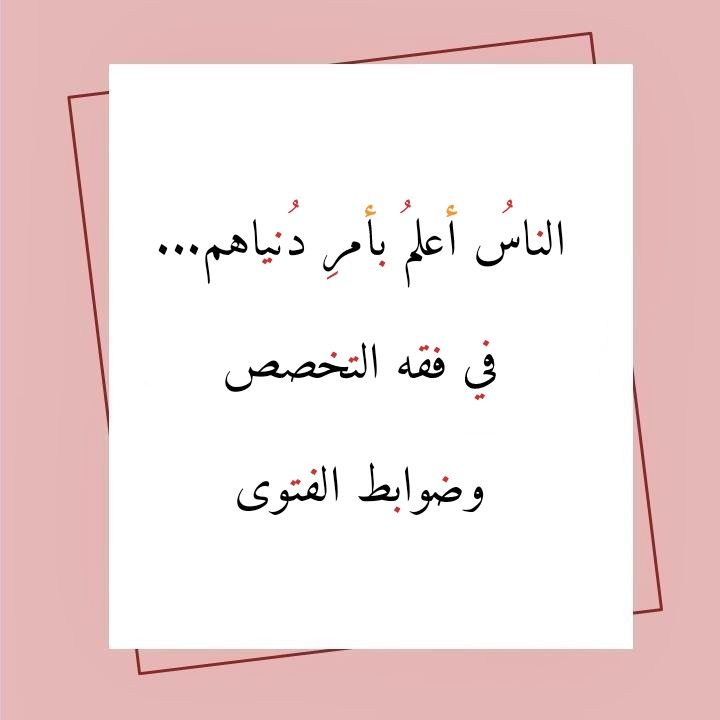
لم يكن النبيّ محمد صلّى اللهُ تعالى عليه وسلّم مجرّد رسولٍ مبلِّغ، بل كان في جوهر رسالته معلّمًا للناس. وقد شهد هو على نفسه بذلك حين قال: «إنما بُعثتُ معلّمًا»، ليؤكد أنَّ التعليم النبويّ ليس تعليمًا للمواعظ فحسب، بل منهجًا شاملًا يقوم على التربية بالقدوة، والشرح بالمثال، والتوجيه بالخبرة والمعايشة.
وهذه السمة التعليمية ليست حكرًا على خاتم الأنبياء، بل هي خيطٌ ناظمٌ يجمع الأنبياء جميعًا: فالمسيح عليه السلام كان معلّمًا لحوارييه، وموسى عليه السلام كان معلّمًا لقومه. غير أنّ التعليم النبويّ في الإسلام امتاز بكونه تعليمًا حيًّا مفتوحًا على التجربة اليومية، كما سنرى في الموقف الذي أسّس لقاعدةٍ معرفية خالدة: «الناس أعلمُ بأمر دنياهم».
يروي صحيح مسلم أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم مرَّ بقومٍ يُلقِّحون نخلهم فقال لهم: «لو لم تفعلوا لصلح»، فتركوه، فخرج النخل شيصًا. فلما علم صلّى الله عليه وسلّم بذلك قال: «أنتم أعلمُ بأمر دنياكم».
في ظاهر القصة تعليمٌ زراعيّ، وفي باطنها درسٌ إبستمولوجيّ عميق في حدود المعرفة البشرية. فالنبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن بصدد التشريع في أمرٍ دُنيويّ تجريبي، وإنما كان يذكّرهم بضرورة التمييز بين المجال الديني التشريعي الذي يختصّ به الوحي، وبين المجال الدنيويّ التجريبي الذي تُدركه العقول بالتجربة والخبرة.
بهذه الجملة القصيرة، أسّس النبيّ صلّى الله عليه وسلّم مبدأً معرفيًا عظيمًا يسبق كلّ نظريات التخصص الحديثة: أن المعرفة نسبية ومجالاتها متعددة، وأنّ كلّ علمٍ له أهله، فلا يجوز لأحدٍ أن يتكلم في ما لا يحسنه.
تنبثق من الحديث قاعدة حضارية كبرى: «استعينوا على كل صنعةٍ بصالح أهلها».
إنّها دعوة إلى احترام التخصص والكفاءة، وإلى إدراك أنّ الخبرة العملية ليست منزلةً دونية، بل هي من تمام العقل والتكليف. ولولا هذا الفهم الرفيع، لما قامت حضارة ولا نُظِّم مجتمع.
وفي ضوء هذا الفقه التخصّصي، يتبيّن أنَّ قول النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم ليس تفويضًا مطلقًا للدنيا بحيث تنفصل عن الدين، بل هو تحديد دقيق لنطاق العمل العقلي التجريبي الذي يظلّ في انسجامٍ مع الوحي ولا يتناقض معه.
فالنبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم علّمنا أنَّ الإيمان لا يُلغي التجربة، وأنّ التدين لا يتنافى مع العلم، بل إنَّ التكامل بينهما هو جوهر الرسالة المحمدية التي أقامت التوازن بين الوحي والعقل، والغيب والشهادة، والعبادة والعمل.
لو أنّ المسلمين التزموا بهذا المبدأ النبويّ، لما عانينا اليوم من فوضى الفتاوى والآراء المتسرّعة التي تصدر من غير أهل الاختصاص، سواء في الدين أو الطب أو السياسة أو العلم.
لقد صارت الساحة المعرفية تعجّ بمن «يفتون» في كلّ شيء: من الفقه إلى الفيزياء، ومن علم النفس إلى الاقتصاد، ومن تفسير القرآن إلى تشخيص الأمراض!
وهكذا، تحوّلت منصّات التواصل إلى منابر لكلّ من «هبّ ودبّ»، حتى صار الخطر الأكبر ليس في الجهل نفسه، بل في الجهل المتكلم الذي يتزيّن بلباس المعرفة.
إنّ هذا الوضع يعكس غياب الأدب النبويّ في طلب العلم، وهو الأدب الذي يقوم على الاعتراف بالجهل حيث لا علم، والصمت حيث لا اختصاص، والإنصات حيث لا خبرة.
فـ«الناسُ أعلمُ بأمر دنياهم»، ولكن ليس جميع الناس؛ بل صالِحو أهل كلّ صنعةٍ هم أعلمُ من غيرهم بأمرها، كما قال صلّى الله عليه وسلّم.
إنَّ هذا الحديث يُعيد تعريف العلاقة بين الدين والعقل، لا من موقع التعارض، بل من موقع التكامل في إدارة الوجود.
فالدين يُهذّب الضمير ويقوّم النية، والعقل يُهندس الفعل ويُتقن العمل.
وحين يختلط المجالان، تضيع الحكمة ويتعطل الاجتهاد. ومن هنا، كان قول النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم: «أنتم أعلمُ بأمر دنياكم» دعوةً إلى تأسيس أخلاق معرفية تجعل من العلم مسؤولية، ومن القول بغير علم خطيئة.
إنّ طاعة الله ورسوله ليست طاعة عاطفية عمياء، بل التزامًا بمنهجٍ تربويّ يُعلّم الإنسان أن يعرف حدوده قبل أن يتكلم، وأن يُحسن الظنّ بخبرة غيره قبل أن يُنكرها.
فمن أراد أن يكون من أهل الطاعة حقًّا، فليتعلم من المعلّم الأعظم أنَّ الكلمة أمانة، وأنَّ الفتوى بغير علم خيانةٌ للعقل والدين معًا.
وهكذا، يبقى حديث النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم هذا شاهدًا خالدًا على أنّ الإسلام دين عقلٍ وعملٍ، لا يُقصي التجربة، بل يُهذّبها، ولا يقدّس الجهل، بل يحمي الإنسان من آثاره.
