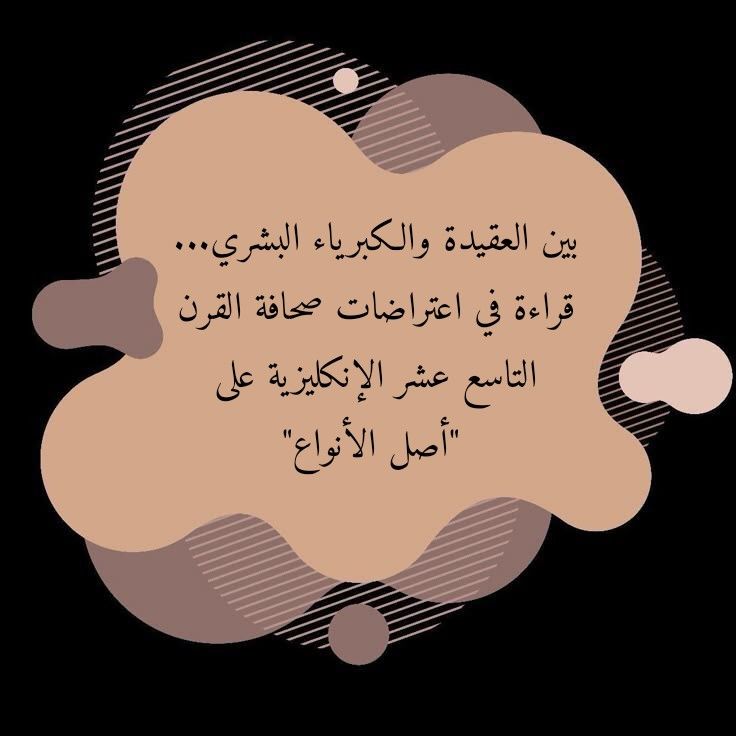
يشكل صدور كتاب أصل الأنواع “On the Origin of Species” عام 1859 نقطة تحوّلٍ كبرى في الفكر الغربي الحديث؛ إذ لم يقتصر تأثيره على المجال العلمي الضيق، بل امتد إلى الفلسفة واللاهوت والأدب، وأعاد رسم العلاقة بين الإنسان والطبيعة. وقد أثار هذا الكتاب جدلًا واسعًا في الصحافة الإنكليزية، حيث تسابق كتّاب الأعمدة والمفكرون اللاهوتيون إلى مهاجمة النظرية الجديدة، معتبرين إياها خطرًا على الإيمان ومساسًا بكرامة الإنسان.
غير أن القراءة التحليلية لتلك الاعتراضات تكشف أن الدافع الحقيقي وراءها لم يكن الدفاع عن الإيمان بقدر ما كان الدفاع عن الصورة النرجسية للإنسان بوصفه “أعظم المخلوقات”.
شهدت إنكلترا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحوّلاتٍ فكرية عميقة، كان من أبرزها الانتقال من النظرة اللاهوتية-الطبيعية إلى المقاربة العلمية-التحليلية للطبيعة. وقد مثّل كتاب داروين ذروة هذا التحوّل.
لكن هذا التحوّل اصطدم مباشرة بموروث طويل من الأنثروبوسنترية (Anthropocentrism)، أي مركزية الإنسان في الكون، وهو مبدأ ترسّخ عبر قرون من التأويل اللاهوتي والميتافيزيقي. ولذلك، فإن مقاومة نظرية التطور لم تكن نتيجة خلافٍ على الآلية البيولوجية للتطور، بل كانت مقاومة رمزية لفكرة زوال التفوق الإنساني الموروث.
تُظهر مراجعة المقالات المنشورة بين ستينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر في صحف مثل The Times، وThe Quarterly Review، وPunch Magazine، أن نبرة الرفض لم تكن علمية الطابع، بل أدبية-خطابية تتوسل السخرية والتقريع العاطفي أكثر من الاستدلال.
فقد وُصفت نظرية داروين بأنها “إهانة للإنسان” و”إلغاء لكرامته الممنوحة من الخالق”، واعتُبر القول بأصلٍ حيوانيٍ للإنسان “تجديفًا ضد الروح الإلهي”. ومع ذلك، فإن تحليل تلك النصوص يُظهر أن الاعتراض لم يكن موجَّهًا إلى مضمون الأدلة التجريبية التي قدّمها داروين، بقدر ما كان رفضًا للنتيجة الوجودية التي تترتب عليها، أي انهيار الحاجز الرمزي الذي يفصل الإنسان عن الحيوان.
تذرّع العديد من اللاهوتيين الإنكليز، مثل صموئيل ويلبرفورس (Samuel Wilberforce)، بأن النظرية تتناقض مع “الخلق الخاص” للإنسان كما ورد في سفر التكوين. غير أن الحوار الذي دار بينه وبين العالم توماس هكسلي (Thomas H. Huxley) عام 1860 في أكسفورد يكشف جوهر القضية:
حين سأل ويلبرفورس هكسلي إن كان جده من جهة الأب أم الأم قردًا، أجابه هكسلي بأنه لا يخجل من جدّه الحيواني، بل يخجل من إنسانٍ يستخدم عقله للسخرية من الحقيقة. هذه الواقعة الرمزية تختزل الصراع برمّته: ليس بين العلم والدين، بل بين التواضع أمام الطبيعة والغطرسة أمامها.
لم تقدّم الاعتراضات أي محاولة لبديلٍ تفسيريٍّ يقوم على الملاحظة أو البرهان. فبدلًا من مناقشة مفاهيم الانتقاء الطبيعي والتكيف الوراثي، ركزت المقالات على إنكارٍ وجدانيٍّ صرف: “كيف يكون الإنسان ابنًا للحيوان؟”.
وهذا الإنكار نابع من جرحٍ نرجسيٍّ حضاري، بحسب تعبير فرويد لاحقًا في تحليله لما سماه “الضربات الثلاث لغرور الإنسان”: ضربة كوبرنيكوس (ليست الأرض مركز الكون)، وضربة داروين (ليس الإنسان كائنًا متفرّدًا)، وضربة فرويد نفسه (ليس العقل سيد ذاته). فالرفض إذًا كان دفاعًا عن امتيازٍ رمزيٍّ أكثر منه عن عقيدةٍ دينية.
أعاد داروين، دون قصدٍ لاهوتي، تعريف علاقة الإنسان بالكائنات الأخرى على نحوٍ ساوى بينها في الأصل والغاية. غير أن المجتمع الفيكتوري، القائم على الطبقية والتراتبية، لم يكن مهيّأً لقبول تصورٍ كهذا.
فالاعتراف بأن الإنسان والحيوان يتقاسمان أصلًا مشتركًا كان يعني المساس ببنية السلطة الاجتماعية والسياسية ذاتها التي تستمد مشروعيتها من فكرة التفوق الطبيعي. لذا، فإن مقاومة النظرية كانت في جوهرها مقاومة للديمقراطية الأنطولوجية التي تقترحها فكرة التطور.
تكشف قراءة اعتراضات الثلث الأخير من القرن التاسع عشر على “أصل الأنواع” أن تلك الحملات لم تكن موجهة ضد داروين بقدر ما كانت دفاعًا عن الإنسان ضد صورته الجديدة.
لقد تذرعت باللاهوت لتخفي خلفها نزعة الكبرياء البشري الذي يأبى الاعتراف بانتمائه إلى السلسلة الحيوية ذاتها التي ينتمي إليها الحيوان.
إن الصراع لم يكن إذًا بين الإيمان والعلم، بل بين التواضع أمام الحقيقة والإصرار على الأسطورة.
وما كان يبدو آنذاك دفاعًا عن العقيدة لم يكن في حقيقته سوى تمسّكٍ بمركزيةٍ زائفةٍ للإنسان، سرعان ما بدأ الفكر الحديث يتجاوزها في سبيل رؤيةٍ كونية أكثر اتساعًا وعدلًا للطبيعة والوجود.
