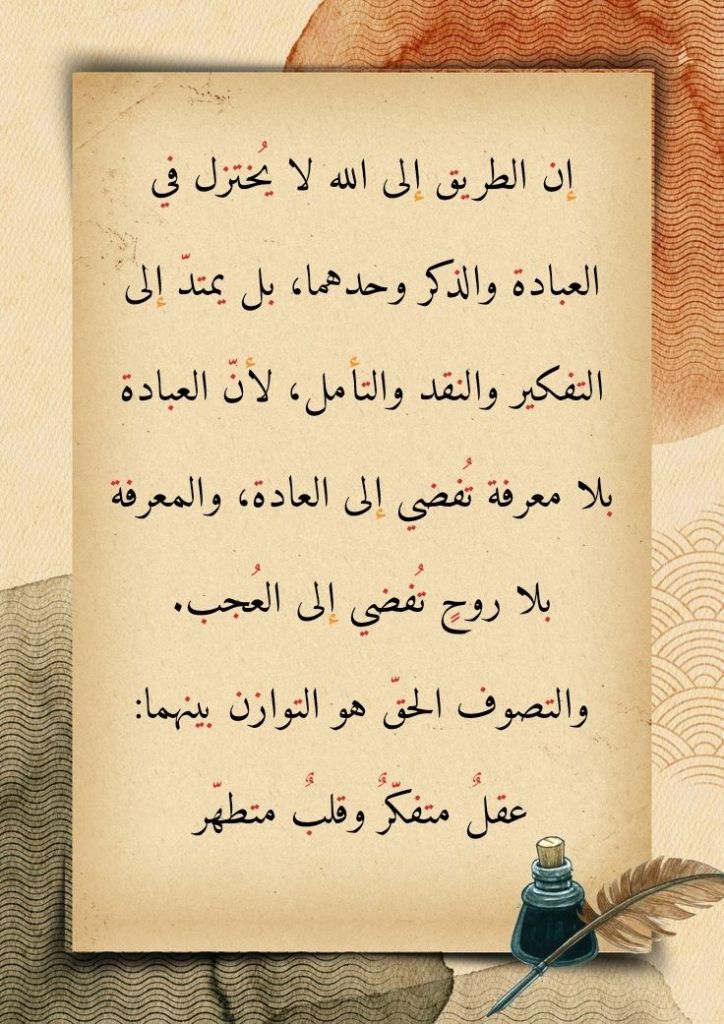
تعرّضت الكتابات المنشورة في صفحتين لي ــ إحداهما مكرّسة لبحث المفاهيم الصوفية، والأخرى معنونة بـ يوميات باحث عن الحقيقة: الطريق إلى الله ــ إلى مجموعة من التساؤلات والاعتراضات التي انطلقت من فرضية مؤدّاها أن الموضوعات التي تتناولها هذه المقالات لا تمتّ بصلة إلى الدين أو التصوف. وقد استند أصحاب هذه الاعتراضات إلى ملاحظتهم حضورَ موضوعات فلسفية، ولغوية، وفكرية، وسياسية في ما يُفترض أنه مجال تعبّدي أو روحي بحت.
غير أنّ هذه الرؤية النقدية تكشف عن نمطٍ من التفكير التجزيئي الذي ورثته الأذهان الحديثة من تاريخ طويل من الفصل بين الدين وسائر أنماط المعرفة. إذ ينطلق أصحابها من تصوّرٍ اختزالي يرى أن للدين مجالاً “تخصصياً” مغلقاً على الطقوس والشعائر، وأنّ ما عدا ذلك يُعدّ خروجاً عن نطاقه الشرعي أو الروحي.
ينبغي في المقام الأول الإشارة إلى أن التصوف، في جوهره، ليس مذهباً جزئياً من مذاهب الفكر الديني، بل هو نسق معرفي شامل يتجاوز حدود الفروع التخصصية للمعرفة. وقد عبّر أستاذي الصوفي عن ذلك بتعريفه البليغ للتصوف بأنه «علم العلوم»، أي العلم الذي تتقاطع عنده سائر المعارف وتتوحّد في مقاصدها العليا.
فالتصوف، بهذا المعنى، ليس علماً بالزهد أو العبادة فحسب، بل إدراكٌ كليٌّ لوحدة الوجود والمعرفة؛ إدراك يرى في كل علمٍ طريقاً إلى معرفة الحق، وفي كل ظاهرةٍ كونية أو إنسانية مظهراً من مظاهر الحقيقة الإلهية. ومن ثمّ، فإن مقاربة الموضوعات الفلسفية أو السياسية أو اللغوية ليست انحرافاً عن الطريق الصوفي، بل هي تجسيد لمبدأ الوحدة المعرفية الذي يقوم عليه هذا الطريق.
المقاربة التي تفصل بين الدين والفكر، أو بين الروح والعقل، إنما تنطلق من إرثٍ لاهوتي-وضعي تشكّل في عصور ما بعد الانقسام بين العلم والإيمان. وهي مقاربةٌ تقوم على الازدواج المعرفي الذي يجعل الإنسان يعيش بوعيين متوازيين لا يلتقيان: وعيٍ ديني يتعامل مع النصوص والشعائر، ووعيٍ دنيوي يتناول السياسة والفكر والفلسفة.
أما الرؤية الصوفية، فتقوم على تجاوز هذا الانقسام عبر إعادة وصل الإنسان بحقيقته الكلية. فالمتصوف لا ينظر إلى المعارف من زاوية الانتماء المدرسي أو المذهبي، بل من زاوية ما تكشفه من “حضور الحق” في الوجود. ولذلك فإن كل حقل معرفي، مهما بدا بعيداً عن الدين، يمكن أن يكون سبيلاً إلى إدراك الحكمة الإلهية الكامنة فيه.
تقوم المقاربة الصوفية على مبدأ الحوار والانفتاح دون وصاية أو إقصاء. فهي تدعو إلى أن تُترك المذاهب الفكرية والمدارس الفلسفية تعبّر عن ذاتها بذاتها، حتى يتبيّن من داخلها مدى صدقها أو حاجتها إلى المراجعة. إنّ التصوف، من هذا المنظور، ليس في صراع مع العلم أو الفلسفة أو السياسة، بل هو الإطار الأعلى الذي يختبر صدقية هذه الحقول ويعيد توجيهها نحو غاياتها القصوى.
فحين يتناول الباحث الصوفي مسائل اللغة أو الوعي أو السلطة، فإنه لا يفعل ذلك من موقع المعارض الديني أو المصلح الاجتماعي، بل من موقع السالك الباحث عن الحقيقة في كل تجلّياتها. ومن هنا تنبع أهمية النظر الصوفي في الحقول المعرفية الحديثة: إذ يقدّم نموذجاً معرفياً يتجاوز الثنائية بين العقل والإيمان، بين الظاهر والباطن، وبين العلم والروح.
ينبغي تصحيح المفهوم الشائع الذي يربط التصوف بالانعزال والانسحاب من العالم. فالمتصوف الحقّ لا يهرب من الواقع، بل يواجهه بعينٍ مزدوجة: عين العقل التحليلي الذي يفهم الظواهر، وعين القلب التي تبصر المعنى المتجاوز لها.
ومن ثمّ، فإن الكتابة في الفلسفة أو السياسة أو اللغة ضمن إطارٍ صوفي ليست خروجاً عن الطريق إلى الله، بل هي امتدادٌ له في مجالات جديدة. فـ الطريق إلى الله لا يمرّ خارج العالم، بل عبر العالم ذاته؛ من خلال تفكيك أوهامه واكتشاف حقيقته.
إنّ إعادة الاعتبار للتصوف بوصفه “علم العلوم” تعني إعادة توحيد أفق المعرفة الإنسانية بعد قرونٍ من الانقسام والتجزئة. فحضور الفكر الفلسفي واللغوي والسياسي في التجربة الصوفية المعاصرة لا يُعدّ ترفاً فكرياً، بل هو ضرورة منهجية تفرضها طبيعة التصوف ذاته، بما هو مشروع لإدراك الحقيقة من خلال كلّ تجلياتها الممكنة.
وعليه، فإن الطريق إلى الله لا يُختزل في العبادة والذكر وحدهما، بل يمتدّ إلى التفكير والنقد والتأمل، لأنّ العبادة بلا معرفة تُفضي إلى العادة، والمعرفة بلا روحٍ تُفضي إلى العُجب. والتصوف الحقّ هو التوازن بينهما: عقلٌ متفكّرٌ وقلبٌ متطهّر.
