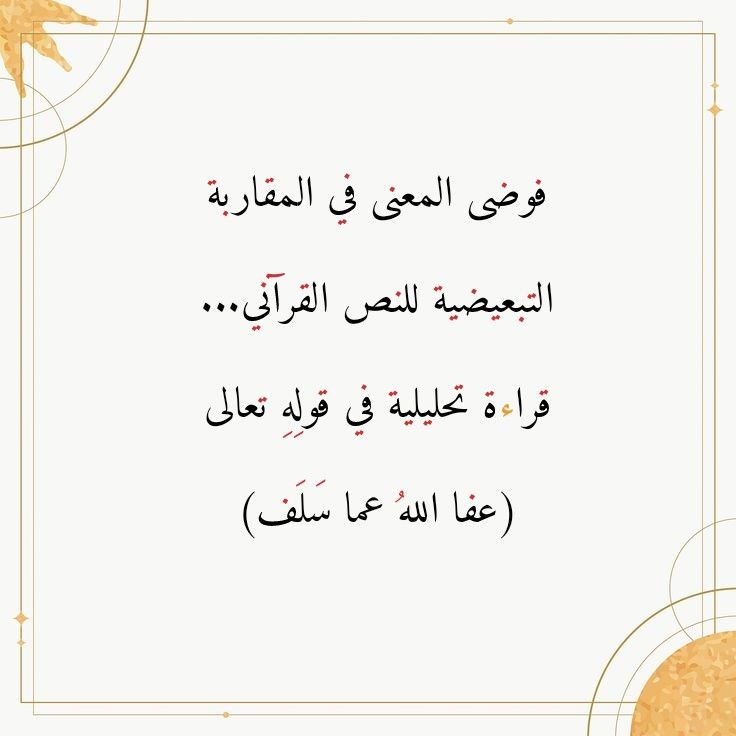
من أبرز ما أصاب العقل الديني المعاصر من عللٍ منهجيةٍ تلك التي يمكن تسميتها بـ”المقاربة التبعيضية التجزيئية” للقرآن الكريم؛ وهي المقاربة التي تتعامل مع النصّ الإلهي كما لو كان مجموعة مقاطع منفصلة يمكن اقتطاعها وإعادة توظيفها بما يخدم أغراضًا آنية أو أهواءً فكرية.
هذا النمط من القراءة لا يكتفي بإضعاف المعنى، بل يُنتج ما يمكن وصفه بـ”فوضى المعنى”، أي فقدان المعنى القرآني لوحدته التركيبية والوظيفية، ليغدو النصّ في نظر أصحابه ذريعة لتبرير السلوك لا مرجعًا لتقويمه.
القرآن الكريم في بنائه اللغوي والدلالي ليس مجموعة شذرات أو جمل متفرقة، بل نسيج منسجم تتكامل فيه الألفاظ والمعاني ضمن نظام سببيّ وبيانيّ محكم.
فكل جملة قرآنية – كما يقرر علم اللغة والسياق القرآني – تحمل معناها في ضوء ما قبلها وما بعدها. ولذلك، فإن أي محاولةٍ لاجتزاء جزءٍ من آيةٍ أو كلمةٍ منها لخلق معنى مستقل، تمثل خروجًا على نظام البيان القرآني نفسه.
من هنا كانت الآية الكريمة:
(أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) (النساء 82)
إشارةً إلى وجوب النظر في القرآن ككلٍّ متكاملٍ لا يقبل التفكيك.
كثيرًا ما تُتداول عبارة “عفا الله عما سلف” في الخطاب العام لتبرير التقاعس عن الإصلاح، أو لتمرير فكرة التسامح المطلق مع الأخطاء الماضية بمعزلٍ عن التوبة والنية الصادقة في الإصلاح.
غير أن هذا الفهم لا يمتّ إلى النص القرآني بصلة، إذ إن المقطع الكامل من الآية يقول:
(عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَام) (المائدة 95).
تُظهر الجملة الكاملة أن العفو الإلهي مشروط بعدم العود إلى الذنب، وأن من يعود بعد العفو فقد استوجب الانتقام الإلهي.
أي أن العفو في القرآن ليس تبرئة مطلقة، بل هو عفوٌ مؤقتٌ منوطٌ بصدق التوبة وسلوكٍ جديدٍ يقطع مع الماضي.
وبذلك يتبيّن أن اجتزاء “عفا الله عما سلف” من سياقها يُحوّلها من تحذيرٍ تربويٍّ إلى تبريرٍ سلوكيٍّ — وهو قلبٌ لمعنى النصّ وتناقضٌ مع مقاصده الأصلية.
يُحذّر القرآن الكريم من هذا النمط من التعامل المجتزأ مع نصوصه، إذ يُعدّ أحد مظاهر الهجر الذي اشتكى منه الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله تعالى:
(وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا) (الفرقان 30).
فالهجر هنا لا يقتصر على ترك التلاوة، بل يمتدّ إلى هجر التدبر الصحيح.
حين يُستبدل التدبر الكامل بالاستشهاد الانتقائي، يغدو القرآن حاضرًا لفظًا غائبًا روحًا.
إنها لحظة القطيعة المعرفية بين النص ومتلقيه: حين يُستعمل النص لتزيين الخطاب لا لتقويم الوعي.
ليست المقاربة التبعيضية ظاهرة تفسيرية فحسب، بل هي انعكاس لأزمةٍ في الوعي الديني والفكري؛ أزمة تتعلق بعجز الإنسان الحديث عن إدراك الكليّات.
فالتفكير التجزيئي هو ابن العقل الأداتي الذي يُجزّئ المعنى ليحيله إلى أداةٍ نفعية، بينما القرآن يُخاطب الإنسان الكُلّي الذي يُبصر الترابط بين القول والفعل، بين النصّ والكون، بين العفو والمسؤولية.
إن فهم القرآن بوصفه “كُلًّا حيًّا” لا “نصًّا مجزأً” هو ما يعيد للنصّ قدسيته وللقارئ مسؤوليته.
البديل عن هذا الفهم التجزيئي هو ما يمكن تسميته بـالمقاربة التركيبية الواعية، وهي التي تقوم على:
تلازم المعنى والسياق: فلا تُفهم آية إلا في ضوء ما قبلها وما بعدها.
استحضار المقاصد الكلية: بحيث يُقرأ كل حكم في إطار غايته الأخلاقية والتربوية.
وحدة الخطاب الإلهي: إذ تتكامل الآيات لتشكل نظامًا معرفيًا وأخلاقيًا متناسقًا.
التحرر من النزعة الأداتية التي ترى في النصّ وسيلة لتبرير الأهواء لا مرجعًا للهداية.
إن “فوضى المعنى” التي تنتج عن المقاربة التبعيضية ليست مجرد خلل لغوي أو تأويلي، بل هي فوضى وجودية تُفقد النصّ قدرته على إصلاح الإنسان والمجتمع.
فحين يُجتزأ النصّ، يُختزل الله في عبارة، وتُختزل الإرادة الإلهية في نوايا بشرية متقلبة.
وإنّ طريق الإصلاح يبدأ بإعادة الاعتبار إلى التدبر الشامل: أن نقرأ القرآن لا كما نهوى، بل كما أراد الله أن يُتلى ويُفهَم:
(كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ) (ص 29).
