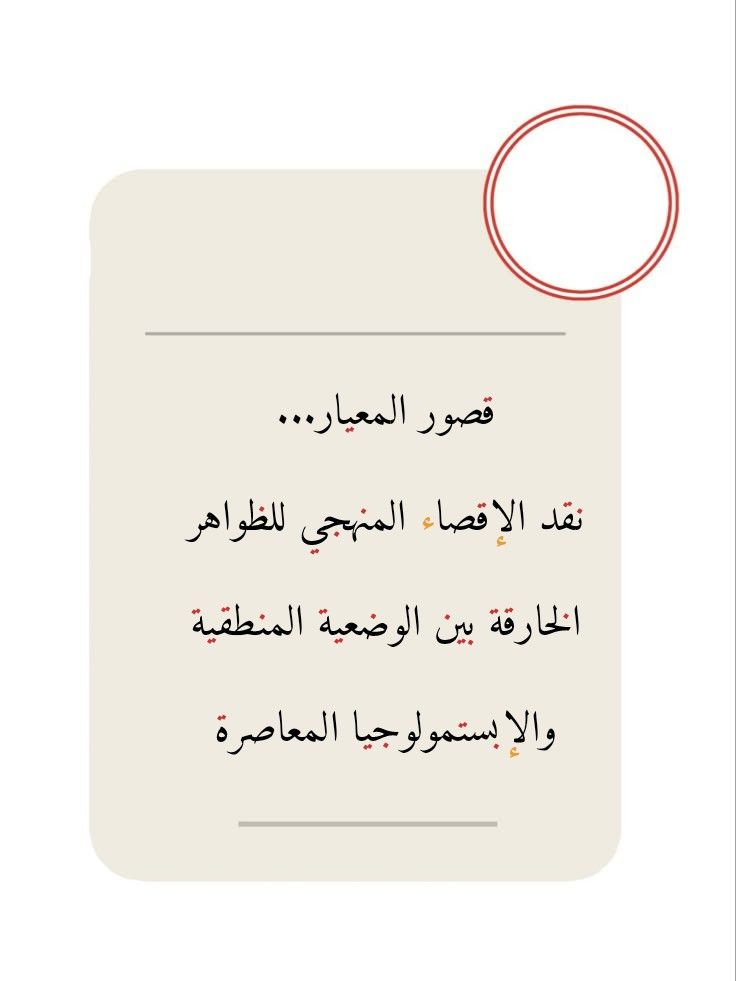
لطالما مثلت الظواهر المستعصية على التفسير العلمي تحدياً وجودياً ومعرفياً للفكر الغربي الحديث، خاصة بعد صعود المدارس الفلسفية التي اتخذت من المنهج التجريبي والعلمي معياراً وحيداً للصدق والحكم على إمكانية الوجود. تترسخ هذه النظرة في مقاربة المدرسة الوضعية المنطقية، التي قضت على الميتافيزيقا وكل ما يخرج عن نطاق التحقق التجريبي أو التحليل المنطقي بوصفه “لغواً” بلا معنى. وعلى الرغم من تراجع الموقف المطلق للوضعية، فإن الإبستمولوجيا المعاصرة لا تزال تمارس شكلاً من أشكال الإقصاء المنهجي؛ فإما أن الظاهرة خاضعة للتفسير العلمي فيُحكم عليها بالوجود، وإما أنها مستعصية على هذا التفسير فيُحكم عليها باستحالة الوجود أو تُصنف كعلم زائف.
إن هذا الاقتصار على التفسير العلمي كمعيار أوحد للحكم على إمكانية الوجود من عدمه هو في حقيقته قصور منهجي، يحجب عنا القدرة على استيعاب مستويات أعمق من الواقع.
إن القصور المنهجي لهذه المقاربات يتجلى بوضوح في وجود ظواهر تم التثبت من حدوثها – حتى وفقاً للمعايير الصارمة للمنهج التجريبي – لكنها تتعارض وتتناقض بشكل مباشر مع القوانين التي استقامت عليها منظومتنا المعرفية. فظواهر من قبيل الشفاء الخارق للجروح المتعمد إحداثها في الجسم، كما يُمارس في سياقات معينة (كالتي تنسب لبعض الدراويش الصوفية أو ممارسات روحانية)، تمثل دليلاً قاطعاً على هذه الإشكالية.
إن حدوث شفاء جذري للجروح في دقائق معدودة، مع انتفاء حدوث أي مضاعفات أو شعور بالألم، يتعارض كلياً مع قوانين البيولوجيا والفسيولوجيا المستقرة التي تحكم آليات التجلط، والالتهاب، وتكوّن الأنسجة، والتي هي مرتكزات الحياة البيولوجية. إن قبول هذه الظواهر كوقائع مثبتة مختبرياً يحتم علينا إعادة النظر في الحكم المطلق الذي يربط الوجود بالضرورة بالتفسير العلمي الحالي.
إن القول بـ “استحالة الوجود” هنا ليس سوى انعكاس لعجزنا المعرفي عن استيعاب الواقعة ضمن إطارنا الحالي، وليس دليلاً على عدم وجودها.
إن مواجهة هذا القصور تقتضي منا خطوتين جوهريتين: تثوير النظرة إلى الوجود، ومن ثم تثوير المقاربة الإبستمولوجية للظاهرة الخارقة.
1. ثورة في نظرتنا للوجود (الأنطولوجيا):
يجب أن ننطلق من فرضية أن القوانين التي تتحكم في ظواهر الوجود غير قابلة للخرق على الإطلاق. فالظواهر المسماة “خارقة” ليست خرقاً لقوانين الوجود، بل هي نتاج “قوانين أخرى” مرتبطة بـ “قوى أخرى” لم يتم استيعابها بعد في المنظومة المعرفية الغالبة.
2. ثورة في مقاربتنا الإبستمولوجية:
يجب أن نتقبل وجود نظام معرفي آخر يسمح بتواجد هذه “القوى الأخرى” وتجليها، وفقاً لمنطق يختلف عن منطقنا المادي الصارم. هذا التقبل لا يعني العودة إلى الميتافيزيقا الساذجة، بل يعني بناء إطار معرفي يدرك نسبية الإطار العلمي الحالي وشموليته الجزئية.
ضمن هذا الإطار الجديد، لا يكون مصير القوانين العلمية ذات الصلة هو “التلاشي” أو “النقض”، بل إنها “تتوارى” للحظات أو دقائق، حتى ينسحب تأثير تلك “القوى الأخرى” التي أدى تجليها المؤقت والمأجول إلى حدوث ما توهمناه خرقاً لقوانين الطبيعة. فقوانين الطبيعة لا تُخرق، ولكن تأثيراتها تتوارى وتتأخر استجابتها المعتادة لحين انتهاء الأجل الموقوت لتلك القوانين الأخرى، التي تفرض حضورها في ظروف محددة.
إن الحقيقة الأنطولوجية للظواهر الخارقة تكمن في كونها نتاج قوانين وجودية أخرى لم نكتشفها، وليست نقضاً لقوانيننا المعروفة. فالأمر ليس ثنائية وجود/لاوجود، بل هو تعددية في القوانين والأنظمة المعرفية.
يجب على الإبستمولوجيا المعاصرة أن تتجاوز الوثوقية المنهجية التي ورثتها عن الوضعية المنطقية، وأن تعترف بأن عجزها عن التفسير ليس دليلاً على الاستحالة، بل هو دعوة لتوسيع إطارها المعرفي. إن تثبيت الظواهر الخارقة مختبرياً هو الإثبات التجريبي لقصور المعيار المنهجي القائم، ويفتح الباب أمام تأسيس “نظام معرفي أوسع” يفسح المجال أمام تداخل المؤثرات الوجودية في سياقات زمنية ومكانية محددة.
