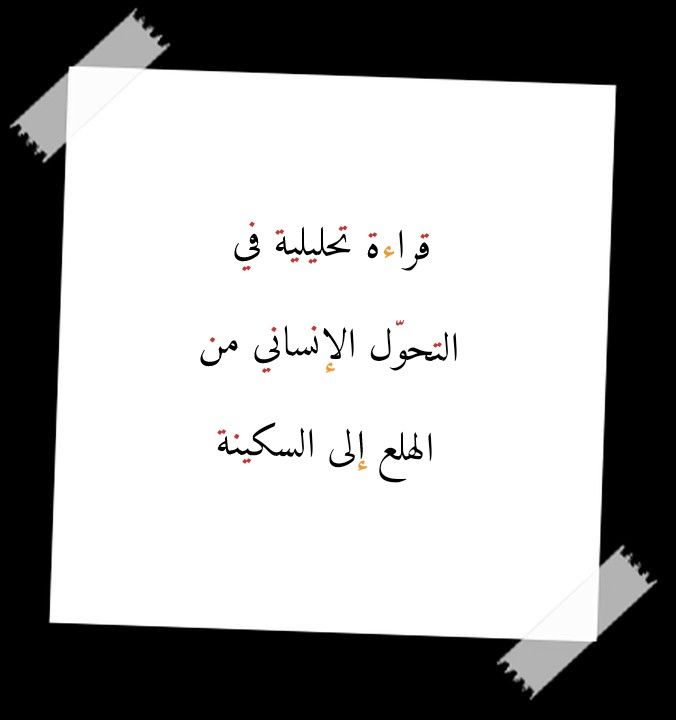
تبدأ سورة المعارج بواحدة من أكثر التشخيصات دقّةً لطبيعة الإنسان:
«إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا».
هذه الآيات لا تُقدِّم حكمًا أخلاقيًا، بل تُحدِّد بنية وجودية: فالإنسان مخلوق على هيئة من الهلع الوجودي، محكومٌ بشعورٍ دائمٍ بالعجز والخوف من الفقد، وبدافعٍ غريزيٍّ إلى التملّك والمنع. هو كائنٌ مفطورٌ على التناقض بين الرغبة في البقاء والخوف من الفناء، وبين توقه إلى الامتلاك وعجزه عن الاكتفاء.
لكن هذه الطبيعة المجبولة على القلق لا تُعدّ قدَرًا نهائيًا؛ فالنص القرآني لا يَختمُ الحكمَ على الإنسان إلا بفتح استثناءٍ يقلب المعادلة رأسًا على عقب:
«إِلَّا الْمُصَلِّينَ».
يأتي هذا الاستثناء لا كاستدراك لغوي بل كـبنية إنقاذية. فـ«إلّا المصلّين» ليست جملةً تُخرج فئةً من الناس فحسب، بل تُعلن بداية تحوّل نوعي في مسار الإنسان:
الإنسان، بحسب النص، مخلوق هلوع بطبعه، لكن المصلّي هو الإنسان الذي اختار أن يعيد توجيه هذا الهلع نحو الله، لا نحو العالم.
إن الهلع الذي كان يبدّده في الخوف من الفقد أو في التمسك بما يملك، يتحوّل بالصلاة إلى هلعٍ إيجابيٍّ: خوفٍ من الانقطاع عن الله، لا من انقطاع الرزق أو الجاه. وهكذا تتحوّل “الجبلة” من مصدر ضعفٍ إلى مصدرِ تَعَلُّقٍ بالمطلق.
الصلاة، في هذا السياق، ليست طقسًا بل عملية تحويل مستمرة لطاقة الهلع إلى طاقة سكينة.
إنها نظام لإعادة برمجة الإنسان ضد نزعاته الأولى.
حين يقوم المصلّي، يقف في مواجهة ذاته قبل أن يقف بين يدي ربّه؛
وحين يركع، يُخضع كبرياءه المجبولة على الفخر؛
وحين يسجد، يُعيد تعريف مركز الجاذبية في كيانه: من ذاته إلى الله.
ففي كل ركعةٍ، تُستنزف صفةٌ بشرية مذمومة:
• يُطفئ السجود جذوة الكِبر،
• ويُهذّب الركوع نزعة التملّك،
• ويُطهّر الدعاء من جَزع المطالب،
حتى يُصبح المصلّي إنسانًا خالٍ من علائق بشريته إلا بمقدار ما يثبت عليه وجوده.
حين يقول النص: «إلّا المصلّين»، فهو لا يتحدث عن جماعة طقسية، بل عن طبقة أنطولوجية من البشر ارتقت بوساطة الصلاة إلى مستوى آخر من الوجود.
إنهم الذين:
«هُم عَلَى صَلاتِهِم دَائِمُونَ».
الدوام هنا ليس زمانيًا، بل وجوديًا: أي أن الصلاة أصبحت نَفَسًا وجوديًا لا ينقطع، وعيًا دائمًا بالحضور الإلهي.
وبذلك، يتحرر المصلّي من الطبيعة البشرية التي خُلق بها، لا بإلغائها، بل بإعادة توجيهها نحو مقصدها الأعلى.
تقدّم الآيات تتابعًا يمكن قراءته كـ”سلسلة تحول نفسي-سلوكي”:
• الهَلَعُ يتحوّل إلى خشوع؛
• الجَزَعُ يتحوّل إلى ثباتٍ وصبر؛
• المَنعُ يتحوّل إلى سخاءٍ وبذلٍ في سبيل الله.
بهذا، لا تُلغى الطبيعة الإنسانية، بل تُعاد صياغتها.
فالإنسان الذي كان يخشى فقد ما عنده، أصبح يرى في العطاء تجلّيًا للوجود،
والذي كان يخاف المجهول، صار يجد فيه موضع لقاءٍ مع المطلق.
وهنا تتجلى عبقرية البنية القرآنية: إذ لا يطلب من الإنسان أن يتجاوز طبيعته بالإنكار، بل أن يهذّبها بالتوجيه.
الإنسان، في وصف القرآن، مخلوق يحمل سلسلةً من الصفات السلبية:
«ظلومًا، جهولًا، كفورًا، كنودًا، جزوعًا، منوعًا، فرِحًا فخورًا…»
غير أن الله تعالى يضع أمامه طريقًا واحدًا للتحوّل:
أن يفعل إرادته بالهدى، وأن يُفعّل هداه بالصلاة.
فالصلاة ليست إذعانًا، بل تحررًا من الإنسان الأدنى فينا، ذلك الإنسان المجبول على الخوف والتملّك والجدال. وهي الباب الوحيد إلى الإنسان الأعلى: إنسان الطمأنينة، الذي يجد في الخضوع قوة، وفي التسليم حرية.
أن تكون مصلّيًا لا يعني أن تؤدّي الصلاة،
بل أن تكون في حالة دائمة من التوجّه،
أن تكون كائنًا متحوّلاً من الانفعال إلى السكون،
من الذات إلى الحق،
من الفقد إلى الوجود.
وهكذا، تكشف الآية القصيرة:
«إِلَّا الْمُصَلِّينَ»
عن المعنى الأعمق للصلاة:
أنها الحدث التحويلي الأكبر في الكينونة الإنسانية،
الذي يُعيد للإنسان توازنه بين بشريته ونوره، بين خلقه وهداه.
