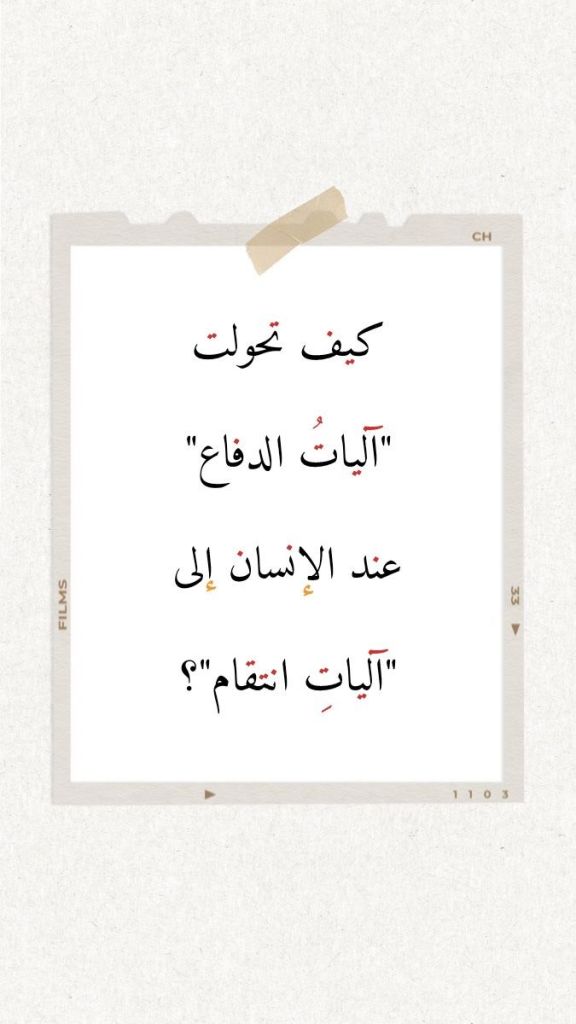
من أكثر الأدلةِ الحاسمة على أنَّ مقاربةَ البايولوجيا التطورية، المستندةَ إلى التصور الدارويني للكيفيةِ التي تنوعت بها الكائناتُ البايولوجية، هي مقاربةٌ فيها من الإيديولوجيا الشيء الكثير، أصرارها على غضِّ الطرْف عن كلِّ ما يتعارضُ مع هذا التصور الدارويني الذي نحَّى جانباً كلَّ ما يشهد بأنَّ هنالك فروقاتٍ جوهرية بين السلوكياتِ البشرية والسلوكيات الحيوانية. صحيحٌ أنَّ التشابهَ الفسيولوجي القائم بين الحيوانِ والإنسان يبلغُ أحياناً حدَّ التماثل المطلق، غير أنَّ هذا لا ينبغي أن يحيدَ بنا عما تُمليه علينا المقاربةُ الموضوعية لسلوكياتِ كلٍّ من الحيوانِ والإنسان. ولعل واحداً من أبرزِ الفروقات الجوهرية بين السلوكِ الحيواني والسلوكِ الإنساني هو ما تتمايز به آلياتُ الدفاع عند الحيوان عن مثيلاتِها عند الإنسان. فالحيوان لا يلجأ إلى الانتقام كما يفعلُ الإنسان، وذلك لشديدِ التزامِه بمحدِّدات آلياتِ الدفاعِ هذه التي لا تسمح له بأن يتجاوزَ الحدودَ التي حدَّدت قوانينُ الطبيعة ما ينبغي أن يكونَ عليه السلوكُ الحيواني في حالةِ الدفاع؛ هذه الحدود التي أصرَّ الإنسانُ على تعدِّيها وتجاوزِها، وبما جعله يجنح إلى الطغيان. فالطغيان لا مكان له في عالَمِ الحيوان، وذلك لتعارضِه مع المخططِ العام للطبيعة؛ هذا المخطط الذي لم يعد الإنسانُ يعبأ به منذ أن اختار الخروجَ على الطبيعةِ وقوانينِها بمحضِ إرادتِه.
وعلةُ انتفاءِ الطغيان في عالَمِ الحيوان تعود إلى كونه لا يتوافق مع واحدٍ من أبرزِ محدِّداتِ هذا المخطط العام. وهذا المحدِّد هو أن تكونَ هنالك “منفعةٌ تطورية” تكمن في كلِّ فِعلٍ غيرِ قياسي أو سلوكٍ ريادي. ويشهد طغيانُ الإنسان بانتفاءِ وجودِ أي تأثيرٍ لهذا المحدِّد، أو ما يماثلُه، حين تتوافر الظروف المحفِّزة لانبثاقِ هذا الطغيان. فالطغيان عند الإنسان يكمن مستتراً عن ناظرَيه، استتارَه عن أعينِ الآخرين، حتى تحينَ الفرصةُ ويسنحَ الظرفُ الذي يسمح لتحول الطغيان من طورِ الكمونِ والاستتار إلى طورِ التفشِّي والانتشار.
إن الماضي البشري يشهد للنوعِ الإنساني، شهادةَ حاضرِه، بأنَّ قلةً من أفرادِه لا يطغى واحدُهم حين تأتي الرياحُ بما تشتهي سَفَنُه. فكم من امرءٍ دمثِ الأخلاقِ وديع ما أن يتسنَّمَ منصباً قيادياً حتى ينقلبَ إلى كائنٍ تَحارُ العقولُ في توصيفِه وبما يتساوق مع ما أظهرَه في الأرضِ من عظيمِ الفساد؟
