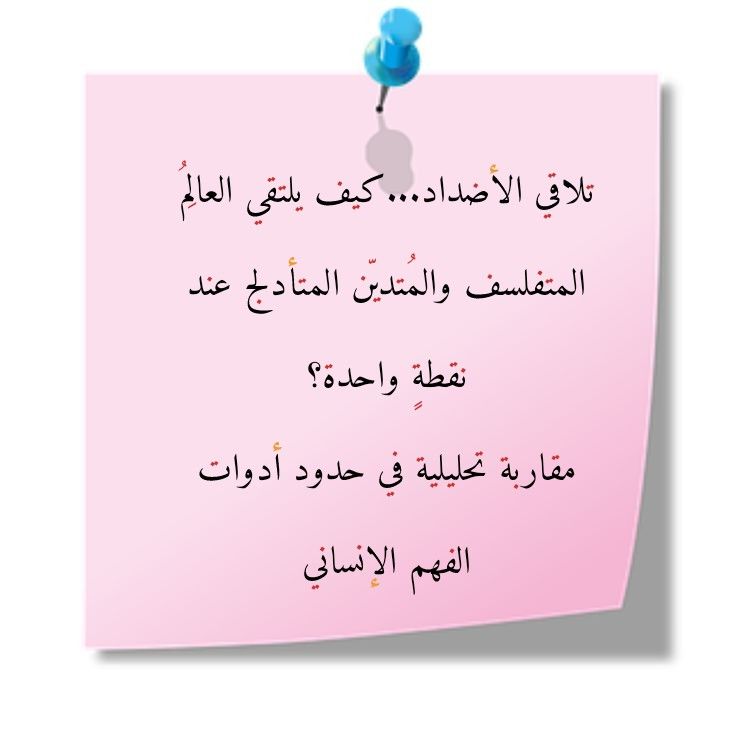
تُقدَّم العلاقة بين العلم والدين، في الوعي الثقافي العام، بوصفها علاقة تضادٍّ جذري؛ إذ يُنظر إلى العلم باعتباره منظومة تفسيرية تستند إلى التجربة والاستنباط والبرهان، بينما يُنظر إلى الدين باعتباره نسقًا إيمانيًا-قيميًا يستند إلى الوحي والتسليم. غير أنّ هذا التصوير الثنائي الصارم يُخفي خلفه مفارقة دقيقة، هي أنّ ممثلي هذين الحقلين، على تفاوتهم في المرجعيات والمنطلقات، يلتقي المتفلسف منهم والمتأدلج في كثير من الأحيان عند نقطة واحدة: الادّعاء الشمولي بالقدرة على تفسير العالَم بأسره.
فعالِمٌ يعتقد أن ما يملكه من أدوات التجريب والنمذجة والاستقراء كافٍ للإحاطة بظواهر الوجود جميعها، بما في ذلك تلك التي تتجاوز نطاق الملاحظة المباشرة أو تلامس أسئلة الغاية والمعنى. وفي المقابل، متديّنٌ مؤدلج يرى أن ما يملكه من تأويلاتٍ للنص القرآني يكفي لتقديم تفسير كامل للعالَم والعِلم معًا، وكأنّ العالم كلّه قائم داخل حدوده المفهومية الخاصة.
هذا التشابه لا ينبع من تقاطعات بين العلم والدين في بنيتهما الداخلية؛ بل من نزعة بشرية مشتركة تتجاوز المجالين معًا: نزعة البحث عن اليقين وإقصاء الاحتمال. فالإنسان، بوصفه كائنًا واعيًا هشًا في مواجهة اتساع الوجود، يميل إلى بناء صورة نهائية مطمئنة حول الكون ومكانه فيه، صورةٍ تمنحه شعورًا بالثبات في عالم لا ثبات فيه.
ومن هنا يمكن التفكير في أنّ “وهم الشمول” ليس انحرافًا منهجيًا بقدر ما هو استجابة نفسية-وجودية. فحين يواجه الإنسان أسئلة من قبيل: ما الغاية؟ ما أصل الأشياء؟ ما حدود معرفتنا؟ فإن الإجابة الناقصة تُربكه، أمّا الإجابة المكتملة، حتى وإن كانت متعسّفة، فإنها تمنحه طمأنينةً معرفية قد تغنيه عن مواجهة قلقه الوجودي.
إنّ العلم، حين يبقى ضمن حدوده المنهجية الصارمة، هو أداة تحليلية جزئية مهمّتها استخراج القوانين التي تنظّم الظواهر. لكنّه يفقد صرامته حين يتحوّل إلى مشروع لتفسير الغاية والوجود والمصير. والدين، حين يبقى ضمن مجاله القيمي والمعرفي، هو إطارٌ مانحٌ للمعنى ومحرّك للسلوك. ولكنه لن يعين المتدين المتأدلج في مسعاه لتفسير البُنى الفيزيائية والآليات السببية للكون.
إن كلاً من العالم المتفلسف والمتدين المتأدلج، حين يتجاوزان حدودهما، لن يتمكنا من الإحاطة بحقيقة الوجود، أما وأنهما قد تخليا عن المنهج المعرفي الصارم الذي جعلته الحقيقة مفتاح الوصول الى أسرارها. فحين يتجاوز العالِم المتفلسف والمتدين المتأدلج حدودهما الوجودية، عندها تصبح التجربة العلمية مشروعًا لاحتكار الحقيقة، كما تصبح العقيدة الدينية منظومة لتأميم المعنى. وهنا لا يعود التضاد بين العلم والدين قائمًا إلا على مستوى الخطاب، بينما يزول على مستوى البنية الذهنية التي تدير الفهم.
إنّ ما يدعو إليه هذا التحليل، إذاً، ليس إقامة جدار فاصل بين العلم والدين، ولا دمجهما تحت إطار واحد، بل إعادة الاعتبار إلى حدود كلّ منهما. فالعلم يجيب عن كيف تحدث الأشياء، والدين يجيب عن لماذا نُقيم قيمةً لحدوثها. وما بين هذين البُعدين تقوم المنطقة البشرية التي لا تُختزل في أيٍّ منهما: منطقة الوعي، القلق الوجودي، التساؤل، الحرية، والبحث الذي لا ينقطع.
وهنا، يصبح الاعتراف بالحدود شرطًا أساسيًا لسلامة المعرفة. فالمعرفة التي لا تعترف بحدودها لا تزداد إلا انغلاقًا، والمعرفة التي تقبل النقص تصبح أكثر قدرة على النمو. وليس المطلوب من الإنسان أن يملك جوابًا نهائيًا لكل شيء، بل أن يملك شجاعة البقاء داخل السؤال دون أن يستعجل الأمان.
فالغاية ليست يقينًا مُطلقًا، بل وعيٌ مفتوحٌ على اتساع العالم.
