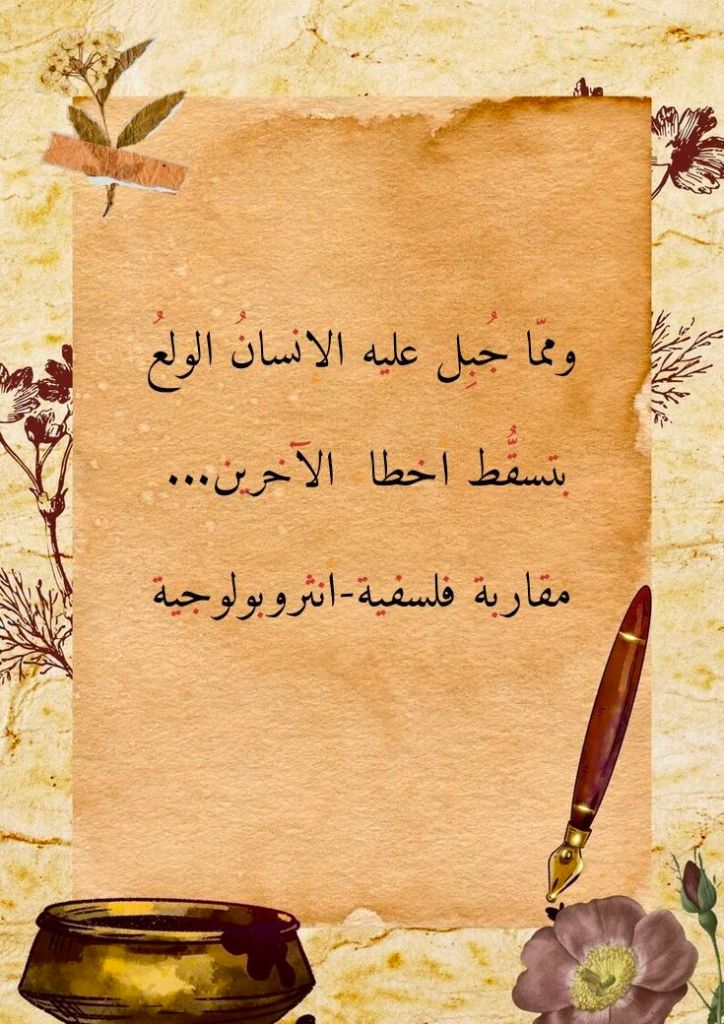
يتبدّى للناظر في السلوك الإنساني عبر امتداد الزمن وتشعّب البيئات الثقافية والحضارية أنّ ثمّة ظاهرة تكاد تكون قاسماً مشتركاً بين البشر جميعاً، مهما تباينت أديانهم وأجناسهم وانحداراتهم الطبقية ومستوياتهم المعرفية. وهذه الظاهرة هي الولع بتسقّط أخطاء الآخرين، والانشغال بعيوبهم، وتتبع زلّاتهم، وإبرازها ولو من غير مقتضٍ مباشر أو فائدة ظاهرة. وليس من العسير أن نلحظ هذه النزعة اليوم كما كانت تُلحظ في المجتمعات التقليدية القديمة، وكما تظهر في النصوص الدينية والآداب الأخلاقية، وفي المشاهد اليومية من حياتنا المعاصرة، بل وفي فضاءات التواصل الرقمي التي أضحت اليوم المسرح الأبرز لكشف هذه النزعة وتضخيمها.
إنّ حضور هذه الظاهرة حضورٌ عابر للزمان والمكان. فهي ليست مقصورة على طبقة اجتماعية بعينها، ولا على بيئة ثقافية محددة، ولا على جماعة دون أخرى. كما أنّها ليست ظاهرة يُمكن إرجاعها إلى خلل نفسي أو عقدة شخصية كما تفعل المقاربات السايكولوجية الاختزالية حين تحاول تفسير كل سلوك غير مبرر بدوافع مرضية أو باضطرابات في البنية العاطفية للشخص. بل إنّ الإنسان السويّ، والمهذّب، والمستقر نفسياً، يمارس هذه النزعة كما يمارسها ذلك الذي يُظن أنّه يعاني من ضعفٍ في التوازن السلوكي. فالاختلاف هنا لا يكمن في أصل النزعة، بل في حدّتها وتكرارها وطرائق تجلّيها.
هذا الاتساع الأفقي في حضور الظاهرة يوجّه ضربة نقدية مباشرة للمدارس التفسيرية التي تستند إلى البايولوجيا التطورية وعلم النفس التطوري والأنثروبولوجيا التطورية؛ إذ إنّ هذه المدارس تسعى في مجملها إلى تفسير السلوك الإنساني بوصفه نتاجاً لوظائف بقاءٍ نُحتت عبر ملايين السنين من الانتقاء الطبيعي. غير أنّ تسقّط أخطاء الآخرين ليس له ما يؤيده ضمن هذا الإطار بوصفه سلوكاً يُعزّز فرص البقاء أو يزيد من القوة التنافسية للفرد أو الجماعة. بل على العكس، كثيراً ما يؤدي هذا السلوك إلى تقويض العلاقات الإنسانية، وتوتير الروابط الاجتماعية، وإضعاف الثقة التي هي عماد أي بنية جماعية مستقرّة.
فالإنسان، وهو يترصّد هفوات غيره، لا يجني منفعة مادية، ولا يدفع تهديداً بيولوجياً، ولا يحقق تقدّماً تكيفياً يُحسّن من استدامة نوعه. صحيح أنّ الإنسان قد يبرّر هذا السلوك لنفسه بوصفه سعياً إلى حفظ المعايير الأخلاقية أو صون النظام الاجتماعي من الانحراف، إلا أنّ ذلك لا يُخفي الدافع العميق الكامن في النفس، وهو دافع لا يمكن تفسيره بتعليلات أخلاقية أو نفسانية جزئية. فهذا الولع أقرب ما يكون إلى حاجة شعورية للتمايز، وإلى رغبة دفينة في أن يشعر المرء أنّه، ولو بدرجةٍ ما، “أفضل” من غيره. أي أنّ هذه الظاهرة تسكن مقام الهوية لا مقام المصلحة، ومقام الاعتبار الذاتي لا مقام البقاء البيولوجي.
ومن هنا يمكن القول إنّ تسقّط أخطاء الآخرين يُعد نافذةً تكشف عن جانب جوهري في الطبيعة البشرية؛ جانب يتعلّق بكيفية إدراك الإنسان لذاته بين الآخرين، وتكوّنه في سياق المقارنة المستمرة. فالإنسان لا يعرف نفسه بذاته وحدها، بل يعرفها بما يقابلها ويشبهها ويخالفها. وهذه العملية التقييمية المتبادلة بين الذوات هي إحدى أعمق الحركات الخفية التي تصوغ الوعي الاجتماعي والسلوكي.
وقد يكون هذا ما يفسّر فشل العلوم التطورية في تقديم تفسيرٍ متماسك لهذه الظاهرة؛ فهي علوم تنطلق من “المنفعة” بوصفها الغاية القصوى، بينما تنطوي هذه الظاهرة على عناصر غير نفعية، بل وربما هدّامة أحياناً. فهي ظاهرة لا تقوم على الضرورة، بل على القابلية الإنسانية للتمايز، وهي قابلية تتجاوز حدود الجسد إلى حدود المعنى.
وبذلك يمكن القول إنّ الولع بتسقّط أخطاء الآخرين ليس سلوكاً عارضاً، ولا مرضاً نفسياً، ولا انحرافاً أخلاقياً فحسب، بل هو أحد أعراض “الوعي البشري ذاته” حين يتوجّه نحو الخارج بحثاً عن مرآة يرى فيها نفسه في مقام التفوّق أو الحضور أو التمايز. إنّها ظاهرة تكشف أنّ الإنسان لا يعيش فقط ليبقى، بل يعيش أيضاً ليُرى، ويُقاس، ويُقدَّر، ويُقارن.
وما لم ندرك أنّ هذه الحاجة إلى “الاعتبار بين الآخرين” هي حاجة تأسيسية في الوجود البشري، فإنّ كل تفسير سينتهي إلى اختزال لا يفي بحقيقة الإنسان حقّها.
