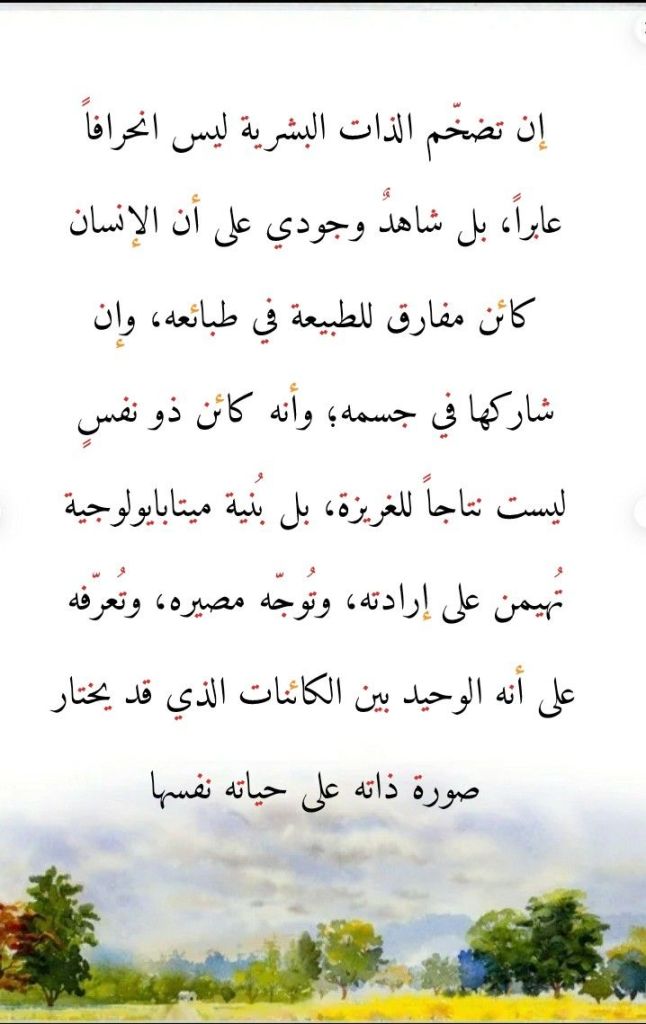
من بين جميع الظواهر التي تُبرز خروج الإنسان على الطبيعة، وتكشف انفصاله الجوهري عن النسق الحيواني، تبرز ظاهرة لا سبيل لردّها إلى التطوّر البيولوجي الخالص ألا وهي تضخّم الذات البشرية. وهذه الظاهرة ليست عَرَضاً جانبياً، ولا انحرافاً نفسياً عابراً، بل هي أحد أهم الأدلّة الوجودية على أنّ الإنسان ليس “امتداداً طبيعياً” للحيوان، بل كائناً نشأ عن حدث ميتابايولوجي خلّف في داخله طبقة نفسية متجاوزة للطبيعة نفسها. فالبيولوجيا تخبرنا أنّ الحيوان تحرّكه معادلة بسيطة وواضحة: البقاء الشخصي وخدمة النوع والانضباط بالغريزة. ومن هنا لا يمتلك الحيوان ذاتاً متضخّمة ولا صورة متخيّلة عن نفسه؛ لا يغضب إن مُنع، ولا يتذمّر إن خضع، ولا يتفاخر إن نجح؛ فهو يتحرك داخل منظومة طبيعية متكاملة، لا تنفصل فيها مصلحة الفرد عن مصلحة النوع، ولا تنفصل فيها الغريزة عن السلوك.
لكن الإنسان، بخلاف ذلك، خرج من هذه البنية خروجاً حادّاً، ليظهر فيه لأول مرة كائنٌ ممتلئٌ بذاته، متضخّمها، مهووس بصورتها، متعطّش لأن تكون له السيادة على كل شيء: على الآخرين، وعلى الأخلاق، وعلى الحقيقة نفسها. وهذا التضخّم لا يمكن تفسيره بآليات الانتخاب الطبيعي، لأنه لا يخدم البقاء ولا يُحسّن فرص النجاة؛ بل يفعل العكس تماماً: يعرّض الإنسان للهلاك، ويحرمه من النصح، ويدفعه إلى القرارات الأكثر إيذاءً لنفسه. وهنا تتجلّى بوضوح الخلفية التي بدأتُ أُسّس لها في مقالاتي السابقة. ففي مقالتي المعنونة “الإنسان ليس كائناً بيولوجياً فحسب”، مهدتُ للحقيقة التي مفادها أن الإنسان نفسٌ ميتابايولوجية ذات إرادتين وصوتَين؛ إرادة تقوده نحو الخير، وصوت “الأنا المعارضة” الذي يقوده نحو العصيان، وطبقة ثالثة أكثر تعقيداً هي الذات المتضخّمة التي ترفض النقد، وتُسقِط كل محاولة لتصحيح السلوك.
كما وأوضحتُ، في مقالتي حول الأصل الميتابايولوجي للنفس، أن ما نشأ في الإنسان ليس “وعياً أعلى” فحسب، بل انقساماً داخلياً جوهرياً لم يُعرف لدى الحيوان: صوتان يتنازعان القيادة، إرادتان متخاصمتان، وصراع داخلي مستمر بين ما يجب فعله وما تدعو إليه النفس.
كما وأن مقالة “تضخّم الذات” ليست إلا امتداداً لهذا النسق، لأنها تكشف الوجه الأكثر ظهوراً لهذا الانقسام: تضخّم الأنا الذي يعطّل الإرادة الأولى ويمكّن الإرادة المعارضة.
فالإنسان يريد النجاة، لكنه يرفض النصيحة التي تكفل له نجاته. ويريد الأمن، لكنه يعصي صوت الحكمة والخبرة. ويبحث عن البقاء، لكنه يتخذ قرارات تهدد بقاءه وبقاء نوعه.
وهذا كله ينسجم مع ما أثبته مشروعي الفكري من أن الإنسان يسكنه “صوت” لا تفسير بيولوجياً له: صوت يعارض مصلحته، ويغلق أذنيه عن التحذير، ويختار الضرر على السلامة حين يقتضي ذلك الحفاظ على صورة الذات.
وهكذا تبلغ ظاهرة تضخّم الذات ذروتها حين تتعامل النفس مع النقد وكأنه تهديد وجودي، لا فرصة للنجاة؛ وحين تنظر إلى الاعتراف بالخطأ وكأنه انكسار، وليس تصحيحاً؛ وحين يظهر الإنسان، أمام النصيحة، بوصفه كائناً ذاتياً فوق-بيولوجي، لا مجرد جهاز بيولوجي غايته البقاء. وهنا يأتي القرآن ليقدّم الشاهد الأكبر على هذه المفارقة: فالإنسان، في مواجهة أنبيائه، لم تكن مشكلته مع الحُجّة، بل مع الذات؛ لم يرفض الرسالة لأنها غير منطقية، بل لأن نفسه المتضخمة لا تحتمل أن تُقاد إلا بنفسها. ولهذا اتّهم الأنبياء بكل ما يحطّ من شأنهم: شاعر، كاذب، مجنون، كاهن، ساحر… لا لشيء إلا لأن الذات لا تتحمّل أن يُقال لها: “أنت على خطأ”.
وهذا السلوك، وكما أوضحت في كثير من مقالاتي حول “الأنا المعارضة”، يكشف أن الإنسان لا يعصي الأنبياء لأن اعتراضه عقلاني، بل لأن الطبقة الميتابايولوجية في النفس تهيمن على قراره، وتُصمت صوت العقل، وتُعطي الأولوية لصورة الذات، لا لسلامتها. ولو كان الإنسان امتداداً بيولوجياً للحيوان، لكان يفعل مثل الحيوان: يستمع للنصح، ويذعن للخبرة، ويحتمي بصوت القائد، ويجعل بقاءه هدفاً أعلى من صورته عن نفسه. لكن الإنسان يفعل النقيض: يقدّم “الذات” على “الحياة”، و”الصورة” على “النجاة”. وهنا ينهار التفسير التطوري؛ لأن ما يفعله الإنسان لا يخدم المنفعة التطورية، ولا يدخل في أي إطار انتخاب طبيعي. فالبيولوجيا والفسيولوجيا تشهدان بتشابه الإنسان مع الحيوان في الجسم، والجهاز العصبي، والهرمونات، وآليات الشعور الأساسية. لكن النفس تشهد بانفصال هائل: في الوعي الأخلاقي، والأنا المتضخمة، والقدرة على تدمير الذات والنوع، والعصيان المتأصّل، ومقاومة النصيحة، والتمرّد على الهداية.
وهذا كله يثبت ما كشفته الميتابايولوجي:
أن الإنسان ليس استمراراً للطبيعة، بل خروجاً عليها؛ ليس مجرد جسم تطوّر، بل نفسٌ ظهرتْ بحدثٍ مفارق للطبيعة؛ ليس حيواناً راقياً، بل كائناً مزدوج الطبقات: بيولوجي في جسمه، ميتابايولوجي في نفسه.
إن تضخّم الذات البشرية، إذاً، ليس انحرافاً عابراً، بل شاهدٌ وجودي على أن الإنسان كائن مفارق للطبيعة في طبائعه، وإن شاركها في جسمه؛ وأنه كائن ذو نفسٍ ليست نتاجاً للغريزة، بل بُنية ميتابايولوجية تُهيمن على إرادته، وتُوجّه مصيره، وتُعرّفه على أنه الوحيد بين الكائنات الذي قد يختار صورة ذاته على حياته نفسها.
