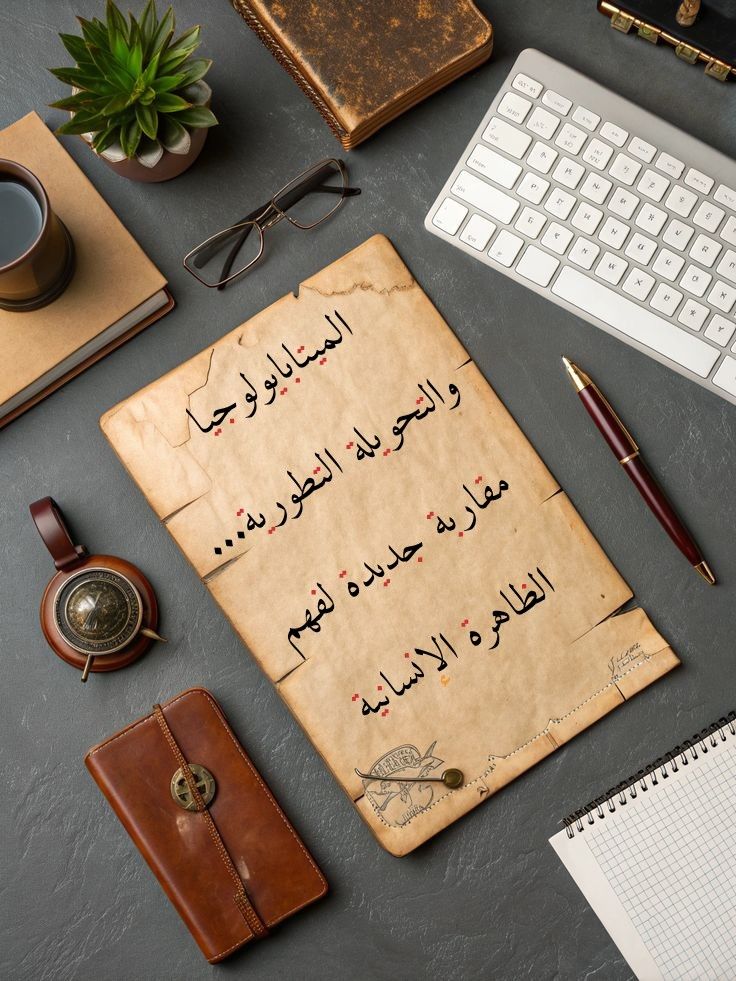
تنطلق المقاربة الميتابايولوجية للظاهرة الإنسانية من فرضية مؤداها أن الإنسان لم يَسِر في تطوره سيراً خطياً خاضعاً بالكامل لقوانين الانتقاء الطبيعي، بل شهد انقطاعاً مفصلياً، تحويلة تطورية، أفضت إلى نشوء كيان نفسي جديد لا يمكن تفسيره بالبيولوجيا وحدها ولا اختزاله إلى نفس مفارقة للمادة. هذا الحدث الميتابايولوجي مثَّل نقطة الانعطاف التي انفصل فيها الإنسان عن النسق الحيواني، وظهر عندها ما نسمّيه اليوم: النفس البشرية، الإرادتان، وتضخم الأنا والآخر.
تهدف هذه الفرضية إلى تقديم نموذج تفسيري جديد للظاهرة الإنسانية، يتجاوز ثنائية “المادي/الميتافيزيقي”، وينطلق من إعادة كتابة الماضي التطوري للإنسان بصورة تسمح بفهم النفس والوعي والصراع الداخلي فهماً متسقاً مع المعطيات القرآنية والبايولوجية والفلسفية.
شهد الماضي التطوري للإنسان لحظة غير قابلة للاختزال إلى قوانين البقاء، لحظة لم تعد فيها الغريزة الحيوانية كافية لتفسير الفعل الإنساني. فالإنسان يظهر في التاريخ بوصفه كائناً ينقلب على طبيعته من الداخل: يمارس الإيثار غير النافع، يعارض دوافعه، يضحّي دون مقابل، ويقترف الشر رغم ضرره. هذه الظواهر لا يمكن تفسيرها بالمنفعة التطورية ولا بالتطور الدارويني الخالص، مما يشير إلى أن الإنسان مرّ بمرحلة تطورية جديدة، ليست بيولوجية في جوهرها بل ميتابايولوجية. عند هذه النقطة انبثقت البذور الأولى للنفس الإنسانية.
يمثل الحدث الميتابايولوجي اللحظة التي ظهر فيها في الكائن البشري عنصر جديد غير موجود عند الحيوان: القدرة على معارضة الذات. فالحيوان يعمل داخل منظومة غريزية لا تنفصل فيها الدوافع عن الفعل. أما الإنسان فقد برزت داخله فجوة بين الرغبة والتنفيذ، فجوة تتسع كلما ازداد وعيه. هذه الفجوة لا يمكن تفسيرها بالغريزة، لأنها تمثل انقطاعاً عن المنطق التطوري. فظهور كوابح سلوكية داخلية، مثل الضمير، الشعور بالذنب، القيم الأخلاقية، ليس مجرد امتداد للغريزة بل تجاوز لها. وهو ما يجعل الحدث الميتابايولوجي أساساً لكل ما يميز الإنسان عن الحيوان.
تُظهر التجربة الإنسانية أن في داخل كل إنسان صوتين: صوت يدعو إلى الفعل (نزوع طبيعي/غريزي/نفعي)، وصوت آخر يعارضه (نزوع قيمي/ضميري/كابح). هذا التمزق الداخلي ليس انحرافاً عرضياً، بل هو جوهر بنية النفس. فوجود إرادتين متعارضتين داخل الإنسان يبرهن على أنه ليس امتداداً بسيطاً للكائن الحيواني، بل كائناً مركباً يحتوي على بنية مزدوجة لا وجود لها في الطبيعة الحيوانية. هذه الازدواجية هي أول دليل على أن النفس ليست بيولوجية خالصة، لأنها لا تخدم مبدأ البقاء. الأنظمة البيولوجية تعمل على تقليل التناقض الداخلي، بينما الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يعيش تضخماً في التناقض.
يمثل “تضخم الأنا الآخر” الامتداد التطوري للحدث الميتابايولوجي. فهو صوت داخلي يتحرك داخل النفس عبر آليات كابحة، لكنه بمرور الزمن يكتسب قوة خاصة ويتحول إلى سلطة داخلية تتحدى الأنا المباشرة.
وهذا الصوت، الذي يظهر كضمير أو تعنيف ذاتي أو نقد داخلي، لا يمكن تفسيره كوظيفة غريزية، لأن الحيوان لا يمتلك أي بنية نقد ذاتي أو تأنيب أو مراجعة. كما لا يمكن اعتباره نفساً مفارقة، لأنه يرتبط بالخبرات والتاريخ والتنشئة، بل هو بقايا “الطبقة الميتابايولوجية” الأولى التي نشأت في الإنسان، الطبقة التي جعلته الكائن الوحيد الذي يقف ضد نفسه.
ولكن هل بإمكاننا ان نعرف النفس بدلالة من هذه الميتابايولوجيا؟ تكمن الإجابة بتذكر الحقيقة التي مفادها أن تاريخ الفكر عرض النفس باعتبارها إما: وظيفة بيولوجية قابلة للاختزال إلى فعالية دماغية، أو جوهراً ميتافيزيقياً مفارقاً للمادة.
إلا أن كلا النموذجين يعجز عن تفسير خصائص النفس: قدرتها على معارضة الغريزة، ميلها إلى التعقيد لا التبسيط، قدرتها على الشعور الأخلاقي، تواجد إرادتين متعارضتين، ظهور الأنا المعارض، الانفعالات التي لا تخدم البقاء.
من هنا يبرز دور الفرضية الجديدة (الميتابايولوجيا): النفس ليست نتاجاً بيولوجياً خالصاً ولا جوهراً مفارقاً، بل نتيجة تحويلة تطورية ذات طابع ميتابايولوجي. إنها طبقة نفسية جديدة نشأت من حدث تطوري غير خاضع لقوانين الطبيعة البيولوجية، لكنها في الوقت ذاته ليست منفصلة عن الجسم.
النفس إذاً بُنية ميتابايولوجية نشأت عند نقطة انفصال الإنسان عن النسق الحيواني، وهي التي أنتجت الإرادتين وتضخم الأنا والأنا الآخر، وجعلت الإنسان كائناً خارج الطبيعة الحيوانية من الداخل.
تقدم هذه الفرضية الجديدة الإطار الفلسفي الكامل لمقاربة الظاهرة الإنسانية من منظور ميتابايولوجي يتجاوز الثنائيات التقليدية. ويمثل هذا الاندماج حجر الأساس لبناء نظرية معرفية جديدة حول: ما الإنسان؟ وكيف ظهر؟ ولماذا يحمل داخله هذا القدر من الصراع والتعقيد؟.
ففي ضوء هذه الفرضية الجديدة، تغدو النفس والإرادة والأنا والصراع الداخلي أدلة على أن الإنسان ليس امتداداً طبيعياً للحيوان، بل كائناً نشأ عن حدث فريد لا يخضع للمنفعة التطورية. وهذا هو الحدث الميتابايولوجي الذي لولاه ما كانت هناك نفسٌ ولا كان هناك إنسان.
والآن، لنتدبر المجالات المعرفية التي ينطوي عليها كلٌ من الأخلاق والوعي الديني والحرية والشرّ البشري، والتي تمتد جذورُها داخل التحويلة التطورية والحدث الميتابايولوجي. فهذه الظواهر الأربع، على اختلافها، تشترك في كونها لا تخضع للتفسير البيولوجي ولا يمكن ردّها إلى الغريزة، مما يجعل فهمها متعذراً دون الإقرار بأن الإنسان نشأ عن بنية ميتابايولوجية تتجاوز الوظيفة الحيوانية.
ولنناقش كلاً على حدة:
1. فالأخلاق لا يمكن تفسيرها ضمن النسق الحيواني؛ فالحيوان لا يعرف معنى الواجب الطوعي (التلقائي)، أو التضحية الإرادية، أو الذات التي تراجع ذاتها. إن ظهور الأخلاق في الإنسان ليس نتيجة تراكمات اجتماعية فقط، بل نتيجة انبثاق طبقة نفسية فوق-طبيعية داخل الكائن البشري. هذه الطبقة هي التي أسست لظهور: قيمة تتفوق على المصلحة، وواجب يتفوق على الدافع، وكبح يتفوق على المنفعة التطورية. فالأخلاق، في جوهرها، ليست استراتيجية للبقاء بل تمرد على استراتيجية البقاء، ومن ثم فهي أثر مباشر للتحويلة الميتابايولوجية وليس للانتقاء الطبيعي.
2. الوعي الديني كخاصية ميتابايولوجية لا وجود لها عند الحيوان. فالدين، في جذره التديني، ليس محاولة لشرح الكون فقط، بل هو استجابة لبُنية داخلية لا يعرفها الحيوان على الإطلاق: بُنية الشعور بالافتقار، وبطلب المعنى، وبالسعي لغاية تتجاوز الوجود البيولوجي.
هذا الوعي الديني ظهر في الإنسان لأنه وحده يمتلك: ذاتاً قادرة على طرح الأسئلة الوجودية، ووعياً يتجاوز الحاضر، وشعوراً بالواجب الأخلاقي والذنب، وحاجة متأصلة إلى العلوّ والارتباط بما يتجاوز المادة. هذه الخصائص ليست نتاج الدماغ وحده بل نتاج الطبقة الميتابايولوجية للنفس.
3. الحرية الإنسانية كأثر للانفصال عن الحتمية الحيوانية. في عالم الحيوان، الحتمية هي القانون الأعلى؛ الغريزة تحدد الفعل، ولا توجد فجوة بين الإرادة والتنفيذ.
أما الإنسان فقد ظهر فيه شيء لم يُعرف في الطبيعة قبله: حرية الفعل. هذه الحرية ليست وهماً اجتماعياً، بل هي نتيجة مباشرة لبروز: الإرادتين، الوعي، المقدرة على مخالفة الدافع.
الحرية إذن هي الدليل الأقوى على أن الإنسان خرج من النسق الحيواني، لأنها لا تخدم البقاء، بل تمنح القدرة على مخالفة ما يخدم البقاء.
4. الشرّ الإنساني: بصفته الوجه المظلم للحدث الميتابايولوجي. الحيوان لا يعرف الشرّ بمعناه القيمي؛ إذ لا يقتل بدافع الكراهية، ولا يؤذي بدافع التلذذ، ولا ينتقم انتصاراً لعقيدة زائفة. لكن الإنسان يفعل كل ذلك. فكيف ظهر الشر البشري بوصفه فعلاً واعياً؟.
الشرّ ليس ظاهرة بيولوجية وذلك لأنه يتعارض مع مبدأ البقاء، وليس هو ظاهرة روحية مجردة وذلك لأنه يرتبط بالبنية النفسية المتناقضة، ولكنه نتيجة مباشرة لظهور الحرية والأنا المتضخمة، وازدواج النفس بعد التحويلة الميتابايولوجية.
فالشرّ الإنساني هو: استخدام الإرادة الحرة بطريقة تتحدى النظام الأخلاقي الذي يتفق مع الطبقة الميتابايولوجية عند تمام امتثالها لكامل ما يُمليه الخير الأعظم.
وبذلك يصبح الشرّ دليلاً على تطور غير بيولوجي، لأنه لا يظهر إلا عند كائن خرج على الحتمية الحيوانية.
إن الأخلاق والوعي الديني والحرية والشرّ البشري ليست ظواهر متفرقة، بل فصول مختلفة لسردية واحد: سردية التحويلة الميتابايولوجية التي أدت إلى ظهور الإنسان ككائن قادر على: رؤية ذاته، ومراجعة دوافعه، وتجاوز طبيعته، والانفصال عن الحتمية. هذه الظواهر الأربع ليست آثاراً جانبية للذكاء، بل شواهد على أن الإنسان لم يُبنَ تطوره على الانتقاء الطبيعي وحده، بل على حدث انفصل فيه عن الحيوان وبدأ فيه تاريخ النفس البشرية.
