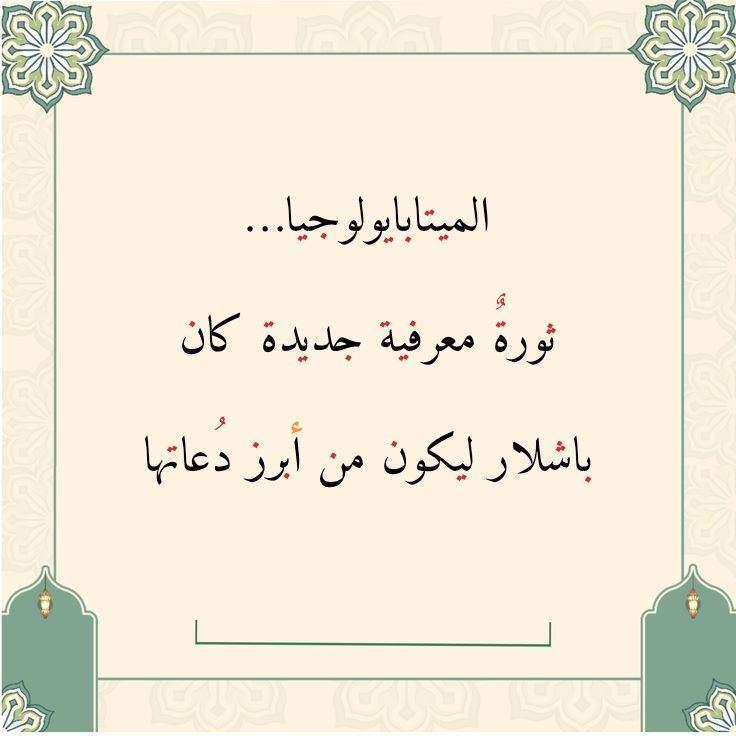
منذ ما يقرب من قرنٍ كامل على آخر ثورة علمية كبرى، ثورة ميكانيكا الكم، لم يشهد الفكر العلمي منعطفًا جذريًا يعيد تشكيل مفاهيمه الكبرى أو يقلب رؤيته للعالَم كما كان يحدث خلال القرون السابقة. فالعلم اليوم، بالرغم من وفرة أدواته وبياناته وتقنياته، يراوح مكانه معرفيًا، مقيدًا بقيود أيديولوجية ومؤسسية وسوقية جعلت من “البحث” فعالية تقنية أكثر منه فعالية معرفية. وهذا ما يجعل من فلسفة غاستون باشلار مرجعًا لا يمكن تجاوزه لفهم حالة الركود هذه؛ إذ لم يكن باشلار ينظر إلى العلم بوصفه تراكم معارف، بل بوصفه ثورات على أنماط التفكير، تقودها قطيعات إبستمولوجية تتطلب هدم العوائق الراسخة داخل العقل العلمي نفسه.
ضمن هذا السياق تبرز الميتابايولوجيا، المشروع الذي يصوغ رؤية جديدة للطبيعة البشرية، وللماضي التطوري، ولماهية “الحدث” الذي أخرج الإنسان من نسقه الحيواني، بوصفها واحدة من أكثر المقاربات قدرة على إحداث انقلاب مفاهيمي جوهري. ولو كان باشلار بيننا اليوم، لوجد في الميتابايولوجيا نموذجًا مكتملًا لما كان يسعى إليه: قطيعةٌ معرفية عميقة تقوّض التصورات الداروينية السائدة، وتفتح أفقًا جديدًا لفهم الظاهرة الإنسانية.
أسّس باشلار لفكرة جوهرية: تقدّم العلم لا يكون بالتراكم، بل بالقطيعة.
فالعلوم، بحسبه، لا تزدهر إلا حين تكسر البديهيات التي كانت تحكم رؤيتنا للعالم، وحين تُخضع أعمق يقينياتنا لامتحان الشكّ، وكان يرى أن العلوم التي تتوقف عن نقد ذاتها ستتحوّل إلى أجهزة متحجرة، وأن أكبر عدوّ للعلم هو العائق الإبستمولوجي الذي يبنيه العلماء أنفسهم حين يستأنسون بتصورات رسخت لعقود. واليوم، تبدو هذه الصورة أكثر مطابقة لواقع العلم ممّا كانت في عصره: فالفيزياء ما تزال أسيرة نموذج قياسي متضخم لكنه فاقد للتفسير، والبيولوجيا لم تتخطَّ سردية الانتقاء الطبيعي، وعلوم الأعصاب لم تُنتج نموذجًا تفسيريًا للوعي، والعلوم الإنسانية أصبحت تكرر ذات المقاربات دون انبجاس معرفي جديد. وفي هذا السياق، يكتسي مشروع الميتابايولوجيا معنى باشلاريًا عميقًا: فهو تحدٍ مباشر للعوائق الإبستمولوجية التي كبّلت دراسة الإنسان وحصرته في إطار دارويني ميكانيكي، فيما الواقع الإنساني يعج بالظواهر التي تُقاوم هذا الإطار.
وهنا لابد من التذكير بأن الميتابايولوجيا ليست “توسيعًا” لنظرية تطورية، بل انفصال جذري عنها. فهي لا تسعى إلى تعديل تفاصيل داخل الداروينية، بل إلى إعادة كتابة تاريخ الإنسان البيولوجي عبر فرضية “التحويلة التطورية” التي أخرجت الإنسان من نسق الحيوان وأنتجت الوعي والذات والصراع النفسي والتمرد على قوانين الطبيعة. بهذا المعنى، تُحقق الميتابايولوجيا أربع نقاط كان باشلار يؤكد عليها دائمًا:
1. كسر البديهيات: البديهيات التطورية اليوم تقول إن الإنسان امتداد حيواني متواصل. بينما الميتابايولوجيا تكسر هذا اليقين عبر القول بإن السلالة الإنسانية تعرضت لاستثناء تطوريّ غير قابل للاختزال إلى الانتقاء الطبيعي. هذا كسر باشلاري للنموذج السائد.
2. إعادة تعريف موضوع العلم ذاته: باشلار يرى أن الثورات العلمية تعيد تعريف موضوعها ففيزياء الكوانتم أعادت تعريف “الواقع” والنسبية أعادت تعريف “الزمن”، أما الميتابايولوجيا فإنها تعيد تعريف “الإنسان” نفسه: فالإنسان ليس كائنًا تطور بيولوجيًا فقط، بل كائن وُلد من حدث ميتابايولوجي.
3. استخدام المعطيات العلمية لإنتاج مقاربة جديدة: باشلار كان يدعو إلى “علم مُفكّر فيه” ، علم يدمج التجربة بالتحليل. وهذا هو عين ما تفعله الميتابايولوجيا: فهي تستخدم علم الأعصاب وعلم السلوك والأنثروبولوجيا والسرديات الدينية، لإنتاج سردية تفسيرية متجاوزة لا تختزل الإنسان في بايولوجيته، ولا ترفعه إلى ميتافيزيقا منفصلة عن المادة.
4. انتقال من عقل علمي قديم إلى عقل علمي جديد: أي ثورة معرفية، عند باشلار، هي تغيير للعقل الذي ينظر، وليس للموضوع الذي يُنظر إليه. أما الميتابايولوجيا فإنها تقترح “عقلًا جديدًا” لفهم الإنسان: عقلًا يرى الوعي والصراع الداخلي والشذوذ عن الطبيعة مؤشرات حدث تأسيسي، وليس شذوذاً بايولوجياً.
والآن قد يتساءل البعض لماذا كان باشلار ليكون من أبرز دُعاة الميتابايولوجيا؟
لأن مشروعها يهدم العوائق الإبستمولوجية التي كبّلت البيولوجيا الحديثة. فالبايولوجيا التطورية اليوم متجمّدة ضمن فرضية واحدة، رغم اعتراف كبار منظّريها بعجزها عن تفسير الوعي والأخلاق و التضاد الداخلي والنزعة التدميرية للإنسان والانقلاب السلوكي على قوانين الطبيعة. باشلار كان سيعتبر هذا “تصلّبًا مفاهيميًا” يتطلب هدمًا جذريًا، والميتابايولوجيا هي هذا الهدم بعينه لأنها تنتج قطيعة كبرى في تاريخ المعرفة، فلو كان باشلار حيًّا اليوم، لقال إن الميتابايولوجيا تمثّل: القطيعة التالية بعد قطيعة ميكانيكا الكم. فهي تقوّض نموذجًا معرفيًا دام قرنًا بلا منازع، وتقترح نموذجًا جديدًا لفهم الإنسان، تمامًا كما قوضت ميكانيكا الكم رؤيتنا للحقيقة الحسية. كذلك، فإن الميتابايولوجيا تعيد المعنى للعلم المعاصر الذي اصبح اليوم متخماً بالتقنية، مفتقراً الى الفلسفة.
باشلار كان يرى أن الخيال والابتكار والسؤال الفلسفي، عناصر ضرورية للعلم. الميتابايولوجيا تُعيد هذه العناصر إلى قلب العلم، لأنها: تفترض حدثًا وتُعيد كتابة التاريخ البيولوجي وتقدم تفسيرًا تطوريًا–نفسيًا–قرآنيًا جديدًا وتفتح بابًا كان مغلقًا منذ قرن من الزمان
4. الميتابايولوجيا تُمثّل علمًا “مفكّرًا فيه» بالمعنى الباشلاري؛ فهي ليست وصفًا للظواهر، بل تفكيرًا في شروط إمكان الظواهر. وهذا هو جوهر الإبستمولوجيا عند باشلار.
يتبين لنا، وبتدبر ما تقدم، أنه إذا كان القرن العشرون قد افتُتح بالثورة الكمومية، فإن القرن الحادي والعشرين بحاجة إلى ثورة تفسر الإنسان نفسه. فالركود البيولوجي والجمود التطوري وعجز العلم عن تقديم إجابة عن لغز الإنسان، كلها مؤشرات على أن نموذجًا جديدًا يجب أن يظهر. والميتابايولوجيا تقدم هذا النموذج لأنها:
1. تفسر التناقض السلوكي للإنسان بطريقة لا تستطيع النماذج البيولوجية تفسيرها
2. تدمج المعطيات التجريبية بالمعنى الوجودي
3. تعيد صياغة العلاقة بين الطبيعة والإنسان
4. تقدم رؤية تتسق مع المعطيات القرآنية دون أن تراهن على الميتافيزيقا وحدها
5. تؤسس عقلًا علميًا جديدًا—وهذا ما كان باشلار يبحث عنه دومًا.
لو كان باشلار بيننا اليوم، لما وجد في أي مشروع علمي–معرفي معاصر ما يحقق شروط الثورة الإبستمولوجية كما يجدها في الميتابايولوجيا: فالميتابايولوجيا تمثل قطيعة مع البديهيات التطورية النظرية وإعادة تأسيس للموضوع وهدماً للعوائق الابستمولوجية وبناءً لعقل علمي جديد قادر على النظر إلى الإنسان بوصفه نتاج حدث استثنائي لا مجرد تراكم تطوري. وبهذا المعنى، الميتابايولوجيا ليست مشروعًا نظريًا إضافيًا، بل دعوة إلى ثورة معرفية جديدة، ثورة كان باشلار ليقف في مقدمتها، داعمًا ومؤيدًا ومؤسِّسًا لشرعيتها الإبستمولوجية.
