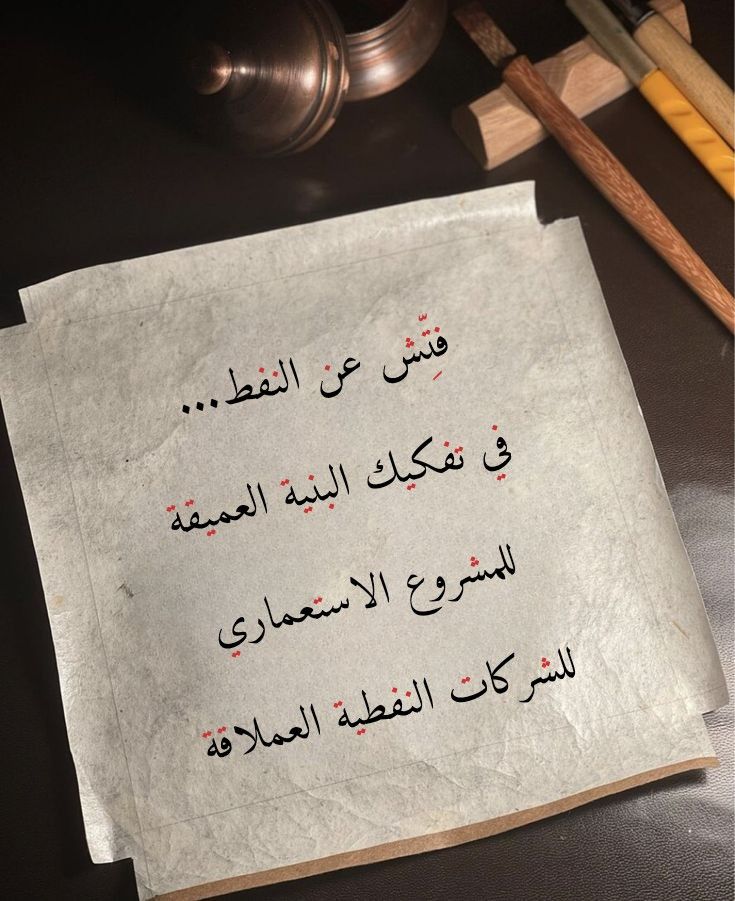
لا تُعدّ مقولة “فتِّش عن المرأة” في الثقافة الفرنسية إلا دعوةً للبحث عن السبب الحقيقي المختبئ وراء الظواهر. وعلى المنوال ذاته، يبدو أن العقود الأخيرة تستدعي مقولةً جديدة أكثر مطابقةً لمنطق العصر: “فتِّش عن النفط”. فما من نزاعٍ جيوسياسي ولا انقلابٍ ولا حصارٍ اقتصادي ولا «حملة ديموقراطية» تشنها قوة كبرى، إلا وتلوح في خلفيته البصمة الثقيلة للذهب الأسود، وللشركات التي جعلت منه محورًا لإمبراطوريات اقتصادية، وسياسات انحرفت عن كل معيار أخلاقي.
وتأتي هذه المقالة لتفكيك الدور المحوري الذي أدّته شركات النفط العملاقة، خاصة الأميركية منها، في صياغة ملامح المشروع الاستعماري الحديث، وكيف أعاد النفط رسم خريطة النفوذ العالمي وكرّس بنيةً استعمارية لا تزال فاعلة حتى اليوم، وإن تغيّر خطابها وواجهتها.
لم يكن النفط مجرد مادة خام، بل تحوّل منذ منتصف القرن العشرين إلى منظومة قوة تمتلك القدرة على:
1. تشكيل التحالفات الدولية: فالدول تُستمال أو تُحاصر تبعًا لموقعها ضمن خريطة إنتاج النفط أو مرور خطوطه.
2. إنتاج اقتصاد عالمي هرمي: الشركات الغربية الكبرى، مثل ستاندرد أويل وشيفرون وإكسون وموبيل، لم تكن مؤسسات اقتصادية وحسب، بل أذرعًا إمبراطورية تحدد لمن يُسمح بالتنمية ولمن يُفرض الفقر.
3. توجيه القرار السياسي في الدول المنتجة: من الانقلابات المدعومة أميركيًا في إيران عام 1953، إلى الضغوط المتواصلة على العراق وفنزويلا ونيجيريا، يتضح أن النفط هو «البنية التحتية» التي تتحرك فوقها السيادة والشرعية والقانون الدولي.
لم تكن الأزمة الفنزويلية، قديمة كانت أم حديثة، سوء إدارة محلية فحسب، بل نتاجًا لتوترٍ تاريخي بين الشعب الفنزويلي وبين شركات النفط الأميركية العملاقة التي رأت في حقول فنزويلا أحد أهم مصادر أرباحها. فمنذ بداية القرن العشرين، سعت الشركات الأميركية إلى: إبقاء الأسعار منخفضة والتحكم بمعدلات الإنتاج وإضعاف قدرة الدولة الفنزويلية على فرض سيادتها على مواردها. ولم تُخفِ هذه الشركات نيتها: “فالنفط الفنزويلي يجب أن يظل تحت السيطرة الأميركية بأي ثمن”. ففي عام 1951 شهدت فنزويلا لحظة تاريخية فاصلة، حين أجبر وزير النفط الفنزويلي آنذاك تلك الشركات على إعادة صياغة الاتفاقيات بما يضمن: زيادة حصة الدولة الفنزويلية من العوائد وتقويض قدرة الشركات على احتكار الأرباح وفتح المجال أمام الدولة لتأدية دور سيادي أكثر حضورًا. كانت هذه الخطوة بمثابة إعلان استقلال اقتصادي، فاعتبرته الشركات الأميركية «تهديدًا إستراتيجيًا» يستوجب الردّ بوسائل مباشرة وغير مباشرة. وحين أمّم محمد مصدّق النفط الإيراني عام 1951، لم يمضِ عامان حتى دُبّر له انقلاب أطاح به، بإدارة مشتركة بين وكالة الاستخبارات الأميركية والبريطانية. لماذا؟ لأنّه أمسك بصمام حياة الإمبراطورية النفطية. واليوم، حين يشنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملته الهوجاء على فنزويلا، لا يحتاج الباحث الموضوعي إلى كثير ذكاء لاستنتاج السبب: فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، وشركات النفط العالمية، خصوصًا الأميركية، ترى في أي محاولة لتعزيز السيادة الوطنية تهديدًا مباشِرًا لمصالحها. إنه النمط ذاته حين حاولت إيران التحكم بنفطها فكانت لها هذه الشركات بالمرصاد؛ حيث دُبر انقلابٌ أطاح بالحكومة الوطنية التي كان يرأسها الدكتور محمد مصدق. وحين حاول العراق إعادة توزيع الثروة وصوغ سياسة نفطية مستقلة دُبر له غزواً سبقه حصار لا يزال شعبه يعاني الأمرين جراءه. وحين حاولت فنزويلا تعزيز سيادتها فُرض عليها حصار اقتصادي وهُددت بالغزو. لا يُفرض الاستعمار اليوم بالوسائل العسكرية فحسب، بل عبر آليات مالية وتقنية وقانونية:
1. العقوبات الاقتصادية؛ حيث هي شكل عصري من أشكال الحصار البحري القديم، يهدف إلى خنق الدولة المنتجة للضغط عليها سياسيًا.
2. الديون الدولية وبرامج صندوق النقد؛ حيث انها تجعل الدولة رهينة خيارات اقتصادية تعطل إرادتها السيادية.
3. الهندسة الإعلامية؛ حيث يُصوَّر أي زعيم يحاول حماية ثروات بلاده بأنه «ديكتاتور» أو «خطر على الديمقراطية»، بينما يُغفل دور الشركات في تأجيج الفوضى.
4. التدخل السياسي المباشر؛ وذلك عبر دعم جماعات داخلية أو تمويل معارضة مسلحة أو شرعنة انقلابات بحجة “استعادة الاستقرار”.
لم يكن ذنب فنزويلا ولا العراق ولا إيران الدكتور مصدق أنها تقع فوق بحيرات هائلة من النفط، لكن العالم الحديث، بحكم بنيته الصناعية والاقتصادية، حوّل هذه الجغرافيا إلى عبء وجودي ثقيل.فالنفط يغري بالهيمنة ويولّد أطماعًا لا حدود لها ويضع الدول المنتجة في صميم الصراع الجيوسياسي العالمي ويجعل حاضرها ومستقبلها مرهونين بقوى لا تعبأ بشعوب المنطقة ولا بمعاناتها.
والآن، لماذا يجب أن نستعيد سردية التاريخ؟ لأنّ تجاهل التاريخ يسمح للشركات العملاقة أن تُعيد إنتاج سرديتها الخاصة، وتبرّر تدخلاتها المتكررة وكأنها “حماية للديمقراطية” أو “دعم لحقوق الإنسان”. بينما الوقائع تقول شيئًا آخر؛ فحيثما وُجد النفط وُجدت الشركات، وحيثما وُجدت الشركات وُجدت الهيمنة.
إن مقولة “فتِّش عن النفط” ليست استعارة، بل خريطة تحليلية تُظهر أن القرارات السياسية لا تُفسَّر بخطابات “الديمقراطية” والأزمات الإنسانية ليست دائمًا “نتائج داخلية” والحروب لا تندلع دفاعًا عن القيم، بل عن المصالح والنفط كان ولا يزال أكبر المحرّكات الخفية لمشروع الهيمنة الغربية. وتلك حقيقة يعرفها كل من يستشهد التاريخ، ولا يُغلب الإيديولوجيا على الوقائع مهما بلغ قبحها أو تلطخت بأدوات الاستعمار الجديد.
