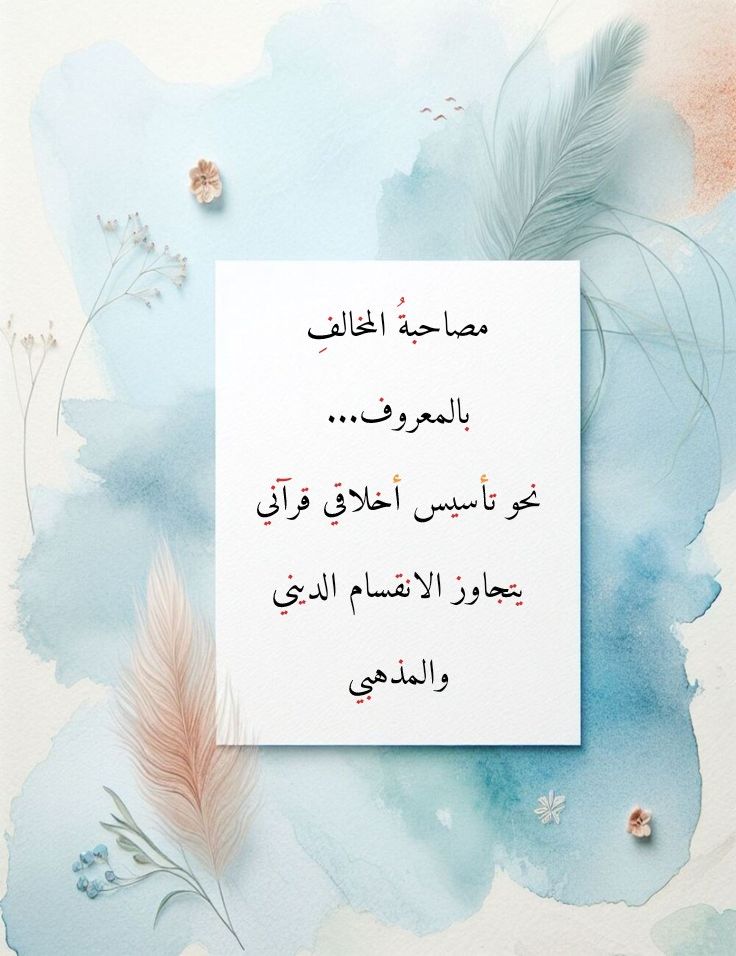
يُعَدُّ البُعد الأخلاقي أحد أهم المكونات البنيوية في الخطاب القرآني، إذ يتجاوز كونه منظومة من الأوامر والنواهي ليغدو نظامًا وجوديًّا كاملاً يوجّه السلوك الإنساني في مواجهة نوازع النفس وتقلّبات الهوى. غير أن تدبّر هذا النظام يكشف عن فجوة واسعة بين ما يطرحه القرآن من محددات سلوكية صارمة، وبين ما تعيشه كثير من المجتمعات المسلمة من انزياحٍ واضح عن هذا النسق. وتتمثل الإشكالية المركزية لهذه المقالة في السؤال الآتي: كيف صاغ القرآن مبدأ “المعروف” بوصفه إطارًا عامًا للتعامل مع المخالف، ولماذا تعجز النفس البشرية، على الرغم من هذا التوجيه الإلهي، عن التزام هذا النسق الأخلاقي؟
ينطلق القرآن من فرضية واضحة مفادها: أن النفس البشرية عاجزة، بطبيعتها، عن تهذيب نفسها بغير هدى خارجي. فالنفس، بما جُبلت عليه من هوى وتقلّب وتمرد، لا تستطيع أن تبلور منظومة أخلاقية مستقرة دون أن تتلقى توجيهًا يتجاوز محدوديتها. ولذلك جاء الوحي ليعمل كـبنية مكمّلة للنقص الأخلاقي في النفس منذ ظهور الإنسان على الأرض. وتؤكد الآيات القرآنية هذا الدور “التوجيهي-التصحيحي” للوحي، من خلال الإحالة المستمرة إلى أن الأخلاق ليست نتاجًا بشريًا خالصًا، بل جزء من التكليف الإلهي الذي لا يكتمل إيمان المرء إلا بالامتثال له.
تكشف الملاحظة الاجتماعية المعاصرة عن تضاد مؤلم بين الأمر القرآني والسلوك اليومي، حيث تتجلى مظاهر غلظة القلب وفظاظة التعامل وسُوء الظن والتسرع في الحكم على الآخرين واستسهال الإيذاء اللفظي والوجداني. وهذا التباين لا يعكس ضعفًا فرديًا فقط، بل يشير إلى قصور بنيوي في الذات الإنسانية يعيدنا إلى فكرة مركزية ألا وهي أن الإنسان كما هو، يختلف جذريًا عن الإنسان كما أراد له الله أن يكون.
ويُثير هذا التناقض تساؤلات أخلاقية جوهرية: كيف يقرأ المسلمُ آيات الرحمة والرأفة ومنها قوله تعالى: ﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ﴾ (يس 30)، ثم يظلّ سلوكه منفصلًا عن هذا المضمون العاطفي الإلهي؟
يحدد القرآن بوضوح أصلًا أخلاقيًا عامًا: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (البقرة من 83)، واللافت أن الخطاب هنا موجّه إلى الناس كافة، لا إلى المؤمنين وحدهم. وبذلك يرسّخ القرآن قاعدة أخلاقية لا تُبنى على الاشتراك العقدي، بل على كرامة الإنسان لذاته. كما يدعم الحديث النبوي هذا النسق، من خلال مقولات تأسيسية مثل: “الكلمة الطيبة صدقة” و”لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق”. تشكّل هذه المبادئ بناءً معرفيًا متكاملًا يجعل من اللين القولِي والبشاشة السلوكية جزءًا من العبادة، لا مجرد فضيلة اجتماعية.
تتجلى أصالة المبدأ القرآني في الآية التي خاطبت الأبناء الذين يجاهدهم آباؤهم على الشرك: ﴿وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ﴾ (لقمان 15). وتدل هذه الآية الكريمة على أمرين أساسيين:
1. أن مناط “المصاحبة بالمعروف” لا يسقط حتى مع وجود أشد صور المخالفة العقائدية.
2. أن المصاحبة بالمعروف ليست امتيازًا عائليًا، بل نظامًا أخلاقيًا عامًا يصلح أن يُقاس عليه سلوك المسلم تجاه كل مخالف، مهما كانت مساحة الاختلاف.
وعليه، فإن حصر “المعروف” في دائرة الأقارب أو المنتسبين لدين واحد يخالف منطق الآية، إذ إن القرآن ينقلنا من أخلاق الجماعة المغلقة إلى أخلاق الإنسان الشاملة.
يتبين لنا، وبتدبر ما تقدم، أن بإمكاننا الجزم بأن:
1. المعروف قيمة قرآنية تأسيسية لا تُستمد من الأعراف الاجتماعية بل من الوحي ذاته.
2. التعامل مع المخالف ليس استثناءً، بل جزء من بنية الأخلاق القرآنية.
3. العجز عن الالتزام بهذا النظام الأخلاقي يكشف محدودية المقاربة العقلانية والحاجة المستمرة للإرتقاء بها لتمكن الانسان من الالتزام الحرفي بكل ما يأمر به الوحي.
4. الفجوة الأخلاقية الراهنة تعود إلى إهمال التدبّر مقابل الاكتفاء بالتلاوة دون تحويل المعنى القرآني إلى ممارسة يومية.
إن مبدأ “مصاحبة المخالف في الدنيا بالمعروف” ليس توصية أخلاقية ظرفية، بل هو ركن من أركان النظام الأخلاقي في القرآن. ويُعيد هذا المبدأ صياغة العلاقة بين الإنسان والمختلف عنه على أساس إنساني عام يتعالى على الانتماءات الضيقة.
وعليه، فإن تجديد الفعل الأخلاقي في المجتمعات المسلمة يقتضي إعادة قراءة الآيات المؤسسة قراءة وظيفية لا تكتفي بمجرد الاستماع، بل تسعى إلى ترجمتها إلى سلوك، بحيث تصبح الكلمة الطيب ولين الجانب ورحابة الصدر ليست فضائل اختيارية، بل التزامًا تدينيًا أصيلًا.
