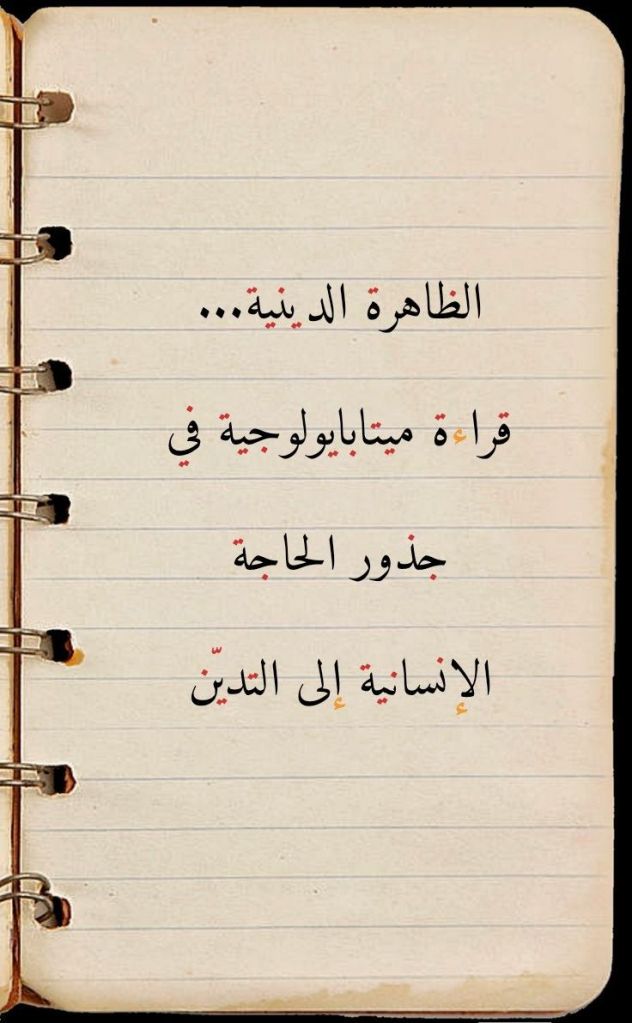
تفترض المقاربة الميتابايولوجية أنّ مسيرة الطبيعة تعرّضت في لحظةٍ مفصلية لـتحويلة تطورية أنهت انتظامها السابق، وأفرزت كائناً جديداً يدعى الإنسان، لم يعد خاضعاً لمنطق الطبيعة الخالص، ولا قادراً في الوقت ذاته على العيش دون منظوماتٍ جديدة تنظّم سلوكه الداخلي والخارجي. لقد ترتّب على تلك الانعطافة تحوّلٌ جذري في البنية التكوينية للإنسان؛ حيث أنه خرج على النظام الغريزي الذي يحكم الحيوان وورث بديلاً عنه نظاماً داخلياً أكثر تعقيداً وأقل اتساقاً وأكثر قابلية للاضطراب. وبهذا المعنى، فالمقاربة الميتابايولوجية ترى أنّ الإنسان كائن معتلّ بالتكوين، لا لأنّه فاسد، بل لأنّ بنيته الجديدة لم تولد مكتملة، ولكن مُهيّأة لأن تُهذَّب وتُضبط. وهنا يظهر سؤالٌ جوهري: كيف واجه الإنسان هذه البنية المعقدة التي ورثها بعد خروجه على قوانين الطبيعة؟ وما الذي مكّنه من مقاومة ما تولّد عنها من خللٍ داخلي وعدوانٍ خارجي؟ الجواب، وفقاً للمنظور الميتابايولوجي، يتمثّل في الظاهرة الدينية.
قبل التحويلة التطورية، كان الإنسان، بصفته حيواناً، يتشارك مع بقية الكائنات نمطاً بسيطاً من التفاعل: استجابة غريزية وعدوان منضبط وتواصل لا يتجاوز حدود البقاء واستمرار النوع. لكن ما إن حدثت الانعطافة، حتى انفلتت العلاقة مع “الآخر المختلف” من إطارها الغريزي المنضبط إلى فضاءٍ مفتوح على احتمالات الاعتداء والهيمنة والإقصاء. وبإمكاننا أن نوجز بعضاً مما أصبح عليه الإنسان بعد تلك الانعطافة التطورية في ما يلي:
1. إنفراط الضوابط الغريزية فالحيوان لا يَقتل من أجل السلطة، ولا يَسحق من أجل العقيدة، ولا يدمّر لمجرّد الرغبة في التدمير. فعدوانه جزء من “النظام الكوني” الذي يخضع له. أمّا الإنسان، فبسبب التحويلة التطورية: انفصل عدوانه عن غايته الحيوية وأصبح قادراً على إنتاج أذى غير مُقاس وتحول “الآخر” لديه إلى مشكلة وجودية لا بيولوجية. من هنا نفهم لماذا امتلأ التاريخ البشري بأصناف العدوان غير المنضبط فحروب الإبادة والتعذيب والاستعباد والطغيان والفتن والاستباحات لا يمكن نسبتها إلى أي نظامٍ طبيعي.
2. أزمة التكيّف الاجتماعي؛ حيث أثبتت التجربة التاريخية أن الإنسان لم يستطع بجهده الفردي أو بآلياته الاجتماعية ضبط العلاقة المختلّة مع الآخر. ومع كلّ محاولة لتنظيم هذه العلاقة، كان الانفلات يعود بأشكال جديدة وأكثر توحشاً. ما يعني أنّ العطب بنيوي وليس سياقياً.
وإذا كانت علاقة الإنسان بالآخر قد تضررت جراء تلك الانعطافة التطورية فإن علاقة الإنسان بذاته قد تضررت هي الأخرى. فبعد تلك الانعطافة، لم يعد الإنسان كائناً مترابط الداخل، بل أصبح ساحة صراع بين: رغبات تتناسل بلا سقف وأحزان بلا أسباب واضحة وقلق وجودي متجذّر وكآبة لا تنفع معها العلاجات ووعي عالق بين الماضي الحيواني والمستقبل الإنساني الذي لم يتحقّق للسواد الأعظم من البشر. ومع مرور العصور، أثبتت التجربة البشرية أنّ الإنسان عاجز عن شفاء ذاته بذاته ومؤهّل للاضطراب أكثر مما هو مؤهّل للسلام الداخلي وأنّ الزمن لا يزيده إلا سوءاً، حتى أصبح أكثر عدوانية وأشد يأساً وأضعف قدرة على تحمّل ذاته ناهيك عن تحمّل الآخرين. هذا العطب الداخلي هو تجلٍ مباشر لنتائج التحويلة التطورية؛ فالنفس التي نشأت فيها، هي “النفس المنفلتة” التي لا يستطيع الجسد الحيواني احتواءها ولا يستطيع العقل إلا أن يبرّر أهواءها. وهنا يظهر الدين، ليس كمنتج ثقافي أو بناء خيالي، بل كمنهاج إلهي لإعادة ضبط ما انفلت. وبالإمكان إيجاز أبرز ملامح هذا المنهاج الرباني في النقاط التالية:
1. الدين كمنظومة مضادّة لغريزة النفس الجديدة؛ فالمفارقة هنا تكمن في أن الدين يفرض على الإنسان سلوكيات تتعارض مع ما تمليه النفس التي ظهرت بعد تلك الانعطافة: فالنفس تأمر بالعدوان، والدين يأمر بالإحسان. والنفس تدفع إلى الشكّ وسوء الظن، والدين يطالب بحسن الظن. والنفس تحضّ على الأنانية، والدين يفرض الإيثار. والنفس تجد لذة في الانتقام، والدين يقول: “ادفع بالتي هي أحسن”. والنفس تجنح إلى الاستعلاء والتعالي، والدين يقول: “ولا تمشِ في الأرض مرحاً”. بهذا المعنى يصبح الدين تقنية ترويض لخللٍ بنيوي متجذّر في النفس البشرية، وليس مجرد تعليمات أخلاقية.
2. الدين يعالج العطب الاجتماعي: من أعظم ما جاء به الدين، حين يُمارس دون تسييس أو أدلجة، أنّه: يعيد تشكيل العلاقة مع الآخر ليجعلها علاقة رحمة لا صراع ويفرض قيوداً صارمة على العدوان ويقدّم معياراً موضوعياً للفضل: “خير الناس أنفعهم للناس” ويحوّل “الآخر المختلف” من تهديد وجودي إلى مجال لفعل الخير.
3. الدين يعالج العطب الداخلي: تفرض المنظومة الدينية على الإنسان محاسبة النفس وتهذيب الرغبات ودفع النفس إلى ضبط انفعالاتها وربط الوجود بنظام أعلى يعيد للإنسان إحساسه بالاتساق. هذه الممارسات ليست “روحانية” فحسب، بل هي في جوهرها استجابة ميتابايولوجية لخللٍ نشأ مع الانعطافة التطورية.
والآن يحق لنا أن نتساءل لماذا لا يستطيع الإنسان الاستغناء عن الدين؟ وفق المقاربة الميتابايولوجية، فإن الدين ليس حاجة نفسية فحسب، بل ضرورة بنيوية:
1. لأن الإنسان كائن خرج على قوانين الطبيعة دون أن يُمنح بديلاً مستقراً عنها.
2. ولأن النفس التي نشأت بعد التحويلة التطورية أصبحت مصدر اضطرابٍ دائم، لا يمكن ضبطه إلا بمنظومة عليا.
3. ولأن العلاقة مع الآخر، ومع الذات، لا تستقرّ إلا بمنظومة تلزم الإنسان ولا تترك له حرية الانفلات.
4. ولأن كلّ محاولات الإنسان التاريخية لمعالجة علله فشلت حين غاب الإطار الديني.
فالدين، في صورته الصافية، ليس ترفاً معرفياً ولا مؤسسةً اجتماعية ولا بديلاً علمياً، بل هو آلية تصحيحية لخللٍ وجودي لا يمكن للإنسان تجاوزه بنفسه.
يتبين لنا إذاً، وبتدبر ما تقدم، أن بإمكاننا أن نَصِفَ الدين بأنه إعادة هندسة للإنسان بعد الانعطافة التطورية. فالظاهرة الدينية، حين تُقرأ ميتابايولوجياً، تكشف عن كونها أعمق ردود الفعل الممكنة على التحويلة التطورية التي أخرجت الإنسان على النظام الطبيعي. فمن دون التدين الحق بالدين، يبقى الإنسان مائلاً إلى العدوان بلا ضابط وعاجزاً عن احتمال ذاته ومتورّطاً في رغباتٍ لا تشبع وغارقاً في صراعاتٍ لا نهاية لها. ومن هنا نفهم حكمة قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: “خير الناس أنفعهم للناس”، فهذا القول يقدّم القانون المضاد للنزعة التي ولّدتها الانعطافة التطورية، ويضع للإنسان معياراً يكبح النفس ويعيده إلى موقعه الصحيح في الوجود.
