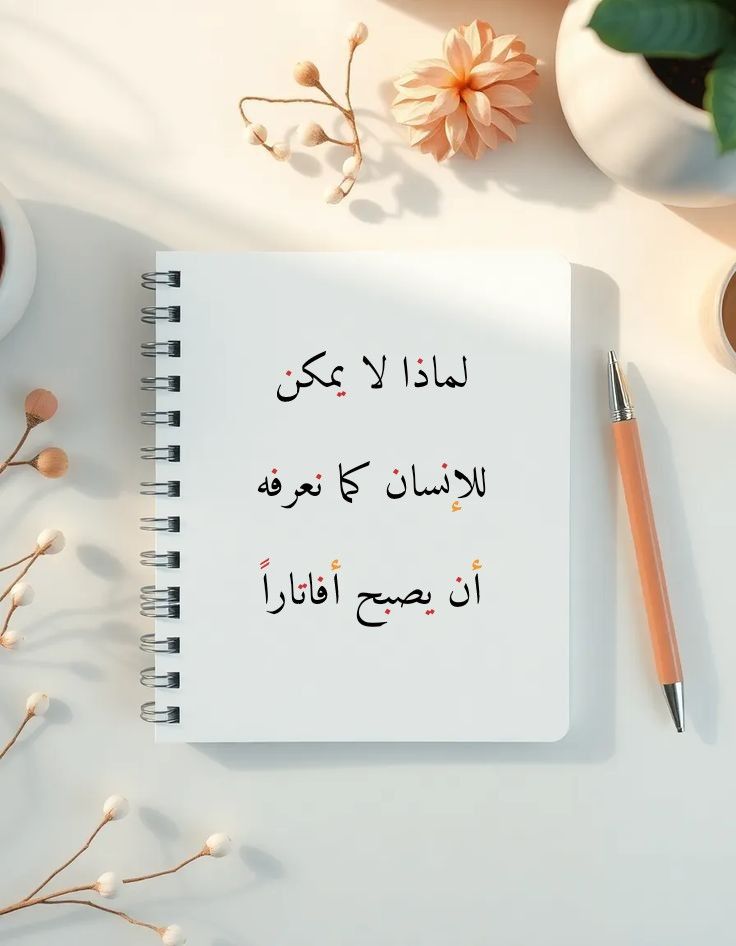
شهد مفهوم الأفاتار (Avatar) تحوّلات دلالية عميقة عبر التاريخ؛ فمن تجلٍّ إلهي في الميثولوجيا الهندوسية، إلى تجسيد رمزي للذات في بعض التصوّرات اليهودية المتأخرة، وصولًا إلى صورة رقمية بديلة للإنسان في الفضاءات الافتراضية المعاصرة. غير أن القاسم المشترك بين هذه الاستخدامات جميعًا يتمثّل في افتراضٍ ضمني مفاده أن الإنسان، أو ما يُمثِّله، قادر على تجاوز حدود جسده الطبيعي والظهور في صورة أخرى أشدّ أو أسمى أو أكثر فاعلية من صورته الأصلية. يأتي القرآن الكريم ليقوّض هذا الافتراض من أساسه، لا بوصفه موقفًا لاهوتيًا فحسب، بل بوصفه حكمًا أنطولوجيًا صارمًا متعلّقًا بطبيعة الخلقة وحدود الإمكان الوجودي لكل كائن.
والآن، لنستقصي ظهورات هذا المصطلح (الأفاتار) عبر التاريخ، ففي الهندوسية، يُعرَّف الأفاتار بوصفه نزول الإله في هيئة بشرية، كما في تجسّدات الإله المزعوم فيشنو المتعددة. هنا، لا يكون الأفاتار بشرًا ارتقى، بل إلهًا تنزَّل. غير أن هذا التصوّر، وإن بدا منسجمًا داخليًا ضمن نسقه الأسطوري، قد أسّس تاريخيًا لفكرة إمكان تبادل المستويات الوجودية بين “الإلهي” والبشري.
أما في بعض القراءات اليهودية الصوفية (الكابالا)، فتظهر تصوّرات أقل صراحة، لكنها لا تخلو من نزعة تجسيد الحضور الإلهي أو الروحي في أشكال بشرية أو شبه بشرية، سواء عبر الملائكة أو عبر “ظلّ” إلهي فاعل في التاريخ.
وفي التطبيقات الرقمية المعاصرة، انتُزع المصطلح من سياقه “الديني” ليُعاد توظيفه بوصفه ذاتًا افتراضية بديلة: صورة يتحكّم بها الإنسان، تتجاوز ضعفه الجسدي، وتُلبّي رغبة دفينة في الانفصال عن حدود الجسد والهوية الطبيعية.
وعلى النقيض من هذه التصوّرات، يقدّم القرآن العظيم تصورًا بالغ الدقة في تقسيم مراتب الخلقة وتحديد ما هو ممكن وما هو مستحيل لكل مرتبة. فالقرآن يؤكد صراحةً إمكانية “تمثُّل” الملائكة بشرًا، وذلك كما في قوله تعالى: {فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا} (مريم: 17). هنا، لا يجري الحديث عن رمز أو خيال، بل عن تمثُّل كامل: ظهور جبريل عليه السلام في هيئة إنسان، مكتمل الصفات البشرية الظاهرة. وهذا “التمثّل” ليس اكتسابًا بشريًا، بل قدرة ملائكية نابعة من “خلقةٍ أشدّ”، مخلوقة من نور. كما يشير القرآن إلى قدرة الجن على “التجسّد”، كما في قوله تعالى: {وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ} (ص: 34)، وهو نصّ يفتح باب الفهم على إمكانية “تجسّد” الجن في هيئة بشرية، بحكم خلقتهم من نار، وهي خلقة أرقى من حيث الكثافة الوجودية من الطين.
والآن، يحق لنا أن نتساءل: “لماذا لا يستطيع الإنسان أن يكون أفاتارًا؟”
يُحسَم الجواب قرآنيًا من خلال مبدأ الخلقة؛ فالإنسان خُلق من طين أما الملائكة فخُلقوا من نور والجن خُلقوا من نار. وهذا التدرّج ليس تشريفًا أخلاقيًا، بل تفاوت وجودي في القدرة. فالقانون التي يرسّخه القرآن مفاده أن الأشدّ خَلقاً يستطيع أن يتمثّل بالأدنى، أمّا الأدنى فلا يستطيع أن يرتقي خَلقيًا إلى الأشد خَلقاً. ومن ثمّ، فإن الإنسان، بحكم ضعفه الخَلقي لا يستطيع أن يتصرّف كأفاتار، لا في حياته ولا بعد مماته ولا في الواقع ولا في الافتراض. وأي محاولة لتصوير الإنسان بوصفه كائنًا قادرًا على تجاوز جسده أو الظهور في هيئة أخرى “أشد خَلقاً” ليست سوى وهم تخيُلي ناتج عن خلط المستويات الوجودية.
ولكن، هل هناك عودة لأسطورة “الأفاتار البشري” بصيغة معاصرة، كما تتجلى في تجسيد هذه الأسطورة في الفضاء الرقمي؟ ما نشهده اليوم في الفضاء الرقمي ليس قطيعة مع الميثولوجيا، بل إعادة إنتاجها بأدوات جديدة. فالأفاتار الرقمي ليس إلا تعبيرًا حديثًا عن رغبة الإنسان القديمة في الانفصال عن جسده والتحكّم في صورة بديلة أكثر قوة أو جمالًا وادّعاء قدرة ليست من طبيعته. غير أن هذه الممارسة، مهما بلغت دقّتها التقنية تبقى محاكاة رمزية لا تغيّر شيئًا من حقيقة “الخِلقة البشرية الضعيفة”. فالإنسان لا يغادر “ضعفه الخَلقي”، بل يموّه عليه.
يتبين لنا، وبتدبر كل ما تقدم، أن القرآن العظيم يقدم موقفًا فريدًا في صرامته الأنطولوجية: لا يُنكر التمثّل ولا التجسّد، لكنه يحصرهما في من خُلقوا لذلك: الملائكة والجن. أما الإنسان، فقد خُلق ضعيفًا، محدود القدرة، مرتبطًا بجسده الطيني ارتباطًا وجوديًا لا فكاك منه. ومن ثمّ، فإن كل تصوّر يجعل الإنسان أفاتارًا، “دينيًا” كان أو رقميًا، ليس إلا خرقًا لمنطق الخِلقة، ومحاولة مستحيلة لتجاوز ما لم يُقدَّر له تجاوزه.
