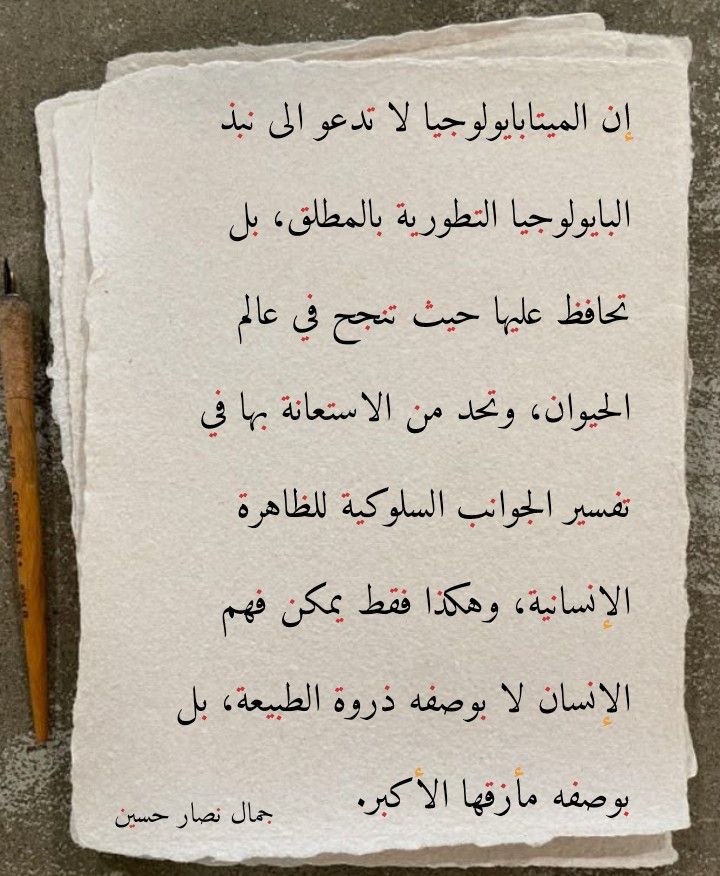
كنت قد أوضحت في مقالات سابقة أن صفاتٍ بشرية مركزية كالاكتئاب الوجودي والسأم والشعور بالعدمية والتناقض الانفعالي وسوء التقدير الاجتماعي، لا يمكن تفسيرها ضمن المنطق التطوري الكلاسيكي دون الوقوع في تناقض منهجي صارخ.
فكل محاولة لإدراج هذه الظواهر ضمن “المنفعة التطورية” تنتهي إمّا إلى تعميمات فضفاضة لا يمكن اختبارها أو افتراضات ترقيعية من نوع “الآثار الجانبية” أو إعادة تعريف الضرر بوصفه فائدة مؤجَّلة. وهذا كله دليل على أن الإشكال ليس في التفاصيل، بل في الإطار ذاته.
تنطلق الميتابايولوجيا من فرضية مغايرة جذريًا، مفادها أن الإنسان لم يكن استمرارًا تراكميًا للسلسلة الحيوانية، بل نتاج تحويلة نوعية rupture في مساره التكويني، مسّت بنية الوعي وطبيعة الإرادة وعلاقة الكائن بذاته وعلاقته بالجماعة والوجود. إن هذه التحويلة لم تُنتج “كائنًا أرقى”، بل كائنًا منقسمًا على ذاته: كائنًا خرج من الانسجام الغريزي الحيواني، دون أن يبلغ توازنًا بديلًا.
من منظور ميتابايولوجي، لا تُفهم الصفات البشرية الهدّامة بوصفها “أخطاء تطورية”، بل بوصفها أعراضًا بنيوية ناتجة عن:
أ. تضخّم الوعي دون اكتمال أدواته، فالإنسان يرى أكثر مما يحتمل، ويدرك أكثر مما يستطيع استيعابه، دون امتلاكه آليات بيولوجية كافية لتنظيم هذا الفيض الإدراكي.
ب. فقدان الانضباط الغريزي، فبينما يضبط الحيوان انفعالاته ضمن حدود البقاء، فقد الإنسان هذا القيد دون أن يعوّضه بنظام بديل متماسك.
ج. تشكّل “الأنا المتضخمة”، وهي نواة الخلل الميتابايولوجي: أنا واعية بذاتها أكثر مما ينبغي، ولكنها عاجزة عن الانسجام مع محيطها أو نوعها.
وهنا يصبح الاكتئاب نتيجة وعي بلا أفق والسأم نتيجة فائض إدراك بلا وظيفة والعدمية نتيجة وعي فقد مرجعياته الغريزية وسوء التقدير الاجتماعي نتيجة انفصال العقل عن منظومة التقييم التطورية الدقيقة. أما الميتابايولوجيا فإنها ترفض، وبشكل قاطع، تفخيم البايولوجيا التطورية للإنسان. فالإنسان، من هذا المنظور، ليس الكائن “الأرقى”، بل الأكثر قلقًا والأكثر تذمرًا والأكثر قابلية للانهيار والأقل انسجامًا مع قوانين الطبيعة. وهذه ليست مصادفة، بل علامات قطيعة بنيوية مع النظام الحيوي الذي كان يضمن التوازن والاستمرارية. وبناءً على ذلك، تقترح الميتابايولوجيا إعادة تموضع الإنسان خارج السلم التطوري التقليدي، فهو ليس حيوانًا متفوقًا ولا كائنًا مكتمل التكوين، بل كائنًا انتقاليًا مأزومًا، يعيش توترًا دائمًا بين ما كان عليه (الانسجام الحيواني) وما لم يكتمل بعد (التوازن الوجودي).
يتبين لنا، وبتدبر ما تقدم، أن الدعوة إلى الميتابايولوجيا ليست تمرّدًا على العلم، بل إنقاذٌ له من إسقاطاته التفخيمية. فحين يعجز نموذج تفسيري عن احتواء ظواهر مركزية، فإن توسيع الإطار يصبح واجبًا معرفيًا لا خيارًا فلسفيًا.
إن الميتابايولوجيا، بهذا المعنى، لا تدعو الى نبذ البايولوجيا التطورية بالمطلق، بل تحافظ عليها حيث تنجح في عالم الحيوان، وتحد من الاستعانة بها في تفسير الجوانب السلوكية للظاهرة الإنسانية، وهكذا فقط يمكن فهم الإنسان لا بوصفه ذروة الطبيعة، بل بوصفه مأزقها الأكبر.
