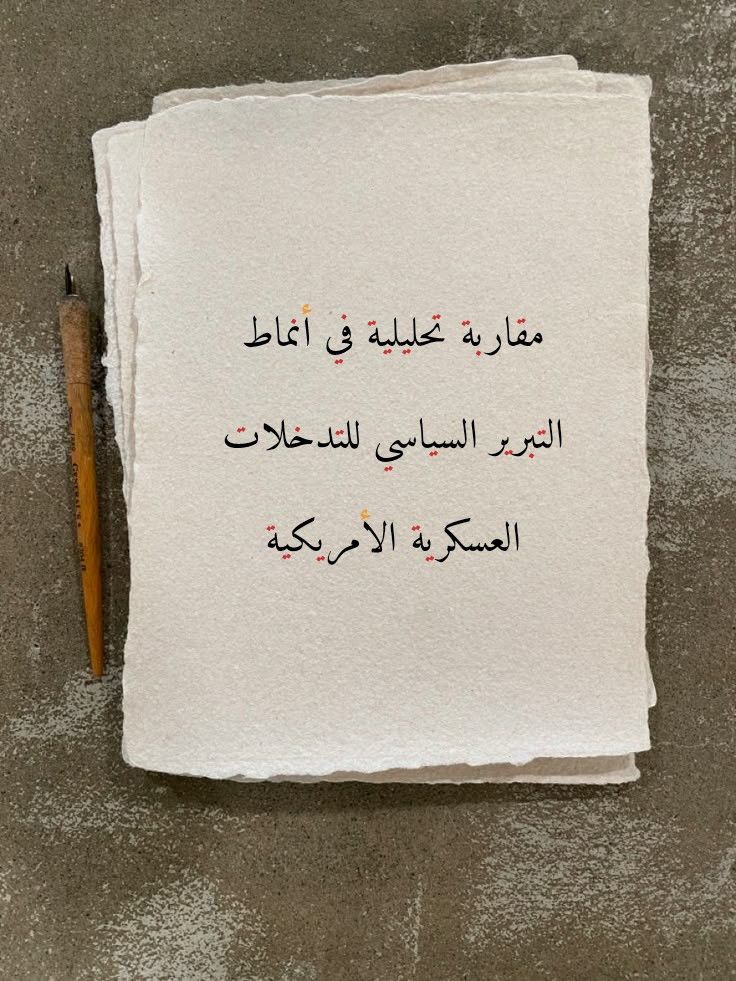
تشير مراجعة تاريخ التدخلات العسكرية الأمريكية المعاصرة إلى نمط متكرر من إنتاج المسوِّغات الأخلاقية والسياسية التي تُستخدم لتبرير أفعال قسرية تتجاوز حدود القانون الدولي، وتتناقض في كثير من الأحيان مع المبادئ المعلنة للسيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها. وعلى الرغم من تنوّع الخطاب المُسوِّغ لهذه التدخلات، فإن جوهر الفعل السياسي يظل واحدًا، ما يسمح بالحديث عن بنية طغيان ثابتة تتبدّل أقنعتها دون أن يتغير منطقها الداخلي.
لطالما انتقد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترمب السياسات الخارجية التي انتهجها أسلافه، ولا سيما تلك التي أفضت إلى تورط الولايات المتحدة في حروب طويلة الأمد بلا عائد استراتيجي واضح. غير أن هذا النقد، عند إخضاعه للفحص التحليلي، لا يصمد أمام الممارسة الفعلية، إذ يعيد ترمب إنتاج المنطق ذاته الذي ادّعى معارضته، وإن بصياغات لغوية مختلفة.
فما استعان به جورج بوش الابن من خطاب «أسلحة الدمار الشامل» لتبرير غزو العراق، يقابله اليوم خطاب آخر يوظّف مفردات «الخطر» و«الاستبداد» و«التهديد الإقليمي» لتسويغ الضغط والعدوان على فنزويلا. وفي الحالتين، لا تؤدي الذريعة وظيفة تفسيرية بقدر ما تؤدي وظيفة إضفاء الشرعية الأخلاقية المسبقة على قرار متَّخذ سلفًا.
يكشف التحليل البنيوي لهذه الخطابات أن المصلحة الاقتصادية، ولا سيما المرتبطة بالطاقة والموارد الطبيعية، تشكّل العامل الحاسم الذي يجري إخفاؤه خلف ستار القيم. فالعراق لم يكن، في واقع الأمر، يمتلك ما زُعم أنه يمتلكه من أسلحة محرّمة، تمامًا كما أن توصيف فنزويلا بوصفها تهديدًا وجوديًا لا يصمد أمام المعطيات الواقعية. إن الثابت في الحالتين هو أن النفط يمثّل المحرّك الصامت للقرار السياسي، بينما تُستدعى الأخلاق لاحقًا لتبرير نتائجه.
لا يمكن فهم هذا النمط من السلوك السياسي بوصفه خللًا ظرفيًا أو انحرافًا فرديًا، بل ينبغي النظر إليه كامتداد لبنية نفسية–حضارية أعمق، تُظهر قدرة الإنسان، حين يمتلك فائض القوة، على إعادة تأويل أفعاله العدوانية بوصفها أفعالًا ضرورية، بل خيّرة. في هذا السياق، يصبح التبرير جزءًا من آلية نفسية تُعيد صياغة الفعل الظالم في صورة واجب أخلاقي، ما يحول دون مساءلته ذاتيًا.
تخلص هذه المقالة إلى أن تغيّر المسوِّغات الخطابية لا يعني تحوّلًا في طبيعة الممارسة السياسية، بل يؤكد وحدة المنطق الذي يحكمها. فحين تتكرّر الذرائع وتبقى النتائج واحدة، يغدو الحديث عن «تنوّع المبررات» حديثًا شكليًا يخفي خلفه طغيانًا بنيويًا ثابتًا، يتغذّى على القوة، ويتقن إعادة إنتاج شرعيته عبر اللغة. ومن ثم، فإن نقد هذا الطغيان لا يستقيم ما لم يتجاوز الأشخاص والوقائع، ليطال المنظومة الذهنية التي تتيح للإنسان أن يرى أسوأ أفعاله في صورة أفضل ما يمكن أن يُنجَز.
