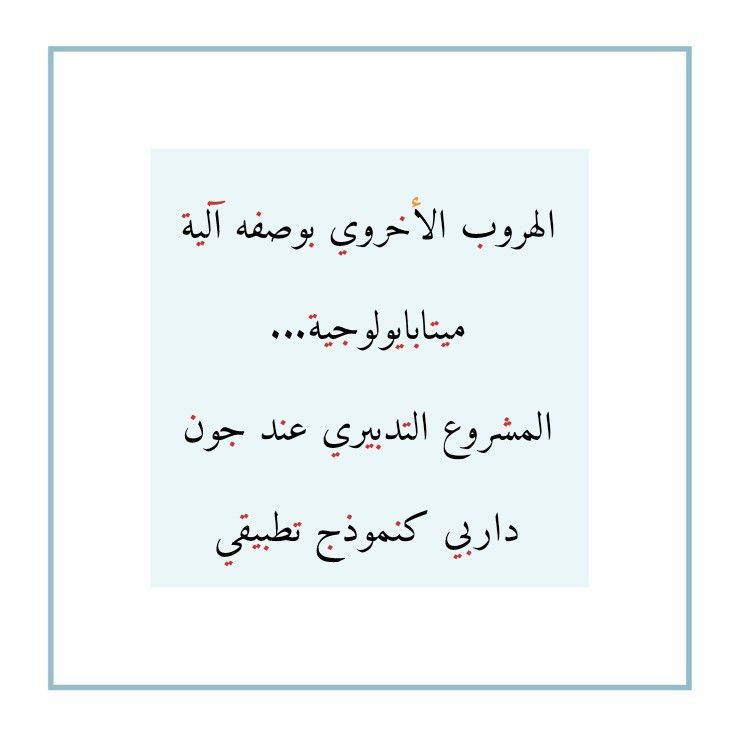
في المراحل التي يبلغ فيها الضغط الوجودي على الكائن البشري حدًّا يتجاوز قدرته على الاستيعاب النفسي والمعرفي، لا يعود العقل في وضع يسمح له بإنتاج معنى مركّب، بل ينكفئ نحو آليات اختزالية للخلاص. إحدى هذه الآليات، وربما أخطرها، هي ما يمكن تسميته ميتابايولوجيًا بـ الهروب الأخروي: أي نقل التوتر من الحاضر الذي يتعذر على المرء احتماله إلى نهاية كونية حاسمة، تُلغى فيها مسؤولية الفعل ويُستبدل الصراع التاريخي بحدث خلاص فجائي. وضمن هذا الإطار، لا تعود الأفكار الأخروية مجرّد معتقدات دينية، بل تتحول إلى استجابات بنيوية لخلل أعمق في علاقة الإنسان بالزمن والمعنى والمسؤولية. وفي هذا السياق يُخطئ من يتعامل مع جون نلسون داربي بوصفه منشئ ظاهرة معزولة. فداربي لم “يخلق” الهروب الأخروي، بل منحه صيغة لاهوتية صالحة للتداول الجماهيري. فما فعله داربي ميتابايولوجيًا هو تحويل القلق الوجودي إلى نظام زمني وتحويل الخوف من التاريخ إلى جدول خلاص وتحويل العجز عن إصلاح العالم إلى انتظار مغادرة العالم.
يقوم المشروع التدبيري لداربي على تفكيك التاريخ إلى مقاطع منفصلة (تدابير)، لا بوصفها مراحل نضج، بل كسلسلة إخفاقات بشرية متتالية، يُرفع عنها التكليف الأخلاقي مع كل فشل. فمن منظور الميتابايولوجيا فإن هذا التفكيك ليس لاهوتيًا بريئًا، بل هو إلغاء لفكرة التراكم التاريخي ونفي ضمني لإمكانية الإصلاح من داخل الزمن. هنا يتحول الزمن من مجال فعل إلى مجرّد ممر انتظار.
إن فكرة الاختطاف (Rapture) تمثل الذروة النفسية للمشروع التدبيري لداربي.
ميتـابايولوجيًا، فأن الاختطاف يعني خلاص بلا مواجهة ونجاة بلا تضحية وخروجًا من العالم بدل تغييره. إنه ليس وعدًا دينيًا فحسب، بل حلم عصبي–نفسي بالانسحاب النهائي من واقع عجز الانسان عن احتمال وطأته فتعذر عليه بالتالي الامتثال الطوعي لسطوته.
لقد أدركت الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الارثوذوكسية والكنيسة البروتستانتية خطر هذه البنية لأنها تفكك وحدة السرد الديني وتعفي الإنسان من مسؤوليته التاريخية وتستبدل الأخلاق بالاصطفاء. لكن الفشل الكنسي لم يكن في النقد، بل في عدم إدراك أن داربي يخاطب خللًا بنيويًا جديدًا لم تكن اللاهوتيات الكلاسيكية مهيأة للتعامل الإصلاحي معه: خلل الإنسان الحديث الذي يعيش وفرة معرفية وفقرًا معنويًا وتسارعًا زمنيًا خانقًا.
ولنأخذ مثالاً على ما قدمه داربي أداةً رمزية للتعامل مع هذا الإخفاق الكنسي. تتمثل هذه الأداة في إيراده العدد 144 ألف. فهذا العدد في أصله هو رمزٌ كوني للكمال البنيوي. غير أن العقل الهارب أخرويًا لا يحتمل الرمز، لأنه يتطلب تأويلاً وصبرًا.
فماذا فعل داربي؟ حوّل الرمز إلى رقم والعدد إلى بوابة والإيمان إلى بطاقة عبور. هنا يظهر بوضوح التحول من دين المعنى إلى دين الإحصاء، وهو أحد أعراض الخلل الميتابايولوجي في مرحلة ما بعد “الإنسان الرمزي”.
وتتمثل قدرة داربي على الحضور العابر للأجيال في هذه العودة المؤثرة في القرن الحادي والعشرين. فهذه العودة ليست عودة فكر، بل عودة وظيفة في عالم بلا يقين معرفي ولا أفق سياسي وبلا سردية أخلاقية جامعة؛ فيصبح الهروب الأخروي أكثر إغراءً من الإصلاح وأكثر بساطة من المواجهة وأكثر طمأنة من المسؤولية. ولهذا، انجذب الشباب، من كلا الجنسين، لا لأنهم أكثر تدينًا، بل لأنهم أكثر هشاشة وجودية.
إن ما هو خطيرٌ في المشروع التدبيري لداربي ليس انتشاره الشعبي، بل تغلغله في الطبقات المؤثرة، فحين يتحول الهروب الأخروي إلى رؤية سياسية ويُقرأه العالم بوصفه مسرح نهاية لا مجال لإصلاحه وحين تُتخذ القرارات الكبرى بعقلية “لن يطول الأمر”. هنا لا يعود الهروب خيارًا نفسيًا فرديًا، بل منطق إدارة للعالم.
يتبين لنا، وبتدبر كل ما تقدم، أنه وفي ضوء الميتابايولوجيا لا يُفهم داربي بوصفه لاهوتيًا منحرفًا، بل بوصفه عارضًا تشخيصيًا لمرحلة إنسانية محددة: مرحلة يعجز فيها الإنسان عن العيش داخل الزمن فيحوّل نهايته إلى ملاذ. الهروب الأخروي ليس خطأً في الإيمان، بل إشارة تحذير إلى خلل أعمق في علاقة الإنسان بذاته وبالعالم وبمسؤوليته الأخلاقية .
