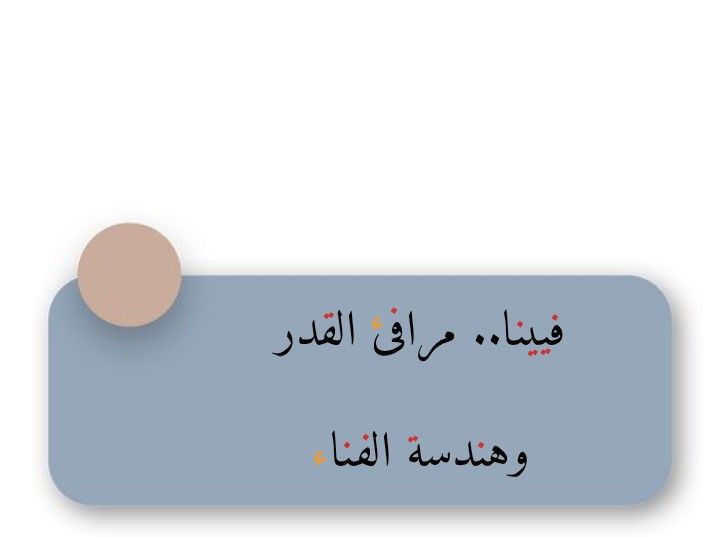
لم تكن فيينا في وعي التاريخ مجرد إحداثية جغرافية انحبست عند منعطف الدانوب، بل كانت “متناً” حضارياً يستعصي على القراءة السطحية؛ متنٌ تتشابك فيه “الجغرافيا القدرية” بصرامة الأرقام وهشاشة الروح الإنسانية. فبينما كان الخيميائي الأوروبي يقف أمام بوتقته في محاكاةٍ “قرديّة (Simia Naturae” لسر الصنعة الإلهية”، كانت فيينا تقف أمام قدرها الكوني كحلقة وصلٍ بين عالمين. إن استنطاق “بيان” هذه المدينة يكشف عن نزوعٍ باطني نحو “هندسة الـ 144″؛ ذلك الرقم الذي لم يكن في عمارة كاتدرائياتها وقصورها مجرد وحدة قياس، بل كان “تحصيناً دينياً-رياضياً” وحصناً رمزياً يُراد به ترويض فوضى “الآخر العثماني” القادم من الشرق. هنا، وعند أبراج “سان شتيفان”، دارت “عجلة العمالقة” الأرضية في مواجهة الصدمة العثمانية، لتلد من رحم الحصار حداثةً مرتبكة، تتدثر بفخامة الباروك Baroque لتستر عُري “هشاشتها” الوجودية، وتعلن أن الإنسان مهما تعملق في بنيانه، يظل أسيراً لندوب براءته المفقودة على أعتاب التاريخ.
