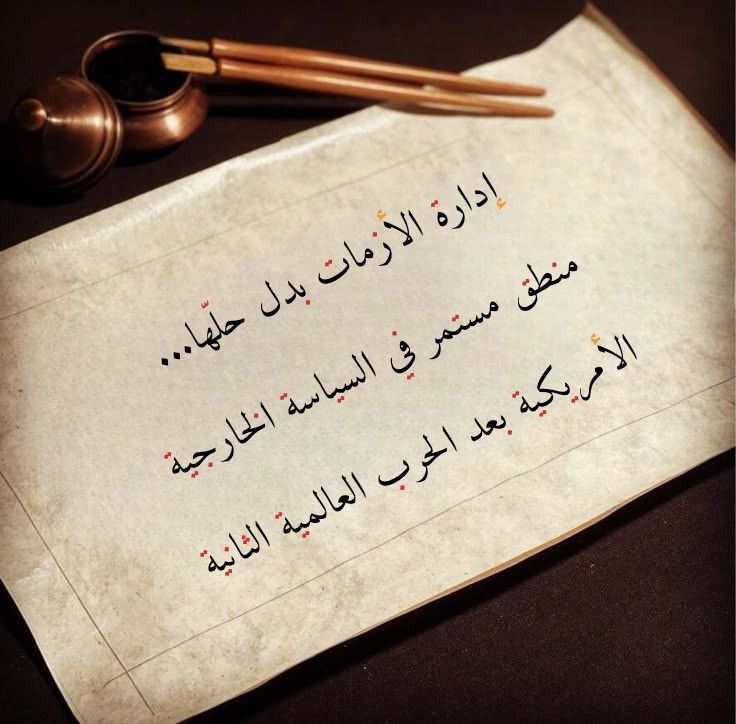
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وجدت الولايات المتحدة نفسها في موقع القوة الأعظم داخل النظام الدولي الناشئ. وقد رافق هذا التحول بروز نمطٍ خاص في التعاطي مع الأزمات الدولية، يقوم وفق عدد من الباحثين والنقاد على احتواء الأزمات وإدارتها أكثر مما يقوم على السعي إلى تسويات نهائية تُنهي أسبابها الجذرية.
لا تنطلق هذه المقاربة من افتراض مؤامراتي بسيط، بل من تحليل بنيوي يرى أن استمرار بعض الأزمات ضمن مستويات يمكن التحكم بها قد يحقق مكاسب استراتيجية واقتصادية وأمنية تتجاوز ما قد ينتج عن تسويات شاملة تعيد الاستقرار وتقلّص الحاجة إلى التدخل الخارجي.
ففي أدبيات السياسة الدولية، تُعرَّف إدارة الأزمات بأنها جملة الإجراءات التي تهدف إلى منع التصعيد غير المحسوب والحفاظ على توازن القوى وضبط الصراع دون تفكيكه جذرياً والإبقاء على قنوات التأثير والوجود العسكري والدبلوماسي. وتختلف هذه المقاربة عن حلّ النزاعات الذي يتطلب معالجة الأسباب البنيوية للصراع: توزيع السلطة والموارد والحدود وأنظمة الحكم والهويات السياسية، وهي ملفات غالباً ما تقود إلى إعادة تشكيل توازنات إقليمية لا تكون بالضرورة منسجمة مع مصالح القوى الكبرى.
منذ خطاب الرئيس دوايت أيزنهاور الشهير عام 1961، دخل مصطلح “المجمع الصناعي–العسكري” إلى القاموس السياسي الأمريكي لوصف شبكة المصالح التي تربط الصناعات الدفاعية بالمؤسسة العسكرية والقرار السياسي. فوفق هذا المنظور، فإن استمرار بؤر التوتر يبرّر الإنفاق العسكري المرتفع والأزمات المزمنة تفتح أسواقاً دائمة لتصدير السلاح والانتشار العسكري الخارجي يعزز النفوذ الجيوسياسي والقواعد المتقدمة تصبح أدوات ضغط إقليمي طويلة الأمد. ولا يُفهم هذا بالضرورة على أنه قرار مركزي موحّد، بل كنتيجة لتفاعل بيروقراطيات متعددة ولوبيات اقتصادية وحسابات انتخابية واستراتيجيات احتواء الخصوم.
فمنتقدو السياسة الأمريكية يشيرون إلى أن تدخلاتها في عدد من الأزمات، بدلاً من إغلاقها، أسهمت في إطالة أمد النزاعات وإنتاج صراعات ثانوية وعسكرة البيئات الإقليمية وخلق أنظمة اعتماد أمني طويل الأمد على واشنطن. فحين تُدار الأزمة بحيث لا تنفجر، ولكن أيضاً لا تُحل، تتحول إلى حالة شبه دائمة داخل النظام الدولي، نزاع منخفض الشدة، لكنه مستمر ويُعاد إنتاجه عبر جولات متكررة من التوتر.
فبعض المحللين يشيرون إلى تزامن فترات التصعيد الخارجي مع أزمات داخلية أمريكية، بوصف السياسة الخارجية إحدى ساحات إعادة ترتيب الإجماع الوطني.
يُستشهد في هذا السياق بستينيات القرن العشرين، حيث تزامنت أزمة الحقوق المدنية والاحتجاجات الاجتماعية الواسعة والانقسام السياسي الحاد، مع تصاعد التدخل العسكري في فيتنام. ولا يُقدَّم هذا الترابط عادة على أنه علاقة سببية مباشرة، بل كإشارة إلى أن الأزمات الخارجية قد تؤدي أحياناً وظيفة سياسية داخلية تتجلى في توحيد مؤقت لشرائح المجتمع أو تحويل انتباه الرأي العام أو إعادة تنظيم الأولويات الوطنية. وضمن هذا الإطار، تبدو بعض الإدارات الأمريكية ميّالة إلى منطق الضبط المستمر من منع الخصوم من تحقيق نصر كامل أو منع الحلفاء من الانهيار أو إبقاء النزاع ضمن سقف محسوب أو تجنب التسويات التي تغيّر الخريطة الاستراتيجية جذرياً. وهذا النمط يُنتج استقراراً هشّاً، وليس حرباً شاملةً أو سلاماً نهائياً، وهو ما يجعل النظام الدولي يعيش في حالة توتر مزمن بدل انتقاله إلى مرحلة إعادة بناء.
يتبين لنا، وبتدبر ما تقدم، أن توصيف السياسة الأمريكية بأنها قائمة على تفضيل إدارة الأزمات على حلّها يبقى فرضية تحليلية داخل حقل العلاقات الدولية، وهذه الفرضية لها أنصارها وخصومها، وتحتاج دائماً إلى تقييم حالة بحالة. غير أن التراكم التاريخي للأزمات الممتدة وانتشار القواعد العسكرية واستمرار الإنفاق الدفاعي الضخم، يطرح أسئلة مشروعة حول ما إذا كانت بنية النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية قد شجّعت، بقصد أو بغير قصد، على تحويل الصراع إلى مورد استراتيجي دائم، بدل أن يكون مشكلة يُسعى إلى تصفيتها.
