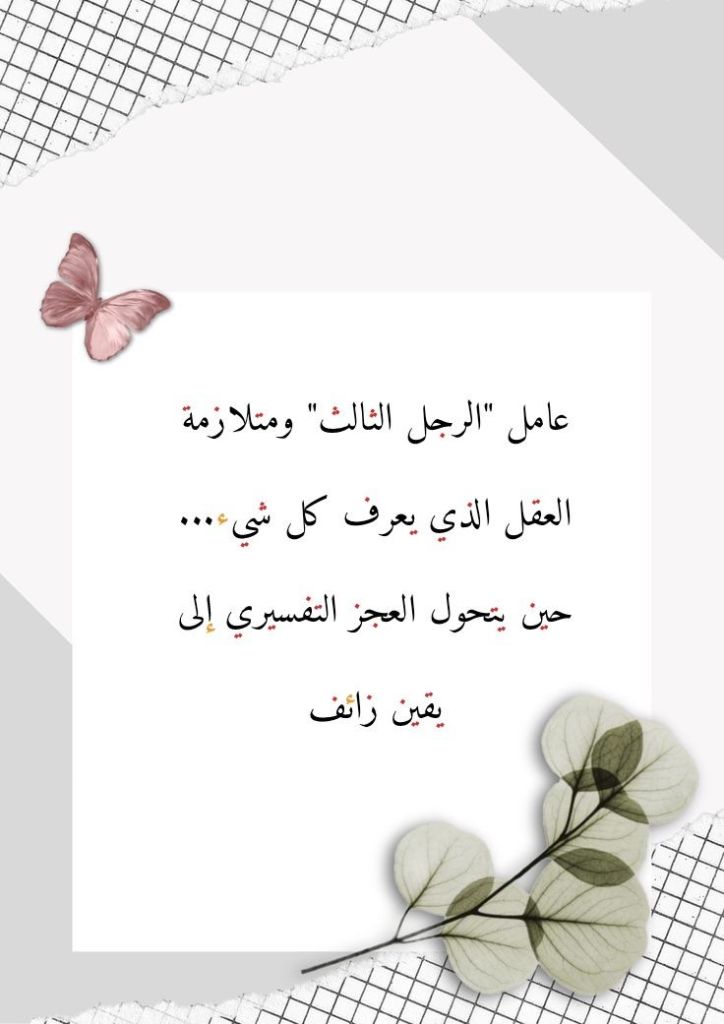
من المسلمات التي يُفترض أن يقوم عليها البحث العلمي الرصين الاستعدادُ الدائم للاعتراف بالجهل المطلق أو المؤقت، أو بلغة أكثر دقة، الاعتراف بأن منظومتنا النظرية الحالية قد لا تكفي لتفسير ظاهرة بعينها. غير أن التاريخ العلمي، كما التاريخ الفكري للبشرية عموماً، يكشف عن ميلٍ متكرر لدى العقل البشري، وخاصة عندما يتوهم امتلاك أدوات معرفية متقدمة، إلى مقاومة هذه العبارة البسيطة: “لا أدري”. فعوض أن يُعلِّق الحكم، أو يقر بإمكان وجود قوانين غير مكتشفة، أو عوامل لم تدخل بعد في الحساب، يميل هذا العقل إلى الإسراع في إنتاج تفسير جاهز، مستخرجٍ مما بين يديه من نظريات، حتى إن كانت غير كافية، وكأن الاعتراف بالعجز المعرفي يشكل تهديداً لهويته العقلانية ذاتها. ومن هنا تقترح هذه المقالة توصيفاً مزدوجاً لهذه النزعة: “متلازمة العقل الذي يعرف كل شيء”، ويأتي “عامل الرجل الثالث” مثالاً نموذجياً عليها. ويمكن توصيف هذه المتلازمة بأنها نمطاً معرفياً دفاعياً يظهر حين يواجه العقل ظواهر لا تنسجم مع نماذجه التفسيرية الراهنة. وتتمثل أبرز سماتها في:
1. رفض الفراغ التفسيري: الفراغ المعرفي يُشعر العقل بالتهديد؛ فيسارع إلى ملئه بأي تفسير متاح.
2. إعادة تأويل الظاهرة قسراً: بدلاً من مراجعة النموذج النظري، تُعاد صياغة الظاهرة نفسها كي تنسجم معه.
3. التحول من الشك العلمي إلى يقين زائف: حيث يُقدَّم التفسير المؤقت بوصفه خاتمة النقاش لا بدايته.
4. تُختزل الظواهر غير المفسَّرة في نعوت مثل: أوهام أو هلوسات أو خرافات أو أخطاء قياس من دون برهنة مستقلة كافية.
هذه المتلازمة لا تعبّر عن قوة العلم، بل عن هشاشة نفسية كامنة في الذات العارفة عندما تُواجَه بحدودها.
ولكن ما هو «عامل الرجل الثالث»؟
يشير مصطلح “عامل الرجل الثالث” إلى تقارير متكررة، خصوصاً في ظروف قصوى كالعزلة الشديدة أو الخطر الوجودي، عن شعور أشخاص بوجود كيان مرافق غير مرئي يمنح الطمأنينة أو التوجيه أو الدعم النفسي، رغم غياب أي شخص فعلي. وبدلاً من التعامل مع هذه الظاهرة باعتبارها سؤالاً مفتوحاً عن طبيعة الوعي وحدود الإدراك وآليات الدماغ في الظروف القصوى، يسارع “العقل الذي يعرف كل شيء” إلى تصنيفها فوراً في خانة الهلاوس العصبية أو إسقاطات نفسية دفاعية أو اضطرابات إدراكية بحتة. وقد تكون هذه التفسيرات صحيحة جزئياً، أو حتى في كثير من الحالات، لكن الإشكال لا يكمن في اقتراح تفسير، بل في “تأليه” عبر تقديمه بوصفه التفسير النهائي الذي يُغلق باب البحث. ومن هنا يتحول العلم من مشروع مفتوح إلى عقيدة مكتفية بذاتها.
إن هذه النزعة ليست وليدة العصر الحديث. فالتاريخ البشري حافل بأمثلة لآلية معرفية مشابهة. فحين واجهت المجتمعات القديمة أحداثاً خارجة عن منظوماتها التفسيرية السائدة، لم يكن السؤال المطروح: هل نحتاج إلى إعادة بناء أطرنا المعرفية؟، بل: كيف نُعيد إدراج هذه الظاهرة داخل قاموسنا المفهومي القائم؟ ومن هنا يمكن فهم لماذا فسّر كثير من الأقوام معجزات الأنبياء، بحسب الروايات الدينية، بوصفها سحراً لا غير. فالسحر لم يكن تفسيراً علمياً، بل وسماً معرفياً يسمح للعقل بالحفاظ على تماسك نموذجه للعالم دون الحاجة إلى هدمه أو تعديله. إنه نفس الميكانيزم النفسي: حين يعجز النموذج، فلا يُراجع النموذج، بل يُعاد تعريف الحدث.
إن العلم، في جوهره، يقوم على قابلية الدحض، وعلى الاعتراف بأن أي نظرية مؤقتة بطبيعتها. لكن حين تتحول النظرية إلى هوية والمنهج إلى يقين مغلق، تظهر متلازمة العقل الذي يعرف كل شيء. وفي هذه الحالة لا يعود السؤال: ما الذي لا نعرفه؟ بل: كيف نُجبر الظاهرة على أن توافق ما نعرفه؟ وهنا يختلط الدفاع النفسي بالتحليل العلمي، ويُقنَّع الخوف من المجهول بلغة المعادلات والتصنيفات.
تقترح هذه المقالة أن التقدم الحقيقي لا يبدأ بتراكم التفسيرات، بل بإحياء فضيلة مهجورة في تاريخ الفكر، وهي الاستعداد الدائم للإقرار بالعجز عن تقديم تفسير صائب للظاهرة أو التجربة المراد تفسيرها. فالعجز هنا ليس نقصاً، بل موقفاً منهجياً، وهو يتمثل في تعليق الحكم عند غياب الأدلة الكافية وقبول إمكان وجود متغيرات غير مكتشفة والفصل بين التفسير المرجّح والتفسير النهائي ومقاومة الإغراء النفسي لملء الفراغ بأي سردية جاهزة. إن “لا أدري” ليست نهاية العلم، بل شرطه الأول.
يتبين لنا، وبتدبر ما تقدم، ان “عامل الرجل الثالث”، سواء فُسِّر تفسيراً عصبياً أو نفسياً أو غير ذلك، يكشف عن شيء أعمق من الظاهرة ذاتها متمثلاً في قلق العقل حين يقف على تخوم ما لا يفهمه. ومتلازمة العقل الذي يعرف كل شيء ليست علامة تفوق حضاري، بل علامة مرحلة انتقالية في وعي الإنسان، مرحلة يتعلم فيها ببطء شديد، أن الاعتراف بحدود العقل قد يكون أعلى أشكال العقلانية.
