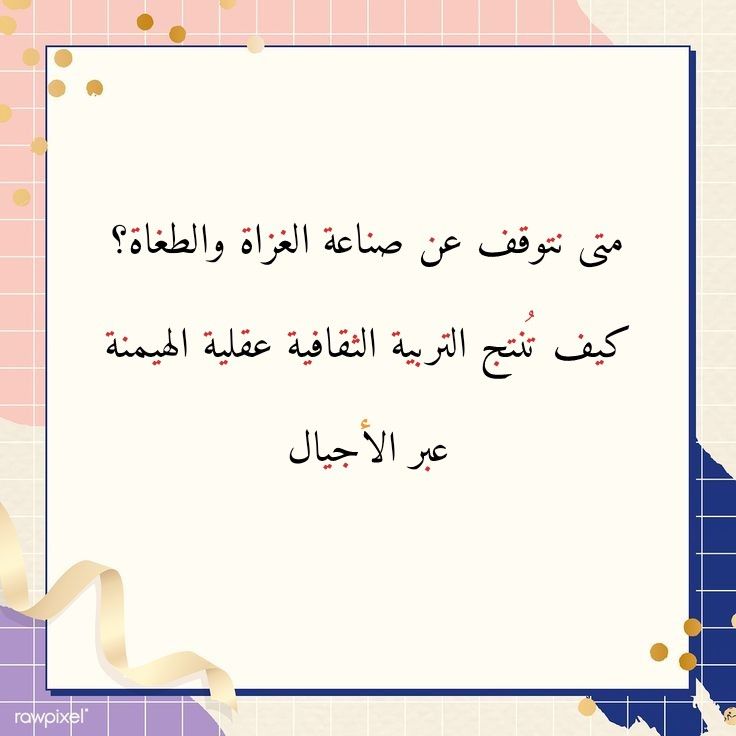
ليست الحروب الكبرى في التاريخ حوادث معزولة، ولا الطغاة استثناءات بايولوجية نادرة تظهر فجأة من الفراغ. بل تشير القراءة السوسيولوجية-النفسية لمسار الحضارات إلى حقيقة مقلقة مفادها أن الغزاة والطغاة غالبًا ما يُصنَعون قبل أن يحكموا؛ يُصنَعون في الأسرة والمدرسة وبواسطة كتب التاريخ والحكايات الشعبية والخطاب الثقافي الذي يُلقَّن للأطفال بوصفه أمجادًا قومية لا يجوز مساءلتها. فالطفل لا يولد وهو يحلم بأن يغزو العالم؛ لكنه يتعلم، منذ سنواته الأولى، أي الشخصيات تستحق الإعجاب، وأي الصفات تُقدَّم باعتبارها نموذجًا للنجاح، وأي أنماط القوة يُحتفى بها بوصفها قمة الإنجاز الإنساني. وحين تُقدَّم شخصيات مثل الإسكندر المقدوني ويوليوس قيصر وجنكيز خان وهولاكو وتيمورلنك وأتيلا ونابليون بونابرت وكريستوفر كولومبوس، وغيرهم كثير، في صورة أبطال استثنائيين دون التوقف الجاد عند الكلفة البشرية الهائلة لغزواتهم، فإن الرسالة التي تتسلل إلى وعي الناشئة ليست محايدة، بل إن العظمة تقاس بالحروب والمعارك، وأن الخلود التاريخي يُنال عبر أدوات القتال وأن الخراب يمكن إعادة تسميته “صناعة المجد”. فالتنشئة الأسرية والمجتمعية تلعب دورًا مركزيًا في تشكيل ما يمكن تسميته “خيال السلطة” لدى الأطفال: ذلك الإطار الذهني الذي يحدد لهم ما الذي يستحق السعي، وما الذي يمنح الاعتراف الاجتماعي. فحين يسمع الطفل مرارًا قصص القادة الفاتحين بصيغة الإعجاب الخالص، وحين تُختصر سيرهم في عبقريتهم العسكرية دون ذكر المدن التي دُمِّرت والمجتمعات التي أُبيدت والملايين الذين قُتلوا وشُرِّدوا، فإن الذاكرة الأخلاقية تُفرَّغ تدريجيًا من مضمونها النقدي. وبذلك يتحول التاريخ، في هذه الحالة، من مادة للفهم إلى مختبر لإعادة إنتاج الطموحات الإمبراطورية. صحيح أن هكذا تنشئة لن ينتج عنها بالضرورة وجوب أن يصبح كل طفل طاغية في المستقبل، لكنها تزرع في اللاوعي الجمعي قابلية مستمرة لتبرير التوسع وتقديس القوة والنظر إلى الآخر بوصفه مادة خام لمشاريع المجد.
إن الخطر الأكبر لا يكمن في تدريس التاريخ العسكري، بل في طريقة سرده. فحين يُروى على أنه سلسلة من الانتصارات المجردة من ضحاياها، يتحول العنف إلى أداة طبيعية لتحقيق الغايات الكبرى. وحين يُفصل القائد عن النتائج الإنسانية لأفعاله، يُعاد تعريف الطغيان بوصفه “حزمًا”، والاحتلال بوصفه “عبقرية استراتيجية”، والدمار بوصفه “ضرورة تاريخية”. وهنا يبدأ التطبيع الثقافي مع فكرة أن السيطرة قدر، وأن الشعوب لا تتقدم إلا عبر سحق غيرها. فكثيرٌ من الكوارث التي شهدها القرن العشرون، والتي أودت بحياة عشرات الملايين، لم تولد في غرف العمليات العسكرية، بل في كتب مدرسية وخطابات قومية وأساطير وطنية تم ضخها في أذهان أجيال متعاقبة حتى بدت الحروب امتدادًا طبيعيًا لـ“حق تاريخي” أو “رسالة حضارية”.
وهنا يحق لنا أن نتساءل: كم كان يمكن للعالم أن يصبح مختلفًا لو أن التربية البشرية احتفت بالعلماء بدل الدكتاتوريين الغزاة، وببناة السلام بدل صانعي الإمبراطوريات، وبمن خففوا معاناة البشر بدل من أولئك الذي زادوها؟
كم من المدن كان يمكن أن تُبنى بدل أن تُهدم؟
وكم من العقول كان يمكن أن تُزهر بدل أن تُدفن في ساحات القتال؟
هذه الأسئلة ليست رومانسية، بل تحليلية-منطقية بامتياز: فالمجتمعات التي تغيّر نماذج القدوة التي تقدمها لأطفالها تغيّر مستقبلها الاستراتيجي، ومستقيل غيرها من المجتمعات على المدى البعيد.
إن التحدي الحقيقي الذي يواجه الحضارة المعاصرة ليس في منع نشوء الطغاة بالقوة، بل في تجفيف منابعهم الثقافية قبل أن يظهروا. ويبدأ ذلك عبر تدريس التاريخ بوصفه مجالًا للمساءلة لا للتقديس وتقديم صورة كاملة للشخصيات الكبرى تتضمن إنجازاتها والكوارث التي تسببت بها معًا وترسيخ قيم المسؤولية الأخلاقية بدل عبادة القوة المجردة والاحتفاء بمن خدموا الإنسان لا بمن أخضعوه لأهوائهم واسترضاءً لغرورهم الذي لا يشبع. فالبطولة ليست في عدد الأراضي التي ضُمَّت، بل في عدد الأنفس التي أَحيت. وليست في اتساع الإمبراطوريات، بل في اتساع دائرة العدل والقسط.
إن السؤال: “متى نتوقف عن صناعة الغزاة والطغاة؟” هو ليس اتهامًا للتاريخ، بل مساءلة للحاضر. فما دام الأطفال يُربَّون على الحلم بأن يكونوا “نسخة ثانية” من طاغية قديم، بدل أن يكونوا مبتكرين أو مصلحين أو بناة سلام، فإن عجلة العنف ستظل تجد من يديرها ويجعلها لا تكف عن الدوران. فالتحول الحقيقي يبدأ حين نُعيد صياغة المخيلة الجماعية للأجيال القادمة، وذلك حين يصبح المجد مرادفًا للحكمة، والقوة مرادفة للمسؤولية، والعظمة مرتبطة بحماية الحياة لا بتدميرها.
