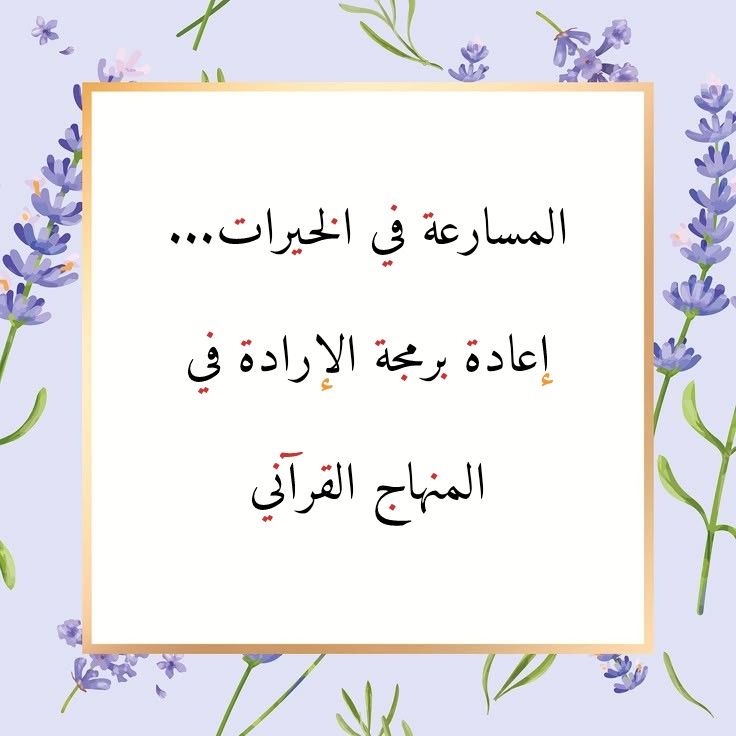
لا يقدّم القرآن الكريم منظومة أخلاقية خطابية مجردة، بل يبني، على نحوٍ منهجي، هندسة دقيقة للسلوك الإنساني، تنطلق من تشخيص واقعي لبنية النفس وما يعتريها من نزعات التأجيل والتراخي والتحايل على التكليف. فالوحي لا يخاطب الإنسان كما ينبغي أن يكون فقط، بل كما هو بالفعل: كائنًا ممزقًا بين إدراك الخير ومقاومة كلفته. وفي هذا السياق، تتكرّر في الخطاب القرآني أوامر ذات طابع زمني-إرادي واضح: “فاستبقوا الخيرات” و “سابقوا إلى مغفرة من ربكم” و “وسارعوا إلى مغفرة من ربكم”. وهذه الأفعال الثلاثة لا تمثل تنويعًا لغويًا فحسب، بل تشكّل نسقًا تربويًا تصاعديًا: فالاستباق هو المبادرة قبل تشكّل التردد، والمسابقة هي إدراك أن الفرصة محدودة وأن الزمن عنصر حاسم، والمسارعة هي كسر بطء النفس وميلها البنيوي إلى التسويف.
إن هذا التركيز على سرعة الاستجابة الأخلاقية يكشف عن إدراك قرآني عميق لطبيعة المقاومة الداخلية التي تواجه القرار الصالح. فالنفس، بحسب توصيف القرآن، ليست حيادية، بل تملك أدوات دفاعية تحفظ بها سلطتها على صاحبها تتمثل في التسويف والتبرير والمجادلة وتأجيل الحسم حتى تفرغ العزيمة من طاقتها الأولى. من هنا يمكن فهم المسارعة بوصفها تقنية إلهية لضبط الزمن النفسي؛ إذ يُطلب من الإنسان أن ينفّذ فعل الخير قبل أن تدخل آليات “الممانعة النفسية” في طورها الكامل. فالقرار الأخلاقي في القرآن لا يُترك معلقًا في الفراغ الإدراكي، بل يُستثمر في لحظة صفائه الأولى، حيث تكون الإرادة في ذروة قدرتها على الحسم.
ينطلق المشروع الميتابايولوجي من فرضية أن الإنسان، بعد التحويلة الوجودية الأولى، دخل في طورٍ من الاختلال البنيوي في علاقته بذاته ورغباته، بحيث بات يميل إلى السلامة الآنية على حساب الترقي الأخلاقي، وإلى الراحة على حساب المجاهدة، وإلى التأجيل على حساب اتخاذ القرار. ضمن هذا الإطار، تبدو أوامر المسارعة القرآنية جزءًا من برنامج علاجي طويل المدى لإعادة تشكيل هذه البنية المنحرفة. فالمنهاج الإلهي، بطبيعته، يصطدم بالنفس لأنه يدعوها إلى ما تكره: الانضباط والتضحية وتجاوز الهوى ومقاومة الإغراء الآني. ولذلك فإن النفس، ما لم تُواجَه، ستستثمر كل ما لديها من أدوات لإفراغ التكليف من فعاليته. ولهذا لا يُمتدح في القرآن مجرد فاعلي الخير، بل أولئك الذين يبادرون إليه بلا إبطاء، كما في وصف الفئة القليلة التي يتميز افرادها بأنهم: {يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ} ((114) آل عمران).
فهنا تُرسم ملامح فئة من أولي العزم وذوي الهمة داخل الجماعة البشرية: أفراد خاضوا صراعًا داخليًا مع النفس وانتصروا في معركة التوقيت. لم ينتظروا حتى تضعف العزيمة، ولم يسمحوا للنفس بإطالة زمن التردد حتى تتحول الطاعة إلى عبء مؤجّل.
إن أحد الابتكارات المفهومية التي يكشف عنها هذا التحليل هو أن الزمن في القرآن ليس عنصرًا محايدًا؛ بل يدخل في بنية المسؤولية الأخلاقية ذاتها. فالتأجيل ليس مجرد ضعف عرضي، بل قد يتحول إلى خطيئة بنيوية حين يصبح آلية دائمة لتعطيل العمل الصالح. وعليه، فإن المسارعة ليست فضيلة عاطفية أو اندفاعًا غير محسوب، بل تدريبٌ منهجي على “اقتصاد الإرادة”، أي إدارة الطاقة الأخلاقية المحدودة قبل أن تُستنزف بالجدل الداخلي والتبرير العقلي. وبهذا المعنى، يعمل الوحي على إعادة هندسة القرار البشري عبر:
1. تقليص المسافة الزمنية بين الإدراك والتنفيذ.
2. تحييد آليات النفس الدفاعية قبل اكتمالها.
3. تحويل المبادرة إلى عادة وجودية.
4. إعادة برمجة الدماغ الأخلاقي على تجاوز إنحيازاته التطورية نحو الراحة والسلامة.
لا يقتصر أثر هذا النسق على تزكية الفرد، بل يمتد، وفقاً للمقاربة الميتابايولوجية، إلى تشكيل المجتمعات القادرة على النهوض. فالأمم التي تتراكم داخلها ثقافة التأجيل والبحث عن الأعذار وانتظار اللحظة المثالية، هي أمم تدخل طور الجمود الحضاري. أما الجماعات التي تُدرِّب أفرادها على المبادرة وتحمل الكلفة وكسر الإغراءات الآنية، فهي التي تمتلك قابلية الاستمرار التاريخي.
وهكذا تتحول المسارعة في الخيرات من توجيه تعبدي محدود إلى أداة بنيوية في بناء الحضارة: تقنية قرآنية لصناعة الإرادات الصلبة، القادرة على مقاومة الانحراف الداخلي قبل مواجهة التحديات الخارجية.
