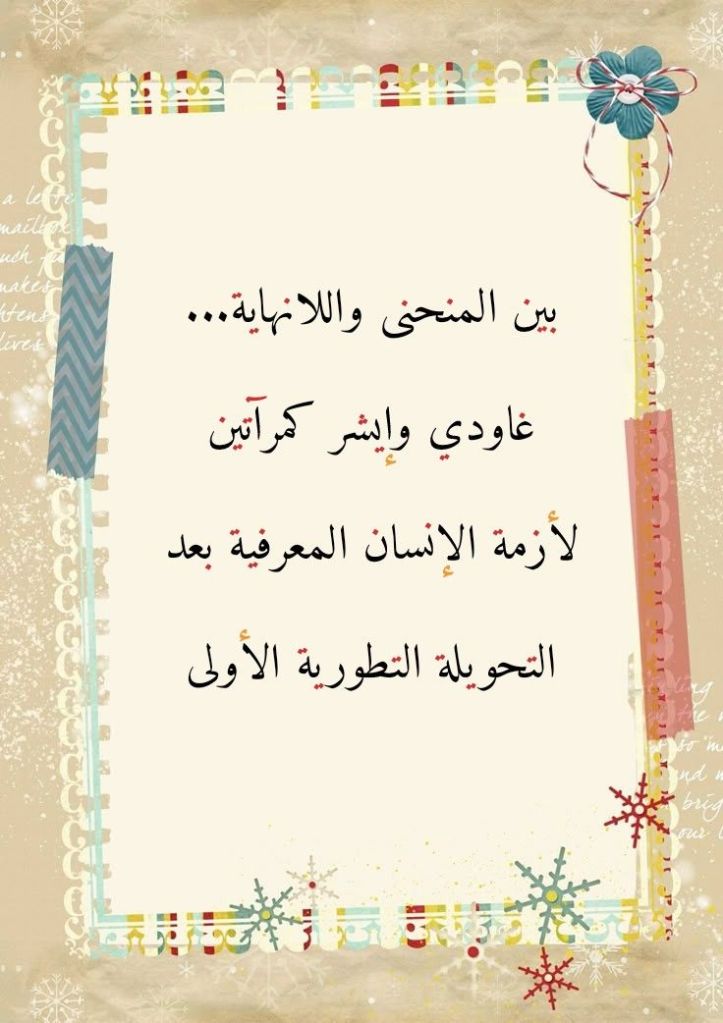
يبدو الإنسان، منذ بداياته الأولى، مولعًا بالخط المستقيم لما يمثله من طريق واضح، بناء منتظم، هندسة يمكن ضبطها بالمسطرة والزاوية القائمة. غير أنّ الطبيعة التي تحيط به لا تشاركه هذا الولع؛ فهي عالمٌ من التعرّجات والتموجات والحلزونات والتفرعات والانثناءات التي لا تنتهي. فالجبال والسواحل والأغصان والأصداف والأوعية الدموية في الجسم البشري، كلها تقول بصمتٍ صارخ: إن الاستقامة استثناء، والانحناء هو القاعدة.
في هذا التوتر بين ميل الإنسان إلى الخط المستقيم وهيمنة المنحنى في الطبيعة، يمكن قراءة مشروعين فنيين استثنائيين: مشروع المعماري الكاتالوني أنطونيو غاودي، ومشروع الفنان الهولندي إيشر. كلاهما لم يكتب أطروحة فلسفية عن أزمة الإنسان الإدراكية، لكن أعمالهما، من حيث لا يدريان، تحوّلت إلى تشخيص بصري عميق لاضطراب ما بعد “التحويلة التطورية الأولى”: تلك اللحظة التي صار فيها الإنسان كائنًا قلقًا، متعثّر المسار، مشتبك الحواس، يبحث عن “الخط المستقيم” ولا يجده إلا بوصفه وعدًا مفارقًا للطبيعة وليس واقعًا أرضيًا.
ففي عمارة غاودي لا نجد الخطوط الحادة ولا الواجهات المسطّحة الصارمة إلا نادرًا. فكل شيء يبدو وكأنه نُحِت لا بيد مهندس بل بيد جبلٍ حيّ أو موجة بحرٍ متجمّدة في لحظة اندفاع. فالأعمدة تميل والأسقف تتقوّس والواجهات تتنفس كما لو كانت جلدًا عضويًا. إن غاودي لا يبني “ضد الطبيعة” بل يحاكي منطقها الداخلي. غير أنّ هذا الانغماس في المنحنى لا يمكن قراءته كمجرد تقليد شكلي للطبيعة. ففي ضوء المقاربة الميتابايولوجية، يمكن النظر إلى هندسة غاودي بوصفها اعترافًا غير معلن بعجز الإنسان عن شق طريق مستقيم في الوجود. فالمنحنى هنا ليس زينة جمالية؛ بل هو صورة لمسار بشري ملتف ومتعرج ولا يبلغ غايته إلا بعد انكسارات متكررة. إن غاودي يشيّد عالَمًا معماريًا يقول، وبصمتٍ حجري، إن الإنسان بعد التحويلة التطورية الأولى لم يعد قادرًا على إقامة نظام صافٍ متوازن من صنعه الخاص. فكل محاولة للاستقامة تنتهي بالميلان، وكل هندسة صارمة تتداعى أمام فيزياء الحياة العضوية التي تسكن المادة ذاتها. ومن هذه الزاوية، يغدو المنحنى الغاودي رمزًا لضعف خلقيّ بنيوي؛ وهو ضعف يجعل الإنسان محتاجًا إلى “صراط مستقيم” لا يخرجه من عنده، بل يأتيه من نظام أعلى يتجاوز هشاشته العصبية–الوجودية. فالطبيعة نفسها، التي يعيد غاودي نحتها بالحجر، تعلن أن الاستقامة المطلقة ليست قانون الأرض، بل وعد من خلق الأرض والسماء.
فإذا كان غاودي قد فضح عجز الإنسان البنيوي عن الاستقامة عبر المنحنى، فإن إيشر يذهب خطوة أبعد؛ حيث أنه ينسف ثقة الإنسان بحواسه ذاتها، فسلالم تصعد وتهبط في الوقت نفسه وشلالات تتدفّق إلى الأعلى وعوالم مغلقة بلا بداية ولا نهاية وأيدٍ ترسم نفسها بنفسها. فالعمارة عند إيشر تبدو واقعية إلى حدّ الخداع، لكنها، ما إن نتأملها تنقلب إلى مصائد إدراكية تكشف هشاشة الجهاز الحسي–العقلي الذي نعتمد عليه لفهم العالم. وهنا لا يعود الخط المستقيم خلاصًا؛ بل يصبح أداة خداع. فما تراه العين ليس بالضرورة ما هو موجود، وما يحسبه العقل ممكنًا قد يكون بناءً وهميًا متماسكًا من الداخل لكنه مستحيل فيزيائيًا في الخارج.
ومن منظور ميتابايولوجي، تشكّل هذه الأعمال تشخيصًا بصريًا لنتائج التحويلة التطورية الأولى على مستوى الإدراك؛ حيث أن الدماغ البشري، وقد انفصل عن توازنه البدئي، صار قادرًا على تشييد عوالم كاملة من الوهم المنطقي. منطق داخلي متقن، لكن بلا مرجعية واقعية نهائية. كأن إيشر يقول: لا تثق كثيرًا بقدرة الحواس على قيادة الإنسان إلى الحقيقة، فهذه الحواس نفسها صارت جزءًا من المشكلة.
وعلى الرغم من اختلاف الوسيط، عمارة عند غاودي ورسوم طباعية عند إيشر، فإن الاثنين يعالجان الجرح نفسه:
• غاودي يعرض تعثر المسار، فالإنسان يسير في عالم منحني لا يستطيع أن ينتج استقامة نهائية من داخله.
• إيشر يعرض ارتباك البوصلة، فالإنسان يرى عوالم تبدو حقيقية لكنها ليست كذلك.
فالأول يركّز على تشوّه الطريق. والثاني على تشوّه الرؤية. وكلاهما، من حيث لا يقصد، يضعنا أمام إنسان عاجز عن بلوغ الحقيقة بمفرده؛ إذ أنه لا يستطيع أن يرسم خطه المستقيم، ولا يملك حواسًا يمكن الاطمئنان إليها بلا قيد. ففي هذه القراءة، يصبح الفن عند الاثنين شهادة غير واعية على الأزمة الوجودية لما بعد التحويلة التطورية الأولى: أزمة الكائن الذي خرج من انسجامه البدئي مع نظام المعنى، فصار يتخبط بين الطبيعة التي لا تعرف الاستقامة، والعقل الذي يصنع أوهامًا متقنة تشبه الحقيقة.
يتبين لنا، وبتدبر كل ما تقدم، أن غاودي لم يكن واعيًا بأنه يرسم صورة الإنسان المتعثر، ولا إيشر كان يقصد صياغة بيان ميتابايولوجي عن خداع الإدراك. غير أن عبقرية الفن تكمن هنا تحديدًا؛ إذ أنه يسبق النظرية ويشخّص ما لم يتم صياغته بعد في لغة المفاهيم. فالمنحنيات الغاودية واللانهايات الإيشرية ليست مجرد ألعاب جمالية؛ بل إشارات إلى مأزق معرفي عميق بإمكاننا أن نعرفه بهذه الكلمات: الإنسان كائن يبحث عن طريق مستقيم في عالم من الانحناءات، ويحاول أن يثق بحواسه في عالَم قادر على خداعه حتى العظم. ومن هنا يغدو فنهما، كلٌ بطريقته، تذكيرًا صامتًا بأن الخلاص المعرفي والوجودي لا يُستخرج من داخل البنية البشرية، بل يحتاج إلى معيار أعلى يعيد ضبط الاتجاه ويكشف الوهم ويقيم ميزان الاستقامة في عالم لا يعرف إلا التعقيد.
