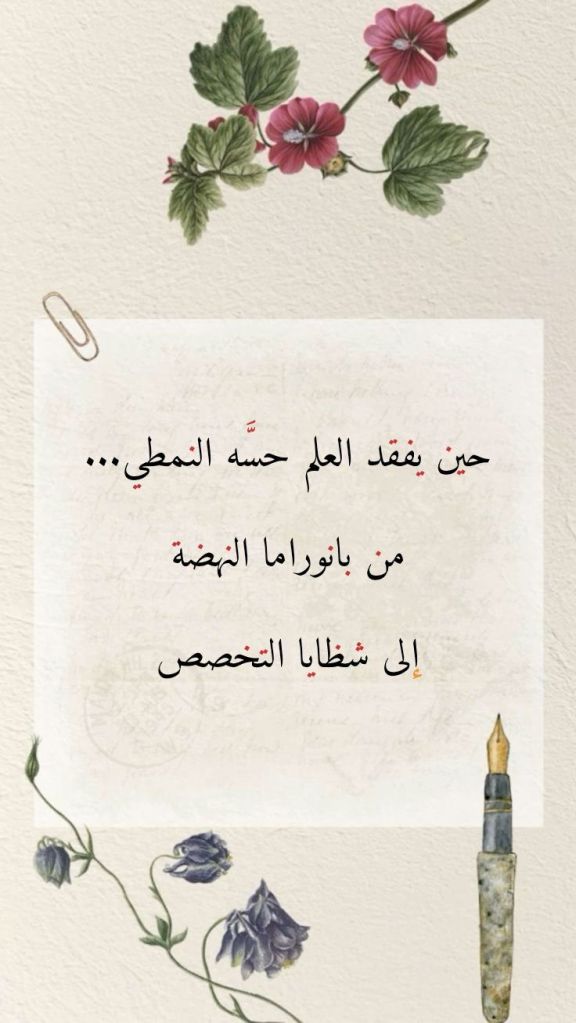
منذ انبثاق الثورة العلمية في عصر النهضة، تشكّلت إحدى أعظم فضائل المنهج العلمي حول قدرة العقل على التقاط الأنماط الكامنة خلف تشابك الظواهر. فلم يكن التقدّم العلمي ثمرة تراكم معزول للوقائع، بل نتيجة جرأة معرفية سعت إلى تجاوز التفاصيل المتناثرة نحو البُنى العميقة التي تنتظمها؛ على سبيل المثال: قوانين الحركة عند نيوتن، أو انتظامات الوراثة لدى مندل، أو البنى الذرية في الفيزياء الحديثة، أو علاقات التطور في البايولوجيا. لقد ازدهر العلم حين كان ينظر إلى الطبيعة بوصفها نسيجًا مترابطًا، لا مجرد أرخبيل من الوقائع الجزئية.
غير أن المشهد المعرفي المعاصر يشهد تحوّلًا مقلقًا. فمع التضخم الهائل في عدد التخصصات، والتعقيد التقني الذي بات يطبع كل حقل، أخذت القدرة على الإمساك بالصورة الكلية في التآكل التدريجي. فصار الباحث يغوص عميقًا في تفاصيل شجرة بعينها أو جين مفرد أو خوارزمية دقيقة أو بروتين واحد أو نموذج مناخي جزئي، بينما تتوارى “الغابة” التي تمنح تلك العناصر معناها الأشمل. وهكذا بدأ العلم، على نحو مفارق، يخسر إحدى أعزّ أدواته التاريخية والمتمثلة بالحس البنيوي القادر على التمييز بين النمط الحقيقي والنمط الزائف.
لا يُنكر أحد أن التخصص الدقيق كان محرّكًا حاسمًا للإنجازات الحديثة. غير أن ما كان في الأصل وسيلة للضبط والصرامة صار، في بعض تجلياته، قيدًا إبستمولوجيًا. فحين ينغلق كل حقل داخل لغته الخاصة ونماذجه الرياضية ومعاييره التجريبية الضيقة، تتضاءل فرص الحوار العابر للتخصصات؛ ذلك الحوار الذي طالما أتاح للعلم اكتشاف انتظامات عليا تتجاوز الحدود الاصطناعية بين الفيزياء والكيمياء، أو بين البايولوجيا والأنثروبولوجيا، أو بين علم الأعصاب وعلم الاجتماع.
إن أخطر ما في هذا الانفصال لا يتمثل في فقدان الرؤية الشمولية فحسب، بل في تزايد قابلية العقل العلمي لاختراع أنماط وهمية. فحين يُقرأ جزء من الواقع بمعزل عن السياق الأشمل الذي نشأ فيه، يسهل تضخيم ارتباطات عارضة، أو تحويل مصادفات إحصائية إلى قوانين، أو تأويل اتجاهات جزئية بوصفها مسارات كونية حتمية. عندئذٍ لا يعود العلم مكتشفًا للأنماط بقدر ما يغدو منتجًا لها، وفق شروط النماذج الحاسوبية، أو قيود التمويل البحثي، أو نزوات السوق التقنية.
ليس هذا التحذير شأنًا أكاديميًا داخليًا فحسب. فالأنماط التي يعتمدها العلم اليوم تُسهم مباشرة في صياغة السياسات البيئية والاستراتيجيات الطبية والنظم الاقتصادية ورؤى المستقبل التقني. فإذا كانت هذه الأنماط مشوّهة أو مبتورة، فإن قرارات الحضارة ذاتها ستُبنى على أرض معرفية رخوة.
إن تجاهل البنى الكبرى، كالتفاعلات المعقّدة بين النظم البيئية، أو الترابطات النفسية-الاجتماعية في السلوك البشري، أو الآثار غير الخطية للتكنولوجيا، قد يقود إلى حلول موضعية تولّد أزمات أعقد. يُعالَج عرضٌ فيولد مرضٌ أعمق؛ تُسدّ فجوة فتفتح هوّة أخرى. وهكذا يتسلل الوهم التقدّمي إلى قلب المشروع العلمي؛ حيث تراكم للمعرفة دون حكمة تركيبية، وزيادة في القدرة التقنية يقابلها تراجع في الفهم الكلي.
إن مستقبل العلم، ومن خلفه مستقبل الإنسان والعالم، يتوقف إلى حد بعيد على استعادة هذا البعد البنيوي المفقود المتمثل في الجرأة على التفكير التركيبي، والقدرة على مساءلة النماذج الجزئية في ضوء الصورة الكبرى، والانفتاح على المقاربات العابرة للتخصصات. فالعلم الذي يتخلى عن حسه النمطي يفقد بوصلته التاريخية التي جعلته أعظم أدوات البشر لفهم الواقع بدل الاكتفاء بإدارته تقنيًا.
لسنا اليوم بحاجة إلى تقليص التخصص، بل إلى تعليمه كيف يرى نفسه جزءًا من لوحة أشمل؛ كيف يربط الجزيء بالمنظومة، والخلية بالمجتمع، والخوارزمية بالإنسان، والتجربة الموضعية بمصير الكوكب. وحده هذا الوعي التركيبي قادر على منع انجراف العقل العلمي نحو هندسة أنماط مصطنعة قد تبدو دقيقة رياضيًا، لكنها فقيرة وجوديًا وتفسيريًا.
لقد علّمنا تاريخ العلم أن أعظم القفزات المعرفية لم تولد من تكديس الوقائع، بل من اكتشاف العلاقات الخفية بينها. فإذا تخلى العلم المعاصر عن هذا الإرث، واكتفى بالغوص العمودي دون أفق أفقي، فإنه يخاطر بأن يتحول من مشروع كشف للحقيقة إلى آلة إنتاج نماذج متزايدة التعقيد ومتناقصة المعنى. إن التحذير اليوم ليس دعوة إلى رفض العلم، بل إلى إنقاذه من ضيق أفقه الجديد، وإلى إعادة توجيهه نحو تلك الرؤية البانورامية التي مكّنته، يومًا ما، من ألا يضيع في تفاصيل الأشجار وهو يتأمل شكل الغابة.
