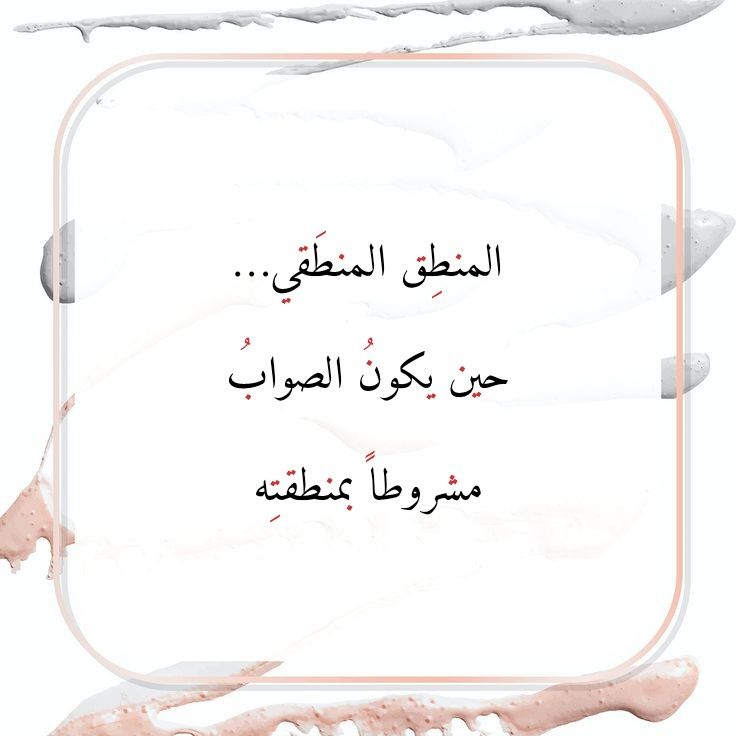
يميل الإنسان، ومنذ بداية تشكُّل التفكير الفلسفي والعلمي، إلى التعامل مع ما يراه منطقيًا بوصفه حقيقة صالحة في كل زمان ومكان، وكأن المنطق يمتلك بطبيعته صلاحية كونية مطلقة، لا تخضع لتبدّل الظروف أو تغيّر الشروط أو اختلاف الأطر التاريخية والمعرفية. غير أن تاريخ الفكر يرينا، عند قراءته قراءة متأنية، أن كثيرًا مما بدا صارمًا عقلانيًا في حقبة ما، أو في سياق بعينه، فَقَد هذا الوصف حين انتقل إلى “بيئة معرفية” مختلفة.
من هنا تقترح هذه المقالة إدخال مصطلح جديد إلى التداول الفلسفي-الإبستمولوجي:”المنطق المنطَقي (regional logic)”، أي المنطق الذي يكتسب صلاحيته من منطقته، زمانًا ومكانًا وظرفًا وشروطًا وإطارًا نظريًا، ولا يملك بالضرورة قابلية العبور الآمن إلى خارجها.
الفرضية المركزية التي تنطلق منها هذه المقاربة هي أن عددًا كبيرًا من النزاعات الفكرية والتناقضات المعرفية لم يكن ليقع لو أدرك البشر أن كثيرًا من أنظمتهم العقلانية ليست مطلقة، بل مشروطة بسياقات نشأتها.
لا يقصد بهذا المفهوم التشكيك في مبدأ العقلانية ذاته، ولا الدعوة إلى نسبوية معرفية فوضوية تساوي بين كل الآراء، بل التمييز بين مستويين:
- المنطق الداخلي: اتساق الفكرة مع مقدماتها وافتراضاتها الخاصة.
- مجال الصلاحية: الإطار الذي تعمل داخله تلك المقدمات أصلًا.
فالمنطق المنطَقي هو ذلك النسق الاستدلالي الذي يكون صحيحًا داخل حدود معينة يتمثل في إطار علمي محدد ومرحلة تاريخية بعينها وشروط تقنية خاصة ومنظومة قيمية أو عقدية معيّنة وبيئة فيزيائية أو اجتماعية مخصوصة. وحين يُنقل هذا المنطق خارج منطقته دون تعديل في افتراضاته، تبدأ التناقضات بالظهور، ويغدو الدفاع عنه ضربًا من تعميم غير مشروع.
وفيما ما يلي أمثلة تاريخية على منطق فقد منطقيته خارج منطقته: - في الفيزياء
لطالما بدت قوانين الحركة الكلاسيكية في نطاق السرعات اليومية والأحجام المألوفة نموذجًا نهائيًا للعقلانية الصارمة. غير أن انتقال البحث إلى مقاييس متناهية الصغر أو سرعات قريبة من الضوء كشف أن ذلك المنطق الفيزيائي كان إقليميًا بامتياز، صحيحًا داخل نطاقه، لكنه غير صالح للتعميم الكوني. فلم يكن الخطأ في العقل ذاته، بل في افتراض أن منطقه المحلي قادر على احتواء كل المستويات. - في الفلسفة
شهد تاريخ الفلسفة دورات متكررة من الاطمئنان إلى منظومات عقلية مكتملة، ثم انهيار يقينها مع تغيّر شروط المعرفة. فما بدا ضرورة عقلية في عصرٍ ما، تحوّل إلى فرضية قابلة للنقض في عصر آخر، لا لأن العقل تخلى عن نفسه، بل لأن منطقته المعرفية تغيّرت. - في التدين والتأويل
ينطبق الأمر ذاته على أنماط التدين العقلاني أو النصي الصارم؛ إذ كثيرًا ما تتحول قراءات نشأت في سياق اجتماعي أو سياسي أو لغوي معين إلى قوانين مطلقة يُراد فرضها على عصور وأمكنة مغايرة جذريًا، فينشأ الاحتكاك والتكفير والصراع باسم ما يُتصوَّر أنه “منطق واحد صحيح”.
تقترح هذه المقالة أن عددًا كبيرًا من الخلافات الكبرى، العلمية والفلسفية والدينية، لا يتمحور حول الصواب والخطأ بقدر ما يتمحور حول تصادم منطقين ينتميان إلى منطقتين مختلفتين. وكل طرف يرى نفسه ملتزمًا بالعقل؛ كيف لا؟ ومقدماته سليمة ضمن سياقه، واستنتاجاته متماسكة داخليًا، وتجربته التاريخية تؤكد له وجاهة طرحه. غير أن الخطأ يبدأ حين يُطالَب الطرف الآخر بالاحتكام إلى منطق لم يولد في بيئته المعرفية. ومن هنا يمكن فهم لماذا يبدو كل معسكر مقتنعًا تمام الاقتناع بأن خصومه يقعون في تناقض فادح، في حين يرى الخصوم الأمر معكوسًا تمامًا.
إذا أُخذ مفهوم المنطق المنطَقي مأخذ الجد، فإنه يفرض تحولًا عميقًا في أخلاقيات الجدل المعرفي، فبدل السؤال: من يملك المنطق الصحيح؟ يصبح السؤال: في أي منطقة يعمل هذا المنطق؟ وما حدوده؟ إن هذا التحول لا يلغي النقد، لكنه يغيّر طبيعته من محاولة الإقصاء إلى اختبار مجال الصلاحية، ومن السعي إلى الإطلاق إلى الاعتراف بالحدود. إلا أنه من الضروري التشديد على أن تبني هذا المفهوم لا يعني قبول كل فكرة بدعوى أنها “منطقية في منطقتها”. فهناك نوع آخر من الأفكار لا ينتمي إلى أي منطقة منطقية معتبرة، وهي أفكار تعاني من تناقض داخلي صارخ، أو تقوم على مقدمات تنقض نفسها بنفسها. وهذه الأفكار لا تندرج تحت المنطق المنطَقي، بل تقع خارج مجال المنطق أصلًا، لأن الحد الأدنى لأي طرح عقلاني هو “الاتساق المنطقي الداخلي”. فالمنطق المنطَقي لا يحمي الفكر من النقد، بل يعيد توجيه النقد من محاولة فرض منطق واحد على الجميع إلى فحص بنيته الاستدلالية وشروطه الخفية وحدوده التطبيقية.
تخلص هذه المقالة إلى أن الاعتراف بإقليمية كثير من أنظمتنا العقلية قد يكون شرطًا أساسيًا لتخفيف حدّة النزاعات المعرفية في عالم يزداد تعقيدًا. فبدل مستقبل حافل بصراعات لا تنتهي حول من يمتلك الحقيقة المطلقة، يفتح مفهوم المنطق المنطَقي أفقًا مختلفًا: عالم يدرك فيه المتحاورون أنهم قد يكونون جميعًا على حق، كلٌ داخل حدوده، وأن الخلل لا يكمن في العقل، بل في طموحه الدائم إلى تجاوز سياقاته الخاصة دون مراجعة مقدماته. إنه انتقال من “عقلٍ إمبراطوري” يريد فرض منطقه على الكون، إلى “عقلٍ تاريخي” يُقر بأن منطقه، مهما بدا صارمًا، ينتمي دائمًا إلى منطقة بعينها فحسب.
