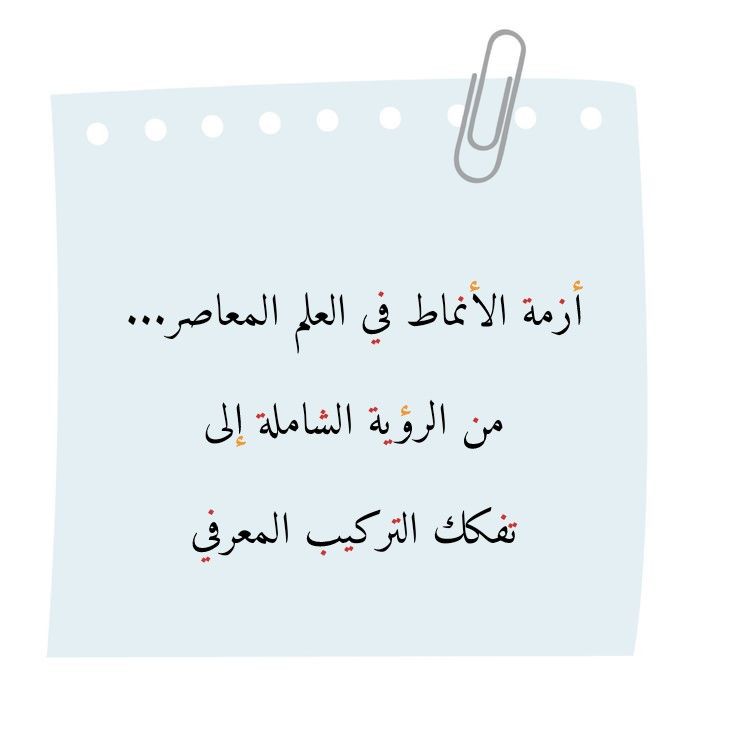
تتناول هذه المقالة التحوّل الذي أصاب المنهج العلمي في علاقته باكتشاف الأنماط الكلية للظواهر، منذ عصر النهضة حتى العقود الأخيرة، حيث أدّى تضخّم التخصصات الدقيقة وتعقّد النماذج التقنية إلى تراجع القدرة التركيبية التي ميّزت العلم الحديث منذ نشأته. وتنطلق المقالة من أطروحة ميتابايولوجية ترى أن هذا التحول لا يمكن فصله عن التاريخ التطوري للعقل البشري منذ “التحويلة التطورية الأولى”، التي أطلقت نزعة النمذجة والتمثيل الرمزي، وما صاحبها من ميل بنيوي إلى تضخيم الثقة الإدراكية. وتخلص المقالة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل مرحلة تكثيفية جديدة لهذه النزعة، بما يستدعي تأسيس إبستمولوجيا تركيبية قادرة على كبح إنتاج “الأنماط الزائفة” قبل أن تتحول إلى بنى تشغيلية تحكم مسار الحضارة.
فلقد شكّل اكتشاف الانتظامات البنيوية في الطبيعة أحد أعمدة المشروع العلمي منذ القرن السادس عشر. فالتقدم المعرفي لم يقم على الوصف الجزئي وحده، بل على إعادة تنظيم الوقائع في صيغة قوانين تسمح بتفسير واسع النطاق والتنبؤ المبدئي. إن القوانين الفيزيائية الأولى، ونماذج الوراثة، وبنى الكيمياء الذرية، جميعها مثّلت انتقالًا من التراكم الوصفي إلى الرؤية التركيبية.
ضمن هذا الإطار، كان التمييز بين “النمط الحقيقي”، بوصفه انتظامًا مستقرًا عابرًا للسياقات الجزئية، و”النمط الزائف”، بوصفه ارتباطًا عارضًا أو إسقاطًا ذهنيًا، شرطًا لازدهار العلم. وقد شكّل هذا التمييز معيارًا ضمنيًا للصرامة المنهجية، يحول دون تحويل المصادفات إلى قوانين أو الاتجاهات المحلية إلى مسارات كونية عامة.
فابتداءً من النصف الثاني من القرن العشرين، تسارع تفريع العلوم إلى حقول فرعية عالية التقنية، لكل منها لغتها الخاصة، وأطرها الرياضية، وأدواتها الإجرائية. وقد أسهم هذا التخصص في إنجازات دقيقة غير مسبوقة، إلا أنه في الوقت ذاته أعاد تشكيل البنية المعرفية للعلم بطريقة حدّت من إمكان إنتاج سرديات تفسيرية شاملة.
إن المشكلة لا تكمن في التخصص ذاته، بل في تحوّله من أداة إبستمولوجية إلى أفق إدراكي مغلق. فحين تُقرأ الظواهر حصريًا من خلال عدسة جزيئية واحدة، سواء كانت جينية أو عصبية أو اقتصادية أو خوارزمية، يتزايد خطر اختزال الواقع إلى ما تسمح به النماذج المحلية، وتغدو الصورة الكلية نتاج جمع آلي لنتائج غير متجانسة بدل أن تكون تركيبًا بنيويًا عالي المستوى. وفي هذا السياق، يبرز مفهوم “الأنماط الزائفة” لا بوصفه خطأً تجريبيًا عابرًا، بل كنتيجة بنيوية لانفصال الحقول عن سياقاتها الكلية. فالنموذج الجزئي، حين يُعمَّم خارج شروطه، يتحول من أداة تفسير إلى مولِّد لـ “الوهم المعرفي”.
وفق المقاربة الميتابايولوجية، تمثل “التحويلة التطورية الأولى” اللحظة التي انتقل فيها الإنسان من استجابة بايولوجية مباشرة للبيئة إلى بناء عالم رمزي ثانٍ يتكوّن من اللغة، والتصنيف، والتمثيل السببي. وقد أطلقت هذه النقلة قدرة غير مسبوقة على اكتشاف الانتظامات، لكنها في الوقت ذاته زرعت ميلًا بنيويًا إلى فرض الخرائط الذهنية على الواقع. وبهذا المعنى، لا تُعد أزمة الأنماط في العلم المعاصر انحرافًا تاريخيًا طارئًا، بل تجليًا متأخرًا لبنية إدراكية قديمة تتمثل في عقل تطوّر لرصد الانتظامات بسرعة لأغراض البقاء، ثم حوّل هذه القدرة إلى جهاز معرفي شامل قد يخلط بين “الكشف” و”الإسقاط”. ويندرج وصف “الغرور المعرفي” ضمن هذا السياق التطوري، وذلك من حيث كونه نزعة إلى التعامل مع النماذج بوصفها مرايا مكتملة للواقع بدل كونها تمثيلات مؤقتة قابلة للمراجعة.
والآن، إذا كانت التحويلة التطورية الأولى قد دشّنت “العقل النمذجي”، فإن التخصص المعاصر يمكن قراءته بوصفه مرحلة متقدمة من تاريخه. فالتقسيم الحاد للمعرفة إلى وحدات دقيقة يضاعف من كفاءة التحليل الموضعي، لكنه في المقابل يضعف القدرة على إعادة تركيب هذه الوحدات في بنى تفسيرية شاملة. وينشأ عن ذلك وضع إبستمولوجي يتسم بـ:
1. وفرة النماذج الجزئية عالية الدقة.
2. تضاؤل الأطر التركيبية العابرة للتخصصات.
3. ازدياد الاعتماد على مؤشرات كمية معزولة عن سياقاتها الأنثروبولوجية والبيئية والأخلاقية.
وفي هذا الوضع، لا يغيب النمط الكلي فحسب، بل يُستعاض عنه بأنماط مشتقة من قيود البيانات نفسها، لا من بنية الظاهرة في اكتمالها.
إن الذكاء الاصطناعي، في هذا الأفق التحليلي، يمثل مرشحًا قويًا لما يُسمّى “التحويلة التطورية الثانية”. فهذه النظم تقوم جوهريًا على استخراج انتظامات إحصائية عالية الأبعاد، أي على ممارسة آلية لاكتشاف الأنماط تفوق قدرة الإنسان الفردية. غير أن هذه القدرة لا تُنهي خطر الأنماط الزائفة، بل قد تعمّمه. فحين تُدمج النماذج الخوارزمية في أنظمة القرار الطبي، والاقتصادي، والبيئي، والسياسي، تتحول الأخطاء الاحتمالية أو الانحيازات البنيوية في البيانات إلى قوى تشغيلية واسعة النطاق. فتنتقل الأزمة هنا من مستوى الخطأ المعرفي إلى مستوى الهندسة الحضارية، إذ يمكن لنمط إحصائي محدود أن يُعاد إنتاجه مؤسسيًا بوصفه حقيقة تشغيلية تحكم توزيع الموارد، أو إدارة المخاطر، أو رسم السيناريوهات المستقبلية.
تقترح هذه المقالة أن مواجهة أزمة الأنماط لا تمر عبر مزيد من الأدوات الحسابية وحدها، بل عبر تأسيس إبستمولوجيا تركيبية تقوم على إخضاع النماذج الجزئية لاختبارات فلسفية وأنثروبولوجية وأخلاقية مرافقة، وإعادة الاعتبار للسياق الكلي للظواهر بوصفه عنصرًا تفسيرياً لا ملحقًا ثانويًا، والتعامل مع الأنماط باعتبارها أدوات مؤقتة لا بنى ميتافيزيقية نهائية، وبناء مؤسسات بحثية تشجّع العمل العابر للتخصصات لا مجرد تجاورها الإداري.
يتبين لنا، وبتدبر كل ماتقدم، أن أزمة الأنماط في العلم المعاصر ليست مجرّد خلل تقني في تنظيم البحث، بل امتداد لمسار تطوري طويل للعقل البشري بدأ بالتحويلة التطورية الأولى ويبلغ اليوم عتبة جديدة مع الذكاء الاصطناعي. وهنا يبرز السؤال المركزي: هل يستطيع الإنسان، وقد تضخّمت قدرته على اكتشاف الأنماط خوارزميًا، أن يطوّر في الوقت ذاته وعيًا إبستمولوجيًا قادرًا على كبح نزعة تحويل النماذج إلى مصائر؟
