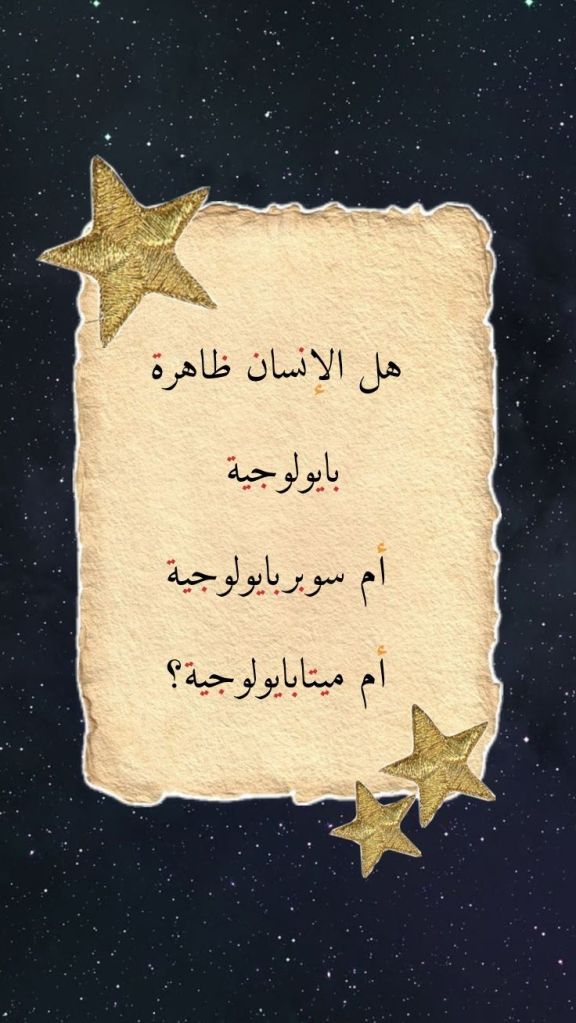
منذ نشأة العلم الحديث ظلّ سؤال ماهية الإنسان يُعالَج داخل الإطار نفسه الذي صيغت فيه بقية ظواهر الطبيعة، والمتمثل في إطار البايولوجيا التطورية. فالإنسان، بحسب هذا التصور، ليس سوى كائن حي معقّد، تخضع بنيته وسلوكه وتاريخه لنفس القوانين التي تضبط بقية الكائنات: الانتخاب الطبيعي والتكيّف والصراع على البقاء والاقتصاد الطاقي للكائن الحي.
غير أن هذا التعريف، رغم نجاحه في تفسير أجزاء واسعة من وظائف الجسم البشري، واجه دائماً صعوبة بنيوية حين حاول تفسير الظاهرة الإنسانية بوصفها كلّاً متكاملاً. فكلما توسّع العلم في دراسة الإنسان، ازداد عدد الظواهر التي لا تتصرف كما تتصرف الكائنات الحية الأخرى؛ ظواهر مثل: اللغة والمعنى والأخلاق والتضحية والرمزية والحضارة والعلم نفسه. وهنا ظهر الاضطرار إلى ترميم النموذج البايولوجي بمفهومٍ إضافي: الإنسان كائن “فوق-بايولوجي” (Super-Biological). لكن هل يكفي ذلك؟
ولكن، لماذا لا يكفي التفسير البايولوجي؟ إن التفسير البايولوجي يقوم على مبدأ أساسي مفاده أن السلوك هو امتداد للوظيفة الحيوية؛ أي أن ما يفعله الكائن الحي يخدم بقاءه وتكاثره بصورة مباشرة أو غير مباشرة. غير أن الإنسان يقدّم ظواهر تناقض هذا المبدأ جذرياً، وذلك كما يتبين لنا في ما يلي:
1. المعرفة ضد البقاء، فالكائن الحي يتجنب المخاطر، أما الإنسان فيبحث عنها سعياً وراء المعرفة؛ فهو يدرس النجوم التي لا تفيده، والذرات التي لا يراها، ويغامر بحياته لاكتشاف ما لا يحتاجه للبقاء. فالعلم ليس تكيّفاً حيوياً، بل خروج عن اقتصاد البقاء.
2. الأخلاق ضد الانتخاب الطبيعي. إن الانتخاب الطبيعي يفضّل الأقوى، لكن الإنسان يمجّد حماية الأضعف، ويؤسس قوانين لحفظ من لا قدرة لهم على المنافسة. فالأخلاق هنا ليست تحسيناً تطورياً، حيث أنها مقاومِة لمنطق التطور ذاته.
3. المعنى ضد الوظيفة، فالكائن الحي يتعامل مع البيئة مباشرة، أما الإنسان فيتعامل مع تمثيلات عنها، وذلك من خلال اللغة والرموز والسرديات والخرائط الذهنية. فالإنسان يعيش في عالم ثانٍ فوق العالم الفيزيائي. وهنا تظهر المشكلة؛ فالبايولوجيا تفسّر السلوك الوظيفي، لكنها لا تفسّر بناء العوالم.
والآن، لماذا لا يكفي وصف الإنسان بأنه “سوبربايولوجي”؟ ولتجاوز هذا القصور الذي يجعل الإنسان ظاهرة لا تكفي البايولوجيا لتفسيرها، ظهر تصور للإنسان بوصفه كائناً “فوق-بايولوجياً”؛ أي أنه بايولوجي في أصله، لكنه أنتج طبقة ثقافية فوق بايولوجية. غير أن هذا الحل ظاهري فقط، لأنه يترك سؤالاً بلا جواب: كيف أنتجت آليةٌ تعمل وفق منطق البقاء نظاماً يعمل ضد منطق البقاء؟ فالسوبر-بايولوجيا تفسّر التعقيد لكنها لا تفسّر هذا “الانقلاب”. وفيما يلي أمثلة على “الانقلاب” لايكفي “التعقيد” للتعليل لها:
• فالحيوان يتكيف مع البيئة، أما الإنسان فإنه يعيد تعريف البيئة
• والحيوان يتبع الغريزة، أما الإنسان فإنه يشك في غرائزه
• والحيوان يعيش في الواقع، أما الإنسان فإنه يعيش في نموذج للواقع
الفرق هنا ليس درجة بل نوع. وبذلك يصبح مفهوم “فوق-بايولوجي” مجرد وصف لنتيجة، وليس تفسيراً لآلية ظهورها.
ولكن، لماذا ينبغي أن نعتبر الإنسان ظاهرة ميتابايولوجية؟ فالميتابايولوجيا لا تضيف طبقة جديدة فوق البايولوجيا، بل تشير إلى تحوّل في نمط التنظيم نفسه. إنها لحظة لم يعد فيها الكائن الحي محكوماً مباشرة ببيئته، بل بتمثيله لها.
فالميتابايولوجيا هي انتقال الكائن من التكيّف مع الواقع إلى التكيّف مع نموذج ذهني عن الواقع. وهذا التحول ينتج خصائص لا يمكن اشتقاقها من الانتخاب الطبيعي. وبالإمكان تبيان تميز الظاهرة الميتابايولوجية بتدبر خصائصها التالية:
1. ازدواج الوجود، فالإنسان يعيش في مستويين:
• العالم الفيزيائي
• العالم الرمزي
ولا يخضع سلوكه للأول مباشرة بل عبر الثاني.
2. إمكانية الخطأ البنيوي. فالحيوان يخطئ ظرفياً (عرضياً)، أما الإنسان فيخطئ حضارياً (أساطير – أيديولوجيات – أوهام جماعية)؛ أي أن الخطأ أصبح خاصية للنظام وليس حادثاً عرضياً.
3. استقلال الدافع عن البقاء، فالإنسان يمكن أن يضحي بحياته لأجل فكرة أو عقيدة أو معنى. وهذا لا يمكن اشتقاقه من اقتصاد الطاقة الحيوية.
4. نشوء التاريخ. فالبايولوجيا تنتج تطوراً، أما الميتابايولوجيا تنتج تاريخاً، والتاريخ ليس تغير الصفات، بل تغير تفسير الواقع.
ولكن، لماذا تفسّر الميتابايولوجيا الإنسان بشكل أفضل؟ لأنها تفترض أن الإنسان لم يصبح “أكثر ذكاءً” فقط، بل أصبح محكوماً بتمثيلاته. وبذلك تفسر: الأسطورة كنظام معنى، والعلم كنظام نماذج، والأخلاق كنظام ضبط فوق حيوي، والحضارة كنظام بيئة صناعية، والأزمات الحضارية كأخطاء نموذج لا كأخطاء تكيّف. فالإنسان لا يعيش في الطبيعة، بل في تفسيره لها.
يتبين لنا، وبتدبر كل ما تقدم، أننا إذا نظرنا إلى الإنسان ككائن بايولوجي، سنعجز عن فهم المعنى. وإذا نظرنا إليه كسوبربايولوجي، سنصف التعقيد دون تفسيره. أما إذا فهمناه ككائن ميتابايولوجي، فسنفهم أن ما يميّزه ليس الذكاء، بل انتقال مركز سلوكه من الواقع إلى النموذج. فالإنسان هو الكائن الذي لم يعد يتكيّف مع العالم، بل يتكيّف مع تصوره عن العالم، وحين يختل التصور، يختل العالم.
