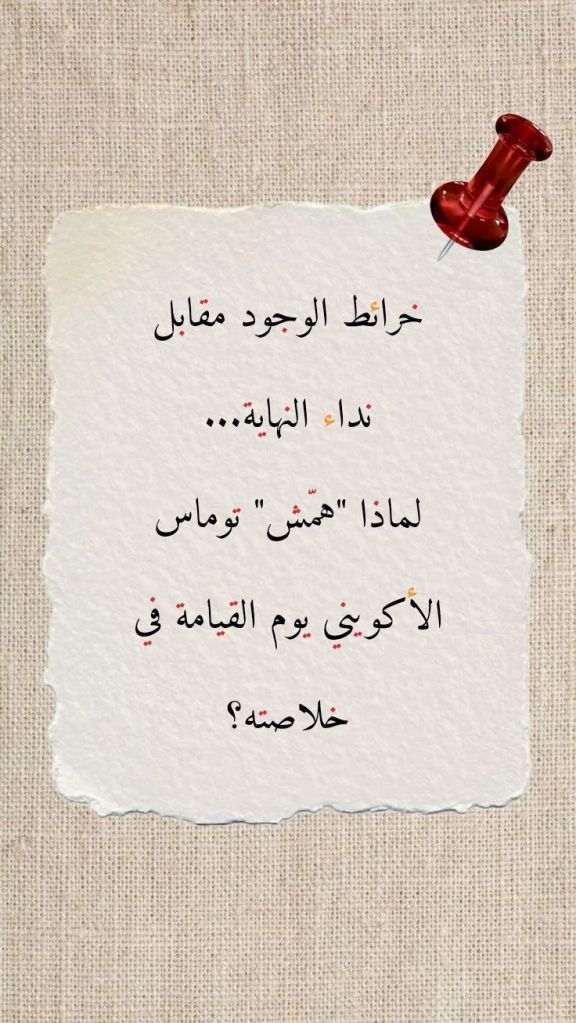
أول ما ينبغي توضيحه في هذه المقالة هو الفرق بين مقاربة توماس الأكويني ليوم القيامة ومقاربة القرآن لذلك اليوم العظيم:
• في القرآن: النص هو “ذكرى” و”نذير”، هدفه الأساسي هو التذكير بالمصير (Teleology). لذا، فإن اليوم الآخر هو المحرك الأخلاقي والوجودي لكل آية من آياته.
• عند الأكويني: فإن كتابه “الخُلاصة اللاهوتية(Summa Theologica)” لم يُكتب لبكون كتاب وعظ، بل كتاب تعليمي لدارسي علم اللاهوت. كان الأكويني يحاول بناء “هيكل عظمي” للعالم باستخدام العقل الأرسطي. فوفقاً لتوماس الأكويني، فإن فهم “ماهية” الأشياء وقوانين السببية هو الطريق الوحيد لفهم الخالق، لذا استغرقت “التفاصيل الهامشية” آلاف الصفحات من كتابه “الخلاصة اللاهوتية” لأنها تمثل “آلية عمل” الكون الذي صنعه الله. فلقد اعتمد توماس الأكويني في تنظيم “الخلاصة” على مبدأ فلسفي يسمى (Exit-Reditus)
1. القسم الأول: خروج الكائنات من الله (الخلق).
2. القسم الثاني: حركة العقل البشري نحو الله (الأخلاق والقوانين).
3. القسم الثالث: المسيح كوسيلة للعودة إلى الله. فالقيامة تقع في نهاية الطريق (العودة)، ولكن لكي يصل الأكويني إلى هذه النهاية، كان عليه أولاً شرح “المسار” بكل تعقيداته “القانونية” والمنطقية. بالنسبة له، القيامة هي “النتيجة”، أما “المقدمات” (التي هي قوانين الطبيعة والفضائل) فهي التي تحتاج إلى برهان عقلي طويل.
لقد كان توماس الأكويني مفكراً “أرسطياً” من الطراز الأول أكثر من كونه “رؤيوياً” (Apocalyptic). كان أرسطو يركز على “الاستمرارية” و”العلية”، لذلك، فلقد قضى الأكويني وقتاً طويلاً في شرح كيف تعمل السببية في هذا العالم، وذلك لأن انقطاع هذه السببية “يوم القيامة” يمثل لغزاً فلسفياً حاول الأكويني تجنبه قدر الإمكان للحفاظ على تماسك نظامه المنطقي. وذلك بالمقارنة مع القرآن الذي أسس لـ “مبدأ القطيعة”؛ حيث أن العالم الحالي ليس إلا مرحلة عابرة، بينما عالم الحقيقة المطلقة يبدأ بـ “الزلزلة” و”الواقعة”.
وهنا لابد من الإشارة الى عامل تاريخي يتلخص في كون توماس الأكويني لم يتأتَ له أن يكمل “خلاصته اللاهوتية”. ففي نهاية حياته، وبعد “تجربة روحية غامضة”، توقف الأكويني عن الكتابة وقال: “كل ما كتبته يبدو لي كالقشة مقارنة بما رأيت”. ومما يجدر ذكره في هذا السياق أن القسم الخاص بيوم القيامة والآخرويات (الأسكاتولوجيا) في عمله الموسوعي “الخلاصة اللاهوتية” لم يكتبه الأكويني نفسه بالكامل، بل قام تلاميذه بتجميعه من كتاباته الأخرى، وهي المجموعة الخاصة الملحقة بـ “الخلاصة اللاهوتية” تحت أسم (السوبلمينتو)Supplementum . ولا يعلم المرء على وجه اليقين إن كان توماس الأكويني سيكمل “خلاصته اللاهوتية” لو كان الله تعالى قد أطال في عمره، ولكننا نعلم يقيناً أنه وصف كل ما كان قد سطره بقلمه من كتابات، غلب عليها ولاؤه لمعلمه أرسطو، بأنها لا أكثر من “قشة” مقارنة بما كان قد خبره في “تجربته الروحية الغامضة”.
وبإمكاننا الآن، أن نعقد مقارنة بين تصور توماس الأكويني لعلاقة الله بمخلوقاته وبين ما يقدمه لنا القرآن من تصوير لهذه العلاقة. فبينما يرى الأكويني أن الله “يتجلى” في الأسباب التي تنتظم العلاقات القائمة في العالم، بكيفية تشي بالذكاء الإلهي الذي يقف من ورائها، وإلى الحد الذي يجعل تدبر هذه الأسباب بدراسة الهوامش عبادة لله الذي سبَّبها، يشدد القرآن على أن الله تعالى الذي خلق هذه الأسباب قادر على تعطيلها إن شاء في هذا العالم، وإن شاء أبقاها فاعلة بإذنه حتى يجيء ذلك اليوم حيث ينتفي أي وجود لها، ويتجلى الله تجليه الأعظم الى أبد الآبدين.
يتبين لنا، وبتدبر كل ما تقدم، أن الأكويني كان يحاول “تأثيل” (Etymologize) الوجود منطقياً، والمنطق بطبعه يميل إلى الاستقرار والقوانين، بينما يمثل يوم القيامة تداعياً فجائياً للمنطق البشري، وبكيفية تعجز قوانين أرسطو عن فهمها ناهيك عن تقبُّلها والقبول بها. وهنا لابد من التشديد على حقيقة مفادها أن تداعي “المنطق البشري” لا يقتصر على عالم الآخرة وأحداثه، وهذا التداعي هو عين ما يحدث في المعجزات: تلك الظواهر التي يستعصي على العقل أمر التعليل لما يجري فيها من خرق بيِّن لقوانين العلم الذي بين أيدينا.
