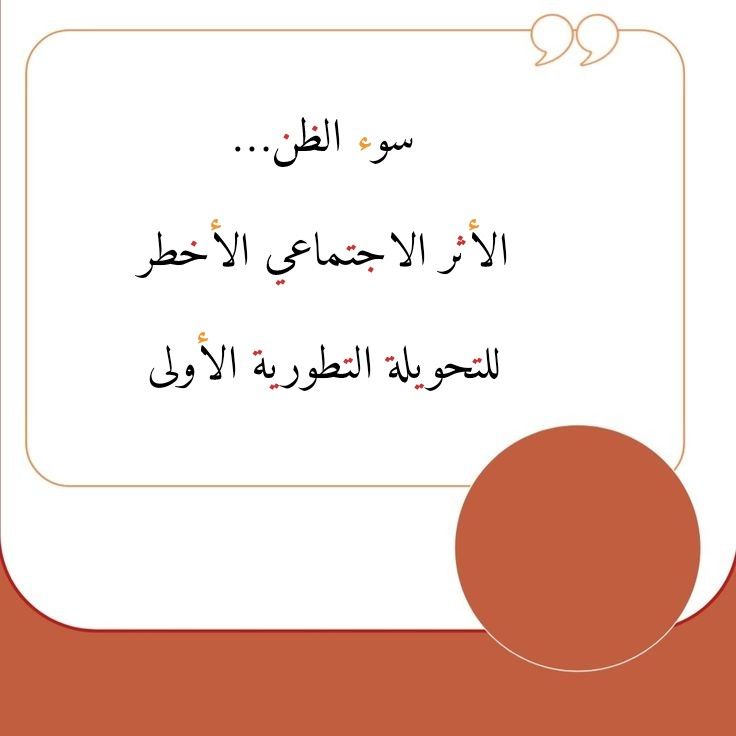
ليس كل ما يفسد العلاقات الإنسانية يصدر عن شرٍّ متعمّد، ولا عن عدوانٍ صريح، ولا حتى عن أنانية واعية. فأشدّ ما يفتك بروابط البشر يحدث غالبًا بصمت، داخل العقل قبل أن يظهر في السلوك، وداخل التفسير قبل أن يظهر في الفعل. ذلك الشيء هو سوء الظن. فنحن لا نفسد علاقاتنا عادةً بما نفعل، بل بما نفسِّر. واللافت أن سوء الظن ظاهرة إنسانية خالصة؛ فلا يوجد في عالم الحيوان ما يماثل هذه القدرة على إفساد العلاقة مع أفراد النوع نفسه عبر افتراض نوايا غير موجودة أصلاً. فالحيوان قد يهاجم أو يخاف أو يتجنب أو ينافس… لكنه لا يبني سردية ذهنية عن “مقصد خفي” وراء فعل بريء، وذلك كما يفعل معظمنا. وهذه القدرة ليست انحرافًا أخلاقيًا عارضًا، بل نتيجة مباشرة لتحول بنيوي عميق في الإدراك عنوانها التحويلة التطورية الأولى.
فقبل تلك التحويلة كان الكائن الحي يتعامل مع العالم وفق معادلة بسيطة عَمادها علاقة سببية مباشرة بين “المثير” و”الاستجابة”. لكن الإنسان خرج من هذه البنية إلى بنية أخرى قوامها علاقة معقدة بين المثير والاستجابة تتوسطها مراحل بينية تقوم على “التفسير” و”افتراض نية” و”حكم”. هنا لم يعد السلوك موجهاً بالواقع، بل بالصورة الذهنية عن الواقع.
لقد اكتسب العقل الإنساني قدرة هائلة على قراءة “ما وراء الظاهر”. غير أن هذه القدرة نفسها ولّدت خللاً ملازماً لها هو “اختلاق” لهذا الـ “ما وراء الظاهر”. فكلما زادت القدرة على تفسير النوايا، زادت احتمالات إساءة تفسيرها.
والآن، لماذا لا نستطيع التخلص من سوء الظن؟ لأن سوء الظن ليس عادة نفسية، بل آلية بقاء قديمة خرجت عن نطاقها الأصلي. ففي بيئة بدائية مليئة بالتهديدات، كان الافتراض الأسوأ أكثر أماناً من الافتراض الأفضل. فالكائن الذي يسيء الظن ببعض الإشارات ينجو أحياناً، أما الذي يحسن الظن دائماً فقد لا ينجو مطلقاً. وبالتالي فلقد نشأ داخلنا مبدأ إدراكي عميق مفاده أن الخطأ في اتجاه الخطر أقل كلفة من الخطأ في اتجاه الأمان. لكن المشكلة تكمن في أن هذا المبدأ بقي يعمل بعد أن تغيّر العالم. فالخطر الذي كان موجهاً نحو الكائن أصبح نادراً، بينما العلاقات الإنسانية أصبحت المجال الرئيسي لتطبيقه. وهكذا تحوّل نظام الحماية إلى نظام تخريب اجتماعي، يعمل داخل أفراد النوع. فحين يتأخر شخص في الرد علينا، لا نستقبل الحدث كواقعة زمنية، بل كمعلومة عن نواياه. وحين ينسى أحد وعداً، لا نفسره كنسيان، بل كموقف موجه ضدنا. وحين يصمت أحدهم، نسمع خطاباً كاملاً قامت أنفسنا بصياغة كلماته. فالعقل لا يحتمل الفراغ التفسيري فإن لم يتبين نيةً عند الطرف الآخر، قام باخترعها. وهنا يظهر سوء الظن بوصفه أقصر طريق يملأ به الدماغ فراغ المعنى. لأن التفسير السلبي أسهل معرفياً من التفسير المحايد؛ حيث أن المحايد يحتاج احتمالات والإيجابي يحتاج ثقة، أما السلبي فيحتاج فقط يقيناً واحداً. لذلك يميل العقل البشري إليه تلقائياً.
ولكن، كيف يدمّر سوء الظن العلاقات بين البشر؟ إن الإنسان لا يتعامل مع الناس كما هم، بل كما يتخيلهم. وعندما يسوء الظن تتحول العلاقة إلى تفاعل بين شخص حقيقي وشخص “متخيل”. فعندما يتكلم الطرف الأول، فيرد الطرف الثاني على “نيةٍ” لم تخطر ببال الطرف الأول أصلاً. ومن هنا تبدأ الحلقة المدمرة:
- تفسير سلبي
- رد فعل دفاعي
- سلوك متوتر
- رد فعل مقابل حقيقي
- تأكيد الوهم الأول
فيتحول الوهم إلى دليل لأنه صنع الدليل بنفسه!
ولكن المفارقة الكبرى تكمن في أن “الظن” ليس دائماً كذباً؛ إذ هو استخدامٌ صائب لقدرةٍ صحيحة في مكانٍ خاطئ. فالعقل صُمم لاكتشاف الأنماط الخفية، لكن العلاقات الإنسانية ليست دائماً نمطاً مخفياً. فنحن نعامل الآخرين كما لو كانوا ألغازاً يجب حلها، بينما معظم سلوكهم أبسط بكثير مما نظن ونتوهم.
فالحيوان قد يخسر معركة، ولكن الإنسان قد يخسر صداقة بسبب احتمال غير حقيقي. وهنا يظهر الأثر الاجتماعي الأعمق للتحويلة التطورية الأولى؛ إذ لم يعد خطر الإنسان على الإنسان جسدياً فقط، بل “تفسيرياً” ايضاً. وبذلك صار الخيال الإدراكي أخطر من العدوان.
وهنا لابد من التشديد على حقيقة مفادها أن النصوص الدينية التي تحذر من سوء الظن لا تعالج مجرد عيب سلوكي، بل تحاول كبح آلية إدراكية متجذرة في طبيعة العقل بعد خروجه على نظام الطبيعة الصارم. فالأمر ليس “لا تسيء الظن لأن ذلك خطأ”، بل “لا تسيء الظن لأن إدراكك نفسه غير محايد”. أي أن الأخلاق هنا ليست تربية سلوك، بل تصحيح جهاز تفسير.
يتبين لنا، وبتدبر ما تقدم، أننا لن نفهم الإنسان ما لم ندرك أن كثيراً من شروره الاجتماعية لا تنبع من رغبة في الإيذاء، بل من فائض في القدرة على الفهم. فلقد منحته التحويلة التطورية الأولى عقلًا يقرأ ما وراء الظاهر، لكن هذا العقل لم يتعلم بعد متى يتوقف عن القراءة. وسوء الظن هو الثمن الدائم لهذه القدرة فهو حارسٌ قديم نسي أن العالم قد تغيّر! فأصبح يحمي الإنسان من أخطار لم تعد موجودة، عبر تدمير علاقاته القائمة.
