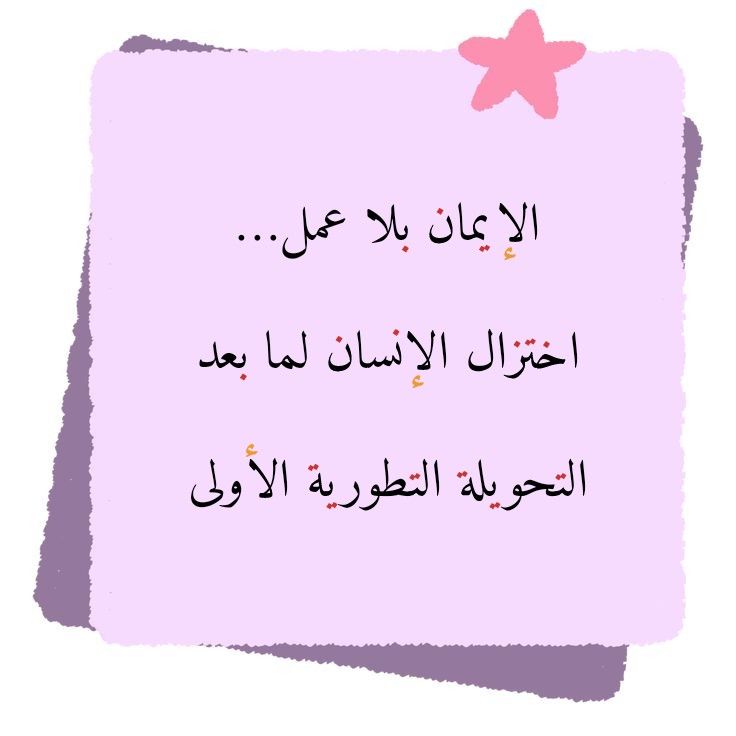
يظهر في التجربة الدينية الإنسانية، قديمًا وحديثًا، توترٌ دائم بين نمطين من التدين:
• تدين يكتفي بالإيمان المعلن والانتساب الرمزي والتصديق اللفظي.
• وتدينٍ آخر يجعل الإيمان منظومةً سلوكية ومسارًا عمليًا لإعادة تشكيل الإنسان أخلاقيًا ووجوديًا.
وقد عبّر القرآن عن هذا التمييز بصورة حاسمة حين قرن الإيمان بالعمل في عشرات المواضع: “الذين آمنوا وعملوا الصالحات”. غير أن التاريخ البشري يشهد بإصرار متكرر على تفريغ هذا الاقتران من مضمونه العملي، وتحويل الإيمان إلى حالة ذهنية مجردة أو هوية ثقافية موروثة. فما العلة العميقة لهذا الميل؟ في المنظور الميتابايولوجي، لا يُفهم هذا الانحراف بوصفه خطأً أخلاقيًا عابرًا، بل بوصفه أثرًا بنيويًا متبقّيًا من التحويلة التطورية الأولى التي أعادت تشكيل الوعي الإنساني بعد “لحظة الشجرة”.
إن هذه المقاربة تفترض أن التحويلة التطورية الأولى لم تكن مجرد انتقال معرفي أو أخلاقي، بل حدثًا تأسيسيًا أعاد ضبط علاقة الإنسان بنفسه وبجسمه وبإرادته وبمفهوم المسؤولية. ومن نتائج هذه التحويلة نشوء انقسام داخلي دائم يتمثل في عقل قادر على التصديق والتبرير وإرادة مترددة أمام الكلفة العملية للتغيير. هنا يولد التوتر المركزي: الإنسان يريد النجاة، لكن بأقل كلفة وجودية ممكنة.
وهنا يبرز السؤال: لماذا يفضّل الإنسان “الإيمان القولي”؟
- الاقتصاد الوجودي. إن الإيمان اللفظي هو الصيغة الأرخص نفسيًا فلا يتطلب تغيير أنماط العيش أو يستدعي تفكيك العادات أو يفرض إعادة هندسة العلاقات أو يهدد الامتيازات المكتسبة. بينما العمل الصالح، بوصفه مسارًا إصلاحيًا، فإنه يمس البنية اليومية للحياة والمتمثلة في الاستهلاك والسلطة والمال والغضب والشهوة والظلم والأنانية. من هنا يصبح الاكتفاء بـ “الإيمان القولي” استراتيجية دفاعية ضد “الألم التحويلي”.
- تضخم القدرة التبريرية للعقل، فبعد التحويلة التطورية الأولى، تضاعفت قدرة العقل على إنتاج السرديات التي تحمي الذات. وذلك باللجوء الى واحدة أو أكثر من المبررات المزعومة التالية: “الله غفور رحيم” “النية تكفي” “الإيمان في القلب” “الزمن فاسد ولا يمكن الإصلاح.” وكلها عبارات قد تكون صحيحة جزئيًا في سياقها، لكنها تتحول حين تُفصل عن العمل إلى أدوات تعطيل. وفي هذا المعنى، يصبح العقل جهاز تكيّف لا جهاز تهذيب.
- وهم الفصل بين الداخل والخارج. فالإنسان ينزع إلى اعتبار الإيمان شأنًا داخليًا خالصًا، بينما القرآن يعالجه كبنية متجسدة. فالإيمان، وفقاً لهذا التصور، ليس فكرة بل حالة تنظيم عصبي-سلوكي تنعكس في القرار والامتناع والمبادرة والعدل. إن الفصل بين الاعتقاد والسلوك هو أحد أعراض “تشظي الإرادة” ما بعد التحويلة التطورية الأولى.
فحين يصرّ القرآن على الربط بين الإيمان والعمل الصالح، فإنه لا يقدم إضافة أخلاقية تجميلية، بل يطرح برنامج إعادة هندسة للإنسان. فالعمل الصالح ليس ملحقًا بالإيمان، بل هو مظهره الخارجي ودليل استقراره في البنية العصبية واختباره الواقعي في التاريخ.
ومن منظور ميتابايولوجي، يمكن فهم هذا الاقتران بين الايمان والعمل الصالح بوصفه علاجًا مباشرًا لأثر التحويلة التطورية الأولى، وذلك كما يلي:
• إصلاح الإرادة المكسورة.
• إعادة وصل القناعة بالفعل.
• إخراج الإيمان من التجريد إلى الممارسة.
• تفكيك آليات التبرير الداخلي.
وهنا يبرز السؤال الذي مفاده: لماذا لا يكتفي الوحي بالإيمان المجرد؟ وذلك لأن الإيمان القولي وحده لا يغيّر البنية الاجتماعية أو يوقف الظلم أو يعيد توزيع الرحمة أو يكبح نزعات الهيمنة أو يرمم الخلل الحضاري. أما الإيمان المقرون بالعمل فيتحول إلى قوة تاريخية يُنشئ عدلًا ويضبط السلطة ويحمي الضعيف ويعيد تعريف النجاح ويكبح منطق الافتراس البشري.
وبهذا المعنى، فالوحي لا يخاطب الفرد فحسب، بل يسعى إلى إعادة برمجة المسار الحضاري.
يتبين لنا، وبتدبر كل ما تقدم، أن التعارض بين الإيمان كادعاء لفظي، والإيمان كمنهاج إصلاحي عملي، ليس اختلافًا فقهيًا سطحيًا، بل انعكاس لانقسام أنطولوجي نشأ بعد التحويلة التطورية الأولى. فالإنسان يميل بدافع الحفاظ على التوازن الداخلي إلى الحد الأدنى من الالتزام. بينما يأمر الوحي بمسار أعلى كلفة، إلا أنه وحده القادر على ترميم التشظي الداخلي وإعادة مواءمة العقل والإرادة وإخراج الإنسان من دوامة التبرير ودفعه نحو الارتقاء الوجودي بعد الإصلاح.
